أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
رؤية الله وبيان المذاهب فيها
ورؤية الله جل جلاله في جنات النعيم هي أعلا ما يَلتذُّ به أهل الجنة، بل أعلا نعيمهم أن ينظروا إلى وجه الله الكريم، وذلك لأنه منتهى الجمال؛ ولأنّ في الرؤية الرضا والإكرام، ولأنّ فيها صلاح القلب برؤية محبوبه عز وجل .
فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب جل وعلا ؛ يعني أنها شيء من جمال الصفات، كما أن رحمة الله عز وجل منها جزء يتراحم به الناس .
وكذلك جمال الحق عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا الوجود، فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها عز وجل من جماله ، فكلما نظروا – فى الجنة - إلى محبوبهم وخالقهم إزدادوا بذلك حسناً وجمالاً .
كما قال ابن القيم رحمه الله ([1]) :
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان
من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان
بمن أفاض ذلك الجمال، وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه .
ولهذا قال بعض أهل العلم: إنَّ الرؤية لله عز وجل هي الغاية التي شَمَّرَ إليها المشمرون .
فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي تَعَبُّد العابد، فإنَّ أعلى نعيم الجنة وأعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم عز وجل، كما قال ففف وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ققق ([2])، نظرت إلى الرحمان فاكتست الوجوه نظرة وجمالا وبهاء وحسنى تبارك ربنا وتعالى .
والرؤية حق لأهل الجنة ثابتة، وهي حقيقة لا مِرْيَة فيها، ولا شك فيها، وهي حق لأهل الجنة فأهل الجنة يرون ربهم عز وجل ويتلذذون بذاك النعيم .
وقد اختلف الناس فى مسألة رؤية الله تعالى عياناً فى الآخرة على ثلاثة مذاهب :-
أولاً : مذهب نفات الرؤية :-
ذهب المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وبعض الزيدية وبعض المرجئة .، إلى نفي رؤية الله تعالى عياناً في الدنيا والآخرة، وقالوا: باستحالة ذلك عقلا؛ لأنهم يقولون إن البصر لا يدرك إلا الألوان والأشكال، أي ما هو مادي والله تعالى ذات غير مادية، فمن المستحيل إذن أن يقع عليه البصر، فالقول برؤية الله تعالى هدم للتنزيه وتشويه لذات الله وتشبيه له حيث إن الرؤية لا تحصل إلا بانطباع صورة المرئي في الحدقة، ومن شرط ذلك انحصار المرئي في جهة معينة من المكان حتى يمكن اتجاه الحدقة إليه، ومن المعلوم علم اليقين أن الله تعالى ليس بجسم ولا تحده جهة من الجهات ولو جاز أن يرى في الآخرة لجازت رؤيته الآن .، فشروط الرؤية لا تتغير في الدنيا والآخرة . ([3])
واستدلوا على هذا بالسمع والعقل :
فمن جهة السمع: أولاً : قوله تعالى ففف لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ققق([4])، قالوا : أنه نفى أن يدرك بالأبصار، وقد علمنا أن الإدراك إذا قرن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية البصر، لانه متى قرن به زال الاحتمال عنه، فاختص بفائدة واحدة وهي الرؤية بالبصر، وذلك بمنزلة قوله لو قال: لا تراه الأبصار، فثبت أنه نفى عن نفسه إدراك البصر فيتناول جميع الأبصار في جميع الأوقات .([5])
وأجيب عليهم : بأنَّ هذا غلط كبير؛ لأنَّ نَفْيَ الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية، فإنَّه قد ترى الشيء ولا تدركه ؛ يعني لا تحيط به ، فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماء ، ولو قلت لأي أحد يرى السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها؟
فسيكون جواب كل أحد : لا، يعني لا يدركها رؤية، وإنما يرى منها ما يمكنه أن يرى وكما قال عز وجلففف فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلَّا ققق([6]) ، ووجه الدلالة أنَّهُ نفى الإدراك، ومع نَفْيِ الإدراك أثبت الله - عز وجل - الترائي وهو رؤية كل جمع لآخر فقال ) فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ ( هذا الجمع رأى الجمع وذاك الجمع رأى الجمع ومع ذلك ) قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( فقال موسى ( كَلَّا ) يعني لن نُدْرَكْ يعني لن يُحاطَ بنا .
فنَفْيُ الإحاطة لا يستلزم أن تُنْفَى الرؤية؛ بل نَفْيُ الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية نقيض ما قالوا، ... و...الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية أنَّ نفي الإدراك ليس كمالاً، والقاعدة المعروفة أنَّ كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده، فربنا - عز وجل - قال {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} ، وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغناه عن خلقه، إلى غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب - عز وجل -.
فلا يقال إنه لا يُدْرَك ويكون المراد كمالاً إلا وأَصْلُ ذلك ثابتاً، وهو أنه في محل من يُرَى أو في محل الرؤية ....
لأنك متى ما قلت في شيء إنك تراه أو لا تدركه رؤيةً فإنما يكون كمالاً إذا كان في محل ما يمكن أن يُرَى .، أما الأشياء التي لا تُرَى أصلاً فإنه ليس من الكمال أن تَنْفِي الرؤية عنها.
فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة، وإنما هكذا وُجِدَتْ، كونك تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها .
فإذاً دَلَّ نَفْيُ الإدراك عن الرب - عز وجل - أنَّ نَفْيَ الإدراك لأجل أنه عظيم عز وجل فإنه يُرَى، ولكنه لا يُدْرَكْ .
والإدراك ينقسم إلى قسمين : إدراكٌ بِرُؤْيَةٍ ، وإدراك بعلمه .
والإدراك بعلم : نَفَاهُ الله عز وجل في قوله سبحانه ) وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ( .
وإدراك الرؤية : نفاه الله عز وجل في هذه الآية .
وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، دلَّ عليها قوله بعد النفي ففف وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ققق ، فكونه سبحانه ) يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ( يعني يراها، وخَصَّ الإدراك بإدراك
الأبصار لأنَّ الأبصار هي محل نَفْيِ الإدراك السابق، فقال ففف لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ققق ، فلما قال ) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ( دَلَّنَا على أَنَّ المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم .([7])
الدليل الثاني من القرآن عند المعتزلة النفاة :- قوله تعالى ففف وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ققق .([8])
قالوا : ولَن موضوعة للتأبيد وإذا لم يره موسى أبدا لم يره غيره إجماعاً .([9])
وقد أجابهم الإمام صدر الدين ابن أبى العز الحنفي فقال : وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ) قَالَ لَن تَرَانِي ( ، وبقوله تعالى: ) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (. فالآيتان دليل عليهم .
الآية الأولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه :
أحدها : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته - أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال.
الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله، وقال ففف إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ققق .([10])
الثالث : أنه تعالى قال { لَن تَرَانِي }، ولم يقل: إني لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمنيه، فالجواب الصحيح: أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى .
يوضحه الوجه الرابع : وهو قوله ففف وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ققق فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟
الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. والكل عندهم سواء .
السادس : قوله تعالى ففف فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ققق، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار، فالبشر أضعف .
السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما.
وأما دعواهم تأييد النفي بـ ((لن)) وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت ؟ قال تعالى فففوَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ققق ([11])، مع قوله فففوَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ققق([12])
ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى ففف فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ققق ، فثبت أن « لن » لا تقتضي النفي المؤبد .
قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى :
ومن رأى النفي بلن مؤبدا ... فقوله اردد وسواه فاعضدا . ([13])
وقد استدل المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة مطلقاً بعدة أدلة أخرى من القرآن ، وأضافوا إلى ذلك أدلةٍ عقلية منها الآتي :-
1- المقابلة : وتحريره كما قال عبد الجبار: إن الواحد منا راء بحاسة، والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلاً أو حالاً في المقابل أو في حكم المقابل. وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلاً، ولا حالاً في المقابل، ولا في حكم المقابل . ([14])
وقد أجاب الرازى عن هذه الشبهة فى كتابه الأربعين ، بعدة أجوبه ومنها نفى الحيز والجهة([15]) ، والحق أن الجواب عن دليل المعتزلة بتسليم نفي الجهة والمقابلة عن الله تعالى لا يستقيم حيث إن إثبات رؤية حقيقية بالعيان من غير مقابلة أو جهة مكابرة عقلية ، لأن الجهة من لوازم الرؤية وإثبات الملزوم ونفي اللازم مغالطة ظاهرة. ثم إن الثابت بالنصوص الصحيحة إثبات الرؤية لله تعالى كرؤية الشمس والقمر .... ثم أن إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى ورد بالكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا فلا حرج في إثبات رؤية الله تعالى من هذا العلو الثابت له تبارك وتعالى ولا يقدح هذا في التنزيه، لأن من أثبت هذا أعلم البشر بما يستحق الله تعالى من صفات الكمال .
أما لفظ الجهة : فهو من الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها، ولا إثباتها بالنص، فتأخذ حكم مثل هذه الألفاظ . ([16])
2-من أدلة المعتزلة على نفي الرؤيا الانطباع : وتقريره كما ذكر الرازي : ( أن كل ما يكون مرئيا فلا بد وأن تنطبع صورته ومثاله في العين، والله تعالى يتنزه عن الصورة والمثال، فوجب أن تمتنع رؤيته ).
3- وأيضاً قالوا : إن كل ما كان مرئياً فلا بد له من لون وشكل، ودليله الاستقراء والله تعالى منزه عن ذلك فوجب ألا يرى .
والجواب عن الدليلين : هو منع كون الرؤية بالانطباع، ومنع كون المرئي ذا لون وشكل، إما مطلقاً أو في الغائب لعدم تماثل الرؤيتين، فرؤية الخالق ليس كرؤية المخلوق، فلا يجب هذا في حق الله تعالى حيث إن ذات الله مخالفة بالحقيقة والماهية لهذه الحوادث والمختلفات في الماهية لا يجب استواؤهما في اللوازم .
والحكم بأن المرئي لابد وأن تنطبع صورته ومثاله في العين، وأنه لا بد وأن يكون ذا لون وشكل مبني على أن هذه الأشياء المشاهدة المحسوسة لا ترى إلا كذلك. ثم قالوا لو صح أن يرى الله فلا يرى إلا كذلك وهو ممنوع في حقه تعالى، والحق أنه تحكم محض وقياس للخالق على المخلوق، وهو باطل قطعا لأنه قياس مع الفارق، فالله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يشبهه شيء من خلقه، فلا يصحقياسه عليه . ([17])
ثانياً : مذهب الأشاعرة ومن نحا نحوهم :-
وهؤلاء أثبتوا الرؤية ولكن قالوا : الرؤية ليست إلى جهة ، وإنما تكون إدراكاً.
فوافقوا السلف فى إثبات الرؤية ، وردُّوا قول المعتزلة في أنَّ الرؤية ممتنعة ، ووافقوا المعتزلة في أنَّ ليس على العرش رب وأنَّ الله سبحانه ليس في جهة - جهة العلو – خلافاً للسلف الصالح ، فقالوا الرؤية لا إلى جهة .
· حقيقة الرؤية عند الأشاعرة :
اختلفت عبارات الأشاعرة فى هذه المسألة ، فظاهر عبارات الأشعرى إثبات رؤية حقيقية بالأبصار ، وذلك خلافاً لأكثر أصحابه .
قال رحمه الله : « لما قال تعالى : } إلى ربها ناظرة { علمنا أنه لم يرد الانتظار، وإنما أراد نظر الرؤية.، ولما قرن الله عز وجل النظر بذكر الوجه؛ أراد نظر العينين اللتين في الوجه ». ([18])
وقال أيضاً : « وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى ففف وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ققق([19])([20])
وقال : مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة .... أن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر ... ([21])
هذا هو قول إمام المذهب ، أما أتباعه فاختلفوا ، فذهب بعضهم إلى قول الأشعري، بينما ذهب كثير منهم إلى أن حقيقة الرؤية مرجعها إلى العلم لا إلى الرؤية البصرية ، وبعضهم قال إنه شيء أعطاه الله لعباده المؤمنين في الآخرة يسمى الرؤيا .
ورغم تصريح أغلب الأشاعرة بإثبات الرؤية لكنهم يفسرونها بما يدل على عدم الإثبات .
يقول الآمدى : فالعقل يجوز أن يخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة بل وفى غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا .. ([22])
وقد نقل الشهرستانى عن الأستاذ أبى إسحاق أن الرؤية حكمها حكم العلم بخلاف سائر الحواس .... إلى أن قال : وصار المعنى كالعلم أو هو من جنس العلم وقد تقرر الاتفاق على جواز تعلق العلم به ... ([23])
فتفسير الرؤية بالعلم يعنى نفى الرؤية بالأبصار ، وليس في إثباتها إلا إثبات لفظ لا حقيقة له .، ولا ريب أن المعتزلة يثبتون العلم بالله يوم القيامة .
ولا شك أن كل من قال من الأشاعرة أن المراد بالرؤية هو العلم ، لم يثبت إلا مجرد اللفظ ولا فرق بينه وبين من نفى الرؤية لأنه مراده الرؤية البصرية ، فأي فرق بين القولين إذاً ؟
بينما ذهبت طائفة من الأشاعرة إلى أن الرؤية هي قوة يجعلها الله في خلقه ، وليست هى الرؤية البصرية .
قال البيجورى : الرؤية قوة يجعلها فى خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرئى ولا كونه فى جهة ولا حيز ولا غير ذلك .... إلى أن قال : والحاصل أنه تعالى يرى من غير تكيف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام ومن غير إحاطة ، بل يحار العبد فى العظمة والجلال فلا يعرف اسمه ولا يشعر بما حوله من الخلائق ، فإن العقل يعجز هنالك عن الفهم ويتلاشى . ([24])
ومن المعاصرين الشيخ حسن أيوب يقول : فإن الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، لا يشترط فيها الأشعة، ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك . ([25])
والحق أن هذا نفى للرؤية لا إثبات لها كما يزعمون ، وإن المعتزلة لا تمنع مثل هذه الرؤية التى هى بمعنى الكشف أو زيادة الانكشاف والمعرفة كما نقله بعضهم .
ولنتأمل ما قاله الآمدى : وذلك أن ما يخلقه الله من زيادة الكشف إن كان من ذات الشئ ووجوده بالنسبة إلى ما يحصل من تعلق علم النفس به شرحا سمى ذلك نظرا ...
إلى أن قال : فإن البصر هو ما يخلقه الله من زيادة الكشف من كونه ذاتاً ووجوداً وذلك مما لا يستحيل تعلق العلم به حتى لا يسمى ما حصل من مزيد الكشف عليه بصرا ... ([26])
قال التفتازانى : ورؤية الله تعالى بمعني الانكشاف التام بالبصر، وهو معني إدراك الشيء كما هو بحاسة البصر . ([27])
فالمقصود والظاهر من كلامهم أنه ليس نظراً بالأبصار كما أثبته الأشعرى والسلف الصالح ، وإنما هو زيادة الكشف .
كما أن بعضهم يرى أن الرؤية إدراك يخلقه الله لهم .
قال السنوسى : إذ كما صح تفضله سبحانه بخلق إدراك لهم فى قلوبهم يسمى العلم يتعلق به على ما هو من غير جهة ولا مقابلة، كذلك يصح تفضله تعالى بخلق إدراك لهم فى أعينهم أو غيرهما يسمى ذلك الإدراك البصر . ([28])
ويقول الدردير : الرؤية عبارة عن نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء ولأى شىء شاء ... فكما أن العلم إدراك ، وهم يعلمونه لا فى مكان ولا فى جهة .... فكذا الرؤية نوع من الإدراك فيدركونه كذلك ، ومع ذلك هو انشكاف تام.([29])
أما الرازي فمال إلى استحالة الرؤية يوم القيامة فقال : إن رؤية الله تعالى بالتفسير المذكور بتقدير أن تحصل فمحلها هو العين والحادقة أم جوهر النفس ؟ والأول كالمستبعد جداً ، وأما أن محل ذلك الإدراك الشريف هو جوهر النفس الناطقة ، فهذا أقرب إلى العقل . ([30])
هكذا تنوعت عبارات الأشاعرة فى حقيقة وماهية الرؤية ، والحقيقة أنهم رغم اختلاف عباراتهم إلا أنهم اتفقوا على أن الله لا يرى بالأبصار ، أنه لا مقابلة فى هذه الرؤية ، ولا جهة .
وعند التحقيق لم يعدُ الأشاعرة عن إثبات اسم بلا مسمى ، وقد أكثر الأشاعرة من الطعن والتشنيع على المعتزلة فى نفيهم الرؤية ، علماً بأنه لا فرق بين الأشاعرة الذين يكون بأن الرؤية هى العلم ، وبين خصومهم من المعتزلة .
والأشعرية فى هذا الباب بين نارين :
أولاً : النصوص الشرعية التي تثبت الرؤيا ، مع تصريح علماء المذهب الأولين بإثباتها ، وأنها أحد أبرز الخلافات مع المعتزلة النافين للرؤية .
ثانياً : الإلزامات التي تلزم عن إثبات الرؤية من قبل خصومهم وخاصةً المعتزلة .
فقالوا لهم : إذا كان الله يرى فلابد من المقابلة بين الرئى والمرئى ، ولابد من مكان وجهة للرئى والمرئى .
وبالتالي يوصف الله تعالى بأوصاف المحدثات .
وكقولهم : إذا كان يرى فهل يرى كله أم بعضه ، ورؤيته كله أى الإحاطة به ممتنعة ، ورؤية بعضه فيه تبعيض وتجزئة له ، وهو من صفات المحدثات .
وكقولهم : هل إذا رأيناه وأدرنا وجوهنا فى الخلف هل نراه فيها ؟
وهذا ما حدا ببعض الأشاعرة إلى القول بأنه يرى فى كل جهة .
وكان ينجى الأشاعرة من هذه التشنيعات والإلزامات أن يقولوا لخصومهم كما قال السلف الصالح من هذه الأمة : إن الله يرى بكيفية لا نعلمها نحن ، ومادام الله تعالى أخبر عن نفسه أنه يرى وأخبر عنه رسوله صصص أنه يرى بالأبصار يوم القيامة فنحن نثبت هذه الرؤية ، أما كيفيتها وصفتها فلا يعلمها إلا الله .، وليس من حقنا الخوض فيها لأنها من العلم الذى حجبه الله عنا .([31])
· مسألة نفى الجهة عند الأشاعرة :-
إن الأشاعرة جعلوا يداً مع المعتزلة فأنكروا العلو، وجعلوا يداً مع أهل السنة فأثبتوا الرؤية، فقالوا: إن الله يرى لا في جهة، وهذا غير معقول وغير متصور.
وقد لاحظت مما تقدم من كلامهم أن إثبات الأشاعرة للرؤية ونفي لازمها – أي الجهة - إنما هو نفي للرؤية نفسها حيث أثبتوا ما لا يمكن رؤيته، لأن نفي اللازم نفي للملزوم .، لذلك كان المعتزالة أكثر منطقية مع أنفسهم حين ذهبوا إلى نفي الأمرين فراراً من الوقوع في التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة .
هذا وإن كان قول الأشاعرة بنفي الجهة فاسداً وممتنعاً، إلا أن مقالة المعتزلة والشيعة بنفي الرؤية والجهة أشد فساداً وأعظم امتناعاً من جهة النقل والعقل .
والذي عليه السلف الصالح أن تلك اللوازم - كالجهة والمقابلة ونحوها - ليست ممتنعة، فإذا كانت المقابلة لازمة للرؤية فهي حق، فما كان حقاً وصواباً فلازمه كذلك، لذا يقول الإمام ابن تيمية : « من ادّعى ثبوت الشيء فقد ادّعى ثبوت لوازمه، ولوازم لوازمه، وهلم جرّاً ضرورة عدم الانفكاك عنه ».([32])
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
فلفظ « الجهة » قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العال .
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة» ولا نفيه، كما فيه إثبات «العلو» و «الاستواء» و «الفوقية» و «العروج إليه» ونحو ذلك.
وقد عُلم أن ما ثمّ موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته .
فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق ، فالله ليس داخلاً في المخلوقات ؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالَم، بائن من المخلوقات.
وكذلك يقال لمن قال : إن الله في جهة : أتريد بذلك أن الله فوق العالم ، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل .
وكذلك لفظ «المتحيز» ، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السموات والأرض ....
وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها، منفصل عنها ليس حالاً فيها. فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه.([33])
فإن أراد الأشاعرة بنفي الجهة أنه ليس في السموات رب ولا فوق العرش إله .، وأن محمداً صصص لم يعرج به إلى ربه، وما فوق العالم إلا العدم المحض : فهذا باطل، مخالف لإجماع سلف الأمة وأئمتها .
ثم إن الثابت بالنصوص الصحيحة إثبات الرؤية لله تعالى كرؤية الشمس والقمر، قال صصص : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. .» الحديث. وهما في جهة، وقد شبه صصص الرؤية بالرؤية .، ثم قوله صصص في الحديث الآخر: « إنكم سترون ربكم عيانا ». إثبات للرؤية البصرية التي لا تتم إلا على ما كان في جهة .
ثم أن إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى ورد بالكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا فلا حرج في إثبات رؤية الله تعالى من هذا العلو الثابت له تبارك وتعالى ولا يقدح هذا في التنزيه، لأن من أثبت هذا أعلم البشر بما يستحق الله تعالى من صفات الكمال .
أما لفظ الجهة : فهو من الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها ، ولا إثباتها بالنص.
هذا هو مذهب الأشاعرة في مسألة الرؤية، وما وقع لهم من تناقض واضطراب في هذا الباب ما هو إلا نتيجة حتمية لمن أقحم العقل في علم الغيب وحكمه فيما لا يصل إليه إدراكه .
وقد أغنى الله سلف هذه الأمة وأئمتها عن كل هذه الإشكالات والاعتراضات ، فأثبتوا الرؤية لله تعالى بدلالة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع اليقينى ، ومنعوا العقل من الخوض في تفصيلاتها ، فآمنوا بالنقل ووضعوا العقل مكانه الذي يجب أن يكون فيه .
ثالثاً : مذهب السلف في إثبات الرؤية :-
ذهب السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن تبعهم من الأئمة أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار عيانًا مواجهة لهم، بغير إحاطة ولا كيفية .
وهذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة وتابعوهم وأئمة الدين كالأئمة الأربعة -أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد- وسفيان الثوري وأبي عمرو والأوزاعي والليث بن سعد وأبي يوسف وغيرهم من الأئمة والعلماء وكذلك أيضًا سائر الفقهاء وأهل الحديث كلهم على هذا الاعتقاد، يثبتون أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانًا مواجهة، فهم يثبتون رؤية الله بالإبصار ويثبتون أيضًا الفوقية، وأنهم يرون ربهم من فوقهم فهم يثبتون الأمرين يثبتون الفوقية والعلو ويثبتون الرؤية.
وقد واستدلوا بالنصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صصص ، واستدلوا أيضاً بالإجماع والعقل الصريح .
1- الأدلة من كتاب الله تعالى :-
- قول الله تعالى ففف وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ققق ([34]) ووجه الدلالة من الآية على أن الله يرى في الآخرة أنه سبحانه وتعالى قد أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين وأخلى الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب -جل جلاله .
وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها : إما أن يكون الله سبحانه عنى نظر الاعتبار، كقوله تعالى : } أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت { ، أو يكون عنى نظر الانتظار، كقوله تعالى : }ما ينظرون إلا صيحة واحدة { ، أو يكون عنى نظر التعطف، كقوله تعالى : }ولا ينظر إليهم يوم القيامة { ، و يكون عنى نظر الرؤية.
فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنى نظر التفكير والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار.
ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه
فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه ، كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: « انظر في هذا الأمر بقلبك »، لم يكن معناه نظر العينين، وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار؛ الذي يكون للقلب، وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، وأهل الجنة في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم .
وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين؛ لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم، وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف؛ لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم .
وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معنى قوله: } إلى ربها ناظرة { أنها رائية ترى ربها عز وجل . ([35])
- قول الله تعالى ففف لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ققق ([36]) والحسنى المراد بها الجنة، والزيادة النظر وإلى وجه الله الكريم كما جاء تفسير ذلك في الحديث الصحيح عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صصص تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ففف لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ققق قَالَ: « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ » قَالَ: « فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ» قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ ».([37])
- قول الله تعالى ففف لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌققق ([38]) ، المؤمنون لهم ما يشاءون فيها أي: الجنة ولدينا مزيد هي رؤية الله في الآخرة .
فسرها العلماء بأن المزيد هو رؤية الله في الآخرة .
فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} قَالَ: «يَظْهَرُ لَهُمُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».([39])
قال العلامة الشنقيطى : قال بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم، ويستأنس لذلك بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، لأن الحسنى الجنة، والزيادة النظر . ([40])
- قوله تعالى ففف وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ققق .([41])
وقد تقدم الكلام على وجه الدلالة فى هذه الآية فى الرد على المعتزلة من كلام الإمام ابن أبى العز الحنفى .
- قوله تعالى ففف كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ققق .([42]) ، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه، كانوا جميعاً عنه محجوبين .
قال الإمام أحمد رحمه الله : فإذا كان الكافر يحجب عن الله، والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟([43])
وقيل لسفيان بن عيينة : إن بشرا يقول: إن الله لا يرى يوم القيمة، فقال: قاتله الله، دويبة، ألم يسمع الله يقول: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} ، فجعل احتجابه عنهم عقوبة لهم فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء، فأي فضل للأولياء على الأعداء ؟([44])
- قوله تعالى: ففف لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ققق ([45])
قال شيخ الإسلام : نفى الإدراك الذي هو الإحاطة وذلك يقتضي كمال عظمته وأنه بحيث لا تدركه الأبصار فهو يدل على أنه إذا رئي لا تدركه الأبصار وهو يقتضي إمكان رؤيته ونفى إدراك الأبصار إياه لا نفي رؤيته فهو دليل على إثبات الرؤية ونفي إحاطة الأبصار به وهذا يناقض قول النفاة وأما مجرد الرؤية فليست صفة مدح فإن المعدوم لا يرى ولهذا نظائر في القرآن . ([46])
قال ابن القيم : والاستدلال بهذا أعجب فإنه من أدلة النفاة وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه وقال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية ....
إلى أن قال : فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك فان العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب جل جلاله يتعالى إن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به ... ([47])
- قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه في النجوم ففف فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ققق ([48]) .
وجه الدلالة أن الخليل عليه السلام حاج قومه في النجوم وبين أنها تأفل وتغيب، في حين أن الرب لا يغيب ولا يأفل ثم قال في ذلك لا أحب الآفلين ولم يحاجهم بأنه لا يحب ربا يرى، ولكن حاجهم بأن لا يحب ربا يأفل وهذا هو دليل عدم الدوام وهو الذي يمتنع على الله تبارك وتعالى أما الرؤية فلا، حيث لم يجعلها الخليل من موانع الربوبية كالأفول والغيبة . ([49])
2- الأدلة من السنة :-
عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صصص إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ قَالَ: « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ... ».([50])
وعنه رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صصص : «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا».([51])
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صصص : «هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟»، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ»، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، .... الحديث ».([52])
ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا
فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال : يرى لا في جهة. فليراجع عقله .
وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته ، رد عليه كل من سمعه من أصحاب الفطرة السليمة .
وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صصص قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».([53])
وعَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صصص قَالَ : « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ».([54])
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صصص : « ... ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، ... الحديث ».([55]) والشاهد في الحديث قوله: (وليس بينه وبينه حجاب) هذا صريح في الرؤية .
هذه أمثلة من النصوص المتواترة، وهي كثيرة كما سبق رواها نحو ثلاثين صحابيًا في الصحاح والسنن والمسانيد، وهي صريحة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة .
3- أما الإجماع :-
قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم يقول الإمام عبد الغنى المقدسى : وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله . ([56])
وقال الإمام ابن أبى العز الحنفي: وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وأهل الحديث، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة . ([57])
وقال الإمام النووي : قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين . ([58])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع على أصلهم لقاء الله ؛ لأنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرة وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي ﷺ وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة . ([59])
4- أقوال الأئمة في إثبات الرؤية :-
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة.([60])
وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك رحمه الله : «الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم».([61])
قال الإمام الحسن : ينظرون إلى الله عز وجل كما شاء بلا إحاطة . ([62])
قال الإمام أبو بكر الخلال فى عقيدة الإمام أحمد رحمه الله : وكان يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار وقرأ {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} ولو لم يرد النظر بالعين ما قرنه بالوجه وأنكر نظر التعطف والرحمة لأن الخلق لا يتعطفون على الله تعالى ولا يرحمونه وأنكر الانتظار من أجل ذكر الوجه ومن أجل أنه تبعيض وتكرير ولأنه أدخل فيه إلى وإذا دخلت إلى فسد الانتظار ... ([63])
عن الوليد بن مسلم، يقول: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية , فقالوا: «أمروها بلا كيف».([64])
وقال الإمام الطحاوى رحمه الله : والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صصص فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صصص ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . ([65])
وقال الإمام الأصبهانى الملقب «بقوام السنة» : مذهب أهل السنة أن الله عز وجل يكرم أولياءه بالرؤية، يرونه بأعينهم كما شاء فضلاً منه ومنة . ([66])
قال الإمام الأشعري: وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: فففوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌققق.([67])
قال الإمام أبو بكر الإسماعيلى : ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة، دون الدنيا .. ([68])
قال الإمام ابن القيم : وأما الأحاديث عن النبي صصص وأصحابه الدالة على الرؤية، فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصدّيق، وأبو هريرة الدوسي، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، .... ثم ساق نحواً من ثلاثين اسماً للصحابة رضوان الله تعالى عليهم .
إلى أن قال رحمه الله : فصل : وأما التابعون ، ونزل الإسلام ، وعصابة الإيمان منهم أئمة الحديث والفقه والتفسير وأئمة التَّصوُّف، فأقوالهم أكثرُ من أن يُحيط بها إلاَّ الله عزَّ وجلَّ ....
ثم ساق الآثار والأقوال عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصرى ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، والأعمش وسعيد بن جبير ، وكعب الأحبار، وأبي إسحاق السبيعي، وعلي بن المديني، وعبد الله بن المبارك ،وشريك بن عبد الله، والأئمة الأربعة – أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد -، والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة ، ووكيع بن الجَّراح وقتيبة بن سعيدٍ ، وأبي عبيدٍ القاسم بن سلام ، وغيرهم .، ثم ساق قول جميع أهل اللغة . ([69])
هذه هى أهم الأقوال والمذاهب فى مسألة الرؤية إلا أن هناك مذهب رابع ، وهو لبعض المتصوفة من الإتحادية والحلولية كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وابن سبعين وغيرهم .
يقولون بأن الله تعالى يرى في الدنيا عياناً كما يرى فى الآخرة عياناً ، وأنه يحاضر ويسامر ، فمن كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن .
وهؤلاء يرد عليهم بقول الله تعالى جواباً لأحب الخلق إليه في ذلك الوقت وهو موسى عليه السلام وذلك عندما سأل الله جل وعلا رؤيته ) قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي ( أفهم خيرٌ من موسى عليه السلام ، أم أشد من الجبل الذي قال تعالى فيه ) فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا (
كما يرد عليهم بحديث النبي صصص « تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ ». ([70]) ، ففي هذا دلالة على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا .
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يرى أحد ربه فى الدنيا إلا ما كان من الخلاف فى رؤية النبي صصص ربه فى المعراج ، وبالله التوفيق .
([1]) متن القصيدة النونية ( الكافية الشافية ) ص203 ، الطبعة الثانية - مكتبة ابن تيمية، القاهرة .
([2]) سورة القيامة : الآية ( 22 -23 ) .
([3]) انظر : مقالات الإسلاميين 1/265 ، وشرح الطحاوية ص153 ط الأوقاف ، وموسوعة الفرق المنتسبة إلى الإسلام 3/443 .
([4]) سورة الأنعام : الآية ( 103 ) .
([5]) انظر : شرح الأصول الخمسة ص232 ، والمغنى 4/144 .
([6]) سورة الشعراء : الآيات ( 61 - 62 ) .
([7]) انظر : الشروح الوافية على العقيدة الطحاوية 1/403 للسيد أبو سيف ، مكتبة الإيمان – المنصورة .
([8]) سورة الأعراف : الآية ( 143 ) .
([9]) انظر : تفسير الزمخشرى المسمى ( بالكشاف ) 2/154 ، الطبعة الثالثة دار الكتاب العربي – بيروت .
([10]) سورة هود : الآية ( 46 ) .
([11]) سورة البقرة : الآية ( 95 ) .
([12]) سورة الزخرف : الآية ( 77 ) .
([13]) شرح الطحاوية ص156 وما بعدها ، ط الأوقاف السعودية .
([14]) انظر : رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ص55 للدكتور / أحمد بن ناصر آل حمد ، الطبعة الأولى جامعة أم القرى – مركز بحوث الدراسات الإسلامية .
([15]) انظر : الأربعين في أصول الدين للرازي ص 190 – 213 ، 217 ، والمواقف للإيجى 8/139 .
([16]) رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ص61 .
([17]) المصدر السابق ص71 – 72 .
([18]) الإبانة عن أصول الديانة ص38 .
([19]) سورة القيامة : الآية ( 22 -23 ) .
([20]) رسالة إلى أهل الثغر ص134 .
([21]) مقالات الإسلاميين ص292 ط ريتر .
([22]) غاية المرام ص167 .
([23]) انظر : نهاية الإقدام للشهرستانى ص201 .
([24]) تحفى المريد شرح جوهرة التوحيد ص129 .
([25]) تبسيط العقائد الإسلامية ص236 .
([26]) غاية المرام ص169 – 170 .
([27]) شرح العقائد النسفية ص51 .
([28]) شرح الوسطى ص372 .
([29]) شرح الخريدة البهية ص203 .
([30]) المطالب العالية 2/55 .
([31]) عقائد الأشاعرة ص301 – 302 بتصرف يسير .
([32]) تنبيه الرجل العاقل 1/63 ، نقلاً عن مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل ص79 جمع د/عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ، الطبعة الأولى – الناشر : مطابع أضواء المنتدى .
([33]) التدمرية تحقيق الإثبات ص 66 وما بعدها لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق د/ محمد عودة – الطبعة السادسة الناشر: مكتبة العبيكان – الرياض .
([34]) سورة القيامة : الآية ( 22 -23 ) .
([35]) الإبانة 1/35 وما بعدها .
([36]) سورة يونس : الآية ( 26 ) .
([37]) صحيح : رواه مسلم برقم 181 ، والترمذي برقم 2552 ، وابن ماجه برقم 187 ، وأحمد برقم 18941 وغيرهم .
([38]) سورة ق : الآية ( 35 ) .
([39]) أخرجه اللالكائى فى شرح اعتقاد أهل السنة برقم 813 ، والبزار فى مسنده برقم 7528 ، والدارمى فى الرد على الجهمية برقم 198 .
([40]) أضواء البيان 7/431 ، طبعة دار الفكر – بيروت لبنان .
([41]) سورة الأعراف : الآية ( 143 ) .
([42]) سورة المطففين : الآية ( 15 ) .
([43]) الرد على الجهمية والزنادقة ص133 ت/صبري بن سلامة شاهين .
([44]) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 1/66 .
([45]) سورة الأنعام : الآية ( 103 ) .
([46]) الصدفية 2/65 .
([47]) حادى الأرواح لابن القيم ص294 ، الناشر: مطبعة المدني، القاهرة .
([48]) سورة الأنعام : الآيات ( 76 - 78 ) .
([49]) انظر : التوحيد للماتدريدى ص78 ، طبعة دار الجامعات المصرية – الإسكندرية .
([50]) صحيح : رواه البخاري برقم 7434 ، ومسلم برقم 633 ، وأبو داود برقم 4729 ، والترمذي برقم 2551 وغيرهم .
([51]) صحيح : رواه البخاري برقم 7435 ، والدارمى في الرد على الجهمية برقم 171 ، والسنة لابن أبى عاصم برقم 461 ، والتوحيد لابن خزيمة 2/413 وغيرهم .
([52]) صحيح : تقدم تخريجه .
([53]) صحيح : رواه البخاري برقم 7444 ، ومسلم برقم 180 ، والترمذي برقم 2528 ، وابن ماجه برقم 186وغيرهم.
([54]) صحيح : رواه مسلم برقم 181 ، والترمذي برقم 2552 ، وابن ماجه برقم 187وأحمد برقم 18936 وغيرهم .
([55]) صحيح : رواه البخاري برقم 1413 وغيره .
([56]) عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسي ص58 .
([57]) شرح الطحاوى ص153 ط الأوقاف السعودية .
([58]) شرح النووي على مسلم 3/15 .
([59]) مجموع الفتاوى 6/469 .
([60]) الفقه الأكبر ص 55 .
([61]) أخرجه الآجرى في الشريعة برقم 574 ، واللالكائى فى شرح اعتقاد أهل السنة برقم 870 ، وابن بطة في الإبانة 7/52 ، والبغوى في شرح السنة – باب رؤية الله 15/229 .
([62]) الإبانة الكبرى لابن بطة 7/51 .
([63]) العقيدة للإمام أحمد رواية أبى بكر الخلال ص111 .
([64]) أخرجه اللالكائى فى شرح السنة برقم 875 .
([65]) متن الطحاوىة بتعليق الألباني ص43 .
([66]) الحجة فى بيان المحجة 2/524 .
([67]) رسالة إلى أهل الثغر ص134 .
([68]) اعتقاد أئمة الحديث للجرجانى ص63 .
([69]) انظر : حادي الأرواح 296 وما بعدها – 333 وما بعدها .
([70]) صحيح : أخرجه مسلم برقم 196 ، والترمذي برقم 2235 ، وأحمد برقم 23672 وغيرهم من حديث عمرو بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي ﷺ .


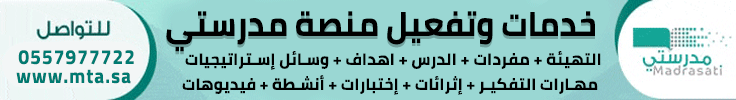






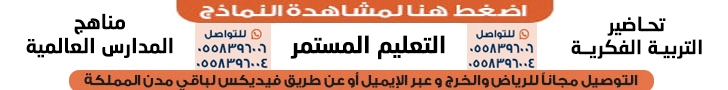

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
