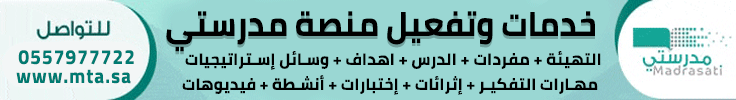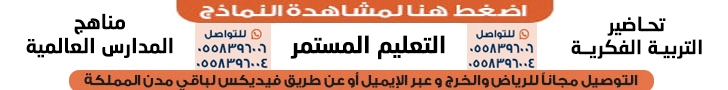الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد :
فإيمانا بالدور الذي تلعبه التحديات السريعة المتلاحقة والتغير في العملية التعليمية والتربوية ، وما يواكب ذلك من تطوّرات بسبب النمو المطرد في جميع المجالات ، الأمر الذي انعكس إيجاباً على العاملين في حقل التربية والتعليم وبخاصة الإشراف التربوي -والذي عرف العاملون فيه بأنهم صفوة الصفوة – ومن خلال ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للإشراف التربوي إلى استقطاب وتقديم كل ما هو جديد ومفيد في ذلك المجال المعطاء باعتباره الناقل والمؤثر المباشر في مؤسساتنا التربوية , ومن ذلك ما سعت إليه الإدارة العامة للإشراف التربوي إلى التعريف والعمل بأنماط الإشراف التربوي الحديثة ومتابعة تطبيقاتها في الميدان 0
ولعل في ذلك لحاق بركب التقدّم ومواكبة للتطور الذي يشهده الإشراف التربوي على مستوى العالم ، وهنا يأتي دور المشرف التربوي في تطبيق هذه الأنماط في الميدان بغية تطوير أداء المعلم داخل الصف والرقي بالعملية التعليمية ، وصولاً إلى مخرجات تعليم مأمولة ، ونحن ومن خلال إدارة الإشراف التربوي نعمل- ولله الحمد - بتطبيق جميع الأنماط السابقة كونها تنمّي قدرات المشرفين التربويين والمعلمين .
لذا فإننا نضع بين أيديكم النشرة التعريفية للأنماط الإشرافية الحديثة ، راجين من الله أن تكون فيها الفائدة للجميع .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .
مفهوم الإشراف التربوي :
الأشراف التربوي : عملية فنية شورية قيادية إنسانية شاملة غايتها تقويم وتطوير العملية التعليمية والتربوية بكافة محاورها .
فهو عملية فنية : باعتباره يهدف إلى تحسين التعليم والتعلم من خلال رعاية وتوجيه وتنشيط النمو المستمر لكل من الطالب والمعلم والمشرف، وأي شخص آخر له أثر في تحسين العملية التعليمية فنياً كان أم إدارياً.
وهو عملية شورية : تقوم على احترام رأى كل من المعلمين، والطلاب ، وغيرهم من المتأثرين بعمل الإشراف ، والمؤثرين فيه ، وتسعى هذه العملية إلى تهيئة فرص متكاملة لنمو كل فئة من هذه الفئات وتشجيعها على الابتكار والإبداع.
وهو عملية قيادية : تتمثل في المقدرة على التأثير في المعلمين، والطلاب، وغيرهم، ممن لهم علاقة بالعملية التعليمية لتنسيق جهودهم من أجل تحسين تلك العملية أو تحقيق أهدافها.
وهو عملية إنسانية : تهدف قبل كل شئ إلى الاعتراف بقيمة الفرد بصفته إنساناً، لكي يتمكن المشرف من بناء صرح الثقة المتبادلة بينه وبين المعلم، وليتمكن من معرفة الطاقات الموجودة لدى كل فرد يتعامل معه في ضوء ذلك .
وهو عملية شاملة : تعنى بجميع العوامل المؤثرة في تحسين العملية التعليمية وتطويرها ضمن الإطار العام لأهداف التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.
خصائص الإشراف التربوي
يتميز الإشراف التربوي الحديث بالخصائص الآتية :
1.أنه عملية قيادية تتوافر فيها مقومات الشخصية القوية التي تستطيع التأثير في المعلمين والطلاب وغيرهم ممن لهم علاقة بالعملية التربوية، وتعمل على تنسيق جهودهم، من أجل تحسين تلك العملية وتحقيق أهدافها.
2.أنه عملية تفاعلية تتغير ممارستها بتغير المواقف والحاجات التي تقابلها ومتابعة كل جديد في مجال الفكر التربوي والتقدم العلمي .
3.أنه عملية تعاونية في مراحلها المختلفة (من تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتقويم ومتابعة) ترحب باختلاف وجهات النظر، مما يقضي على العلاقة السلبية بين المشرف والمعلم ، وينظم العلاقة بينهما لمواجهة المشكلات التربوية وإيجاد الحلول المناسبة .
4. أنه عملية تعنى بتنمية العلاقات الإنسانية والمشاركة الوجدانية في الحقل التربوي ، بحيث تتحقق الترجمة الفعلية لمبادئ الشورى والإخلاص والمحبة والإرشاد في العمل ، والجدية في العطاء ،
والبعد عن استخدام السلطة وكثرة العقوبات وتصيد الأخطاء .
5.أنه عملية علمية لتشجيع البحث والتجريب والإبداع ، وتوظف نتائجها لتحسين التعليم، وتقوم على السعي لتحقيق أهداف واضحة قابلة للملاحظة والقياس .
6.أنه عملية مرنة متطورة تتحرر من القيود الروتينية ، وتشجع المبادرات الإيجابية، وتعمل على نشر الخبرات الجيدة والتجارب الناجحة ، وتتجه إلى مرونة العمل وتنويع الأساليب .
7.أنه عملية مستمرة في سيرها نحو الأفضل ، لا تبدأ عند زيارة مشرف وتنقضي بانقضاء تلك الزيارة ، بل يتمم المشرف اللاحق مسيرة المشرف السابق .
8.أنه عملية تعتمد على الواقعية المدعمة بالأدلة الميدانية والممارسة العملية ، وعلى الصراحة التامة في تشخيص نواحي القصور في العملية التربوية .
9.أنه عملية تحترم الفروق الفردية بين المعلمين وتقدرها، فتقبل المعلم الضعيف أو المتذمر، كما تقبل المعلم المبدع والنشيط .
10. أنه عملية وقائية علاجية هدفها تبصير المعلم بما يجنبه الخطأ في أثناء ممارسته العملية التربوية ، كما تقدم له العون اللازم لتخطي العقبات التي قد تصادفه في أثناء عمله .
11. أنه عملية تهدف إلى بناء الإشراف الذاتي لدى المعلمين .
12. أنه عملية شاملة تعنى بجميع العوامل المؤثرة في تحسين العملية التعليمية وتطويرها ضمن الإطار العام لأهداف التربية والتعليم .
13. أنه وسيلة هامة لتحقيق أهداف السياسة التعليمية خاصة وأهداف التربية عامة .
التخطيط للإشراف التربوي :
يمثل التخطيط الركيزة الأولى في رسالة المشرف التربوي ، فعن طريقه تحدد الأولويات الإشرافية ، وتختار النشاطات والفعاليات والبرامج الإشرافية الملائمة لتحقيق أهداف الإشراف التربوي ، بعيداً عن العشوائية والعفوية التي ينتج غالباً عنها عديد من المشكلات فضلاً عن ضياع الوقت وإهداره فيما لا طائل تحته .
فالتخطيط للإشراف التربوي من المقومات الرئيسة لنجاح المشرف التربوي ، و لا يستطيع أن يستغني عنه ، وذلك من منطلق أن الإشراف التربوي يجب أن يستند إلى أهداف واضحة وشاملة تنبثق من تحليل واقع المجالات الإشرافية التي يعمل في إطارها ، وهو مسئول عن الارتقاء بها، كما يعتمد على جمع المعلومات و البيانات الوافية عن المعلمين وكفايتهم و المناهج الدراسية ، وكذلك البيئات الدراسية المختلفة ، وصياغة خطة عمل محددة تتلاءم مع نوعية الأهداف وطبيعتها ، فالتخطيطللإشراف التربوي أسلوب للتفكير في المستقبل بتحديد معالم سير العمل اعتماداً على حاجات الميدان ومتطلباته وظروفه بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة .
ومن الموجهات الأساسية التي يضعها المشرف التربوي أمامه وهو مقبل على تخطيطه لعملية الإشراف التربوي ما يلي :
1. أن تكون خطته للإشراف التربوي نابعة من نتائج تحليل المعلومات و البيانات التي يحصل عليها من مجالات الإشراف التربوي ، بمعنى أن تلبي الخطة حاجات أساسية تتمثل في تطوير قدرات المعلمين ، و المنهج الدراسي ، و البيئة المدرسية .
2. أن تكون أهداف الإشراف التربوي واضحة ومرتبة حسب الأولويات التي يظهرها تحليل الواقع والتصور المستقبلي ، بحيث تتجه جميع الجهود لتحقيقها .
3. اختيار الوسائل و الإجراءات و المستلزمات الفاعلة و المناسبة لتحقيق أهداف الإشراف التربوي ، اختياراً يتفق و أساليب تحقيق الأهداف .
4. أن تكون الخطة خاضعة للتجريب لتثبت كفايتها ، و إبراز أوجه قوتها ونقاط الضعف فيها دون استعجال للنتائج .
5. أن تتضمن الخطة إجراء تقويم لكل النشاطات والأدوات التي استخدمت وفق معايير محددة ، وأن تكون متلازمة مع النشاطات الإشرافية .
6. أن يبتعد التخطيط عن الرتابة والنمطية والأساليب التقليدية ، ويتجه إلى الإبداع .
7. أن تكون الخطة في عدة مستويات ، بمعني أن تتجزأ الخطة السنوية إلى خطة فصلية وشهرية ، يراعى فيها التوافق و الانسجام و عدم التعارض .
الخطة الإشرافية وعناصرها :
يحتاج المشرف التربوي أن يرسم خطة سنوية فاعلة متكاملة تتضمن مجالات الإشراف التربوي الرئيسة : رفع كفاية المعلمين ، وتطوير المناهج الدراسية ، وتحسين البيئة المدرسية بما تتضمنه من عناصر متفاعلة ، بشرية ومادية .
ينبثق من الخطة السنوية التي يضعها المشرف التربوي ثلاثة مستويات : الخطة الفصلية ، والخطة الشهرية ، والخطة الأسبوعية ، وتتضمن كل منها مجموعة من الأهداف في مجالات الأشراف التربويوالأنشطة الإشرافية الملائمة وجدولة زمنية تتناسب مع نوعية الأهداف ، و النشاطات الإشرافية والإمكانات المتوافرة ، و أنشطة تقويمية مبنية على دلالة الأهداف .
ويمكن تفصيل مراحل بناء الخطة الإشرافية كما يلي :
أولاً: مرحلة جمع البيانات والإحصاءات الأولية :
تعد هذه المرحلة أساسية وهامة في عمل المشرف التربوي ، إذ عن طريقها تستخرج مجموعة من المؤشرات والموجهات لأهداف خطته ونشاطاتها ، وهذه المرحلة تتضمن :
1-عدد المدارس التي يشرف عليها ومراحلها وتوزيعها الجغرافي .
2-نوعية البيئات المدرسية التي يشرف عليها ، ومدى انسجام إداراتها ومعلميها .
3-عدد المعلمين والمديرين ومؤهلاتهم وسنوات خبراتهم .
4-مستويات تحصيل الطالب كما أظهرتها نتائج الاختبارات وخصوصا في المادة التي يشرف عليها .
5-المناهج الدراسية التي يشرف على تنفيذها والتعديلات الحادثة عليها .
6-الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البيئة المحلية للمدارس التي يشرف عليها .
7-تقديرات الأداء الوظيفي للمديرين والمعلمين .
8-التقنيات والإمكانيات المادية المتوافرة في المدارس .
ثانياً : تنظيم المعلومات والبيانات والإحصاءات وتبويبها :
لكي يسهل تناول المعلومات والبيانات وتوظيفها في الكشف عن الحاجات الإشرافية ، يمكن تنظيمها على النحو التالي :
1. حفظها وتبويبها في الحاسب الآلي حسب نوعية البيانات وموضوعاتها أو تنظيمها في ملفات خاصة حسب المجالات الإشرافية .
2. تلخيصها في بطاقات خاصة سهلة التناول.
مع التأكيد في هذه المرحلة على ضرورة تحديث المعلومات والبيانات وتنميتها من المصادر المتاحة .
ثالثاً : مصادر المعلومات والبيانات والإحصاءات :
توجد عدة مصادر يمكن أن يستقي منها المشرف التربوي معلومات وبيانات وافية في المجالات التي يستهدفها ومنها :
1. الاستبيانات التي تعممها الإدارة التعليمية .
2. نتائج اجتماعات وزيارات العام الماضي .
3. نتائج تحصيل الطلاب مثل الخلاصة النهائية لنتائج طلاب المرحلة الثانوية التي تصدرها الإدارة العامة للتعليم .
4. نماذج أسئلة الاختبارات الفصلية والنهائية التي يعدها المعلمون .
5. الملاحظات الموضوعية غير المتسرعة التي يدونها المشرفون التربويون عن المديرين والمعلمين و الطلاب .
6. أقسام الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم ولاسيما ما يتعلق منها بالمعلمين الجدد والمقررات الدراسية المعدلة .
رابعاً: مرحلة وضع الخطة الإشرافية :
نظرا إلى أن عملية الإشراف عملية تعاونية ، وتحقيق أهدافها يتطلب تضافر جهود كل من المشرف والمعلمين والمديرين كذلك يجب أن تكون معطيات الخطة نابعة من تعاون بعض من يعنيهم الأمر مما يضمن تأييد جميع أطرافها ، وأن هذه الخطوات تتمثل في الآتي :
1. تحديد الأهداف العامة للخطة السنوية بحيث تشتمل على مجالات الإشراف التربوي .
2. تحديد الأهداف ذات الأولوية والتي من الممكن إنجازها في الفترة الزمنية المحددة للخطة.
3. وضع مجموعة من الأنشطة والأساليب الإشـرافية التي تكفل تحقيق أهداف الخطة وذلك مثل: الندوات ، والمشاغل التربوية ، و الزيارات الصفية ، والنشرات الدورية ، و الدروس النموذجية وغيرها.
4. تحديد الصيغة النهائية للخطة ومناقشتها مع بعض المستفيدين منها .
خامساً: مرحلة التنفيذ :
لتسهيل تنفيذ الخطة العامة تجزأ إلى خطط فصلية ، وشهرية ، وأسبوعية تترابط معا في وحدة عضوية واحدة، وتأخذ الصورة التنفيذية عدة أشكال مثل : الزيارات الصفية أو المشاغل التربوية ، أو البرامج التدريبية وعموما يشمل أي نشاط إشرافي على المكونات التالية :
1. تحديد أهداف النشاط الإشرافي بصورة إجرائية .
2. تحديد الأدوات والوسائل المناسبة للقيام بالنشاط الإشرافي .
3. تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ النشاط ومكانه .
4. تحديد أسماء المشرفين أو المديرين أو المعلمين المتعاونين في تنفيذ النشاط الإشرافي، وتحديد مهامهم بدقة .
5. التنسيق مع الفئة المستهدفة من المعلمين في تحقيق أهداف البرنامج وتحديد توقيته الزمني.
6. تحديد الأنشطة التقويمية المناسبة لقياس مدى تحقق أهداف النشاط أو البرنامج .
أنماط الإشراف التربوي :
ـ الإشراف البنائي .
ـ الإشراف العيادي .
ـ الإشراف بالأهداف .
ـ الإشراف التطويري .
ـ الإشراف التنوعي .
ـ الإشراف الإلكتروني .
أولاً : الإشراف البنائي :
يتعدى الإشراف التربوي هنا مرحلة التصحيح إلى مرحلة البناء ، وإحلال الجديد الصالح محل القديم الخاطيء ، فليس من المهم العثور على الخطأ ، بل أن نمتلك المقترحات المناسبة والخطة الملائمة لمساعدة المعلم على النمو الذاتي والإفادة من تجاربه ، وبداية الإشراف هنا هي الرؤية الواضحة للأهداف التربوية وللوسائل التي تتحقق إلى أبعد مدى ؛ لذا ينبغي أن تنصب أنظار المشرف والمعلم على المستقبل ، لا على الماضي ، إذ إن الغاية من الإشراف البنائي لا تقتصر على الأفضل ، وإنما تتجاوز ذلك إلى المستقبل بإشراك المعلمين في رؤية ما ينبغي أن يكون عليه التدريس الجيد وأن يشجع نموهم وأن يستثير المنافسة بينهم من أجل أداء أفضل ويوجهها للصالح التربوي .
ويمكن تلخيص مهمة الأشراف البنائي في النقاط الآتية :
أ- استخدام أفضل الإمكانات المدرسية والبيئية في خدمة التدريس .
ب- العمل على تشجيع النشاطات الإيجابية وتطوير الممارسات القديمة .
ج- إشراك المعلمين في رؤية ما يجب أن يكون عليه التدريس الجيد .
د- تشجيع النمو المهني للمعلمين وإثارة روح المنافسة ا الشريفة بينهم .
ثانياً : الإشراف العيادي ( العلاجي ، الإكلينيكي ) :
تحيل كلمة العيادي في القاموسعلى دلالة لها بعد طبي (إكلينيكي)، فهي تمكن من القيام بملاحظة حالة معينةبغية تشخيص أسباب القصور وعدم التوازن فيها واقتراح خطة علاجية ملائمة ، فالطبيبيقوم خلال فحص إكلينيكي بفحص الحالة ويشخص ، ثم يصف العلاجالمناسب .
ظهرت البدايات الأولى في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي في جامعةهارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية على يد العالم التربوي ( كوجان ) ، الذي يقول : إن المعالجةالعيادية تأخذ وقـتاً أفضل وتقوم في إطارها علاقة وثيقة وحرص على الشفاء والعمل فيالعيادة يحتاج إلى تدريب على التشخيص والتحليل والمشاهدة الميدانية وتكوين فروضمؤقتة .
ويعرّفه ( كوجان ) بأنه : ذلك النمط من العمل الإشرافي الموجه نحو تحسين سلوك المعلمين الصفيوممارستهم التعليمية الصفية بتسجيل كل ما يحدث في غرفة الصف من أقوال وأفعال تصدرعن المعلم وعن الطلاب أثناء تفاعلهم في عملية التدريس وبتحليل أنماط هذا التفاعل فيضوء علاقة الزمالة القائمة بين المشرف التربوي والمعلم بهدف تحسين تعلم الطلاب عنطريق تحسين تدريس المعلم وممارسته التعليمية .
أهدافــه :
1. نقل المعلمين إلى مستوى أعلى في الأداء وترك أثر إيجابي في التعليم .
2. زيادة فاعلية دور المعلم من خلال التفاعل الحقيقي مع المشرف التربوي .
3. التغيير الإيجابي في اتجاهات المعلمين نحو الإشراف التربوي .
4. إثارة دافعية المعلمين وممارستهم للجديد النافع في المجالات التربوية المختلفة .
5. تطوير تعلم التلاميذ وسلوكهم .
أهميته :
يعد استخدام أسلوب الإشراف الإكلينيكي ضرورة تربوية تطويرية ملحة تفرضها عدة مبررات رئيسة هي :
1.ضعف برامج التدريب قبل الخدمة .
2.ضعف الممارسات التعليمية الصفية للمعلمين المبتدئين بشكل عام .
3.كثرة التجديدات والمستحدثات التربوية وتنوعها ، وعدم توافر النظام الإشرافي الفعال والقادر على استيعابها، وتدريب المعلمين على امتلاك الكفاءات الأدائية المرتبطة بها.
خطواتــه :
1. التخطيط المشترك بين المشرف والمعلم والمشاركين الآخرين للوحدة التدريسية .
2. مشاهدة الحصة وتسجيلها عن طريق الصورة أو الصوت أو الكتابة .
3. تحليل الحصة تحليلا موضوعيا شاملا من قبل المشرف التربوي ومن قبل المشاركين على حد سواء ، وتقويمها لمعرفة نقاط القوة لتعزيزها ، ومواطن الضعف للتركيز عليها في التخطيط الجيد ومن ثم العمل على تحقيقها.
مميزاتــه :
الإشراف الإكلينيكي أسلوب إشرافي مؤثر، فعال، ويتميز بالآتي:
1. أن المعلم طرف فاعل في العملية الإشرافية ، يسهم في تقديم التغذية الراجعة الضرورية لتعديل وتطوير الخطة الإشرافية .
2. يعدّ أسلوبا فعالاً في تغيير أنماط السلوك التعليمي الصفي للمعلمين تغييراً إيجابياً ولنقلهم إلى مستوى أعلى في الأداء ، يؤدي بدوره إلى إحداث آثار إيجابية في العملية التعليمية .
3. أن طبيعة العلاقة بين المشرف والمعلم في ضوء أسلوب الإشراف الإكلينيكي تتميز بروح الثقة والتعاون الإيجابي بين الطرفين ، مما يؤثر بدوره في العلاقة بين المعلم والطلاب ، حيث تتجه هذه العلاقة نحو مزيد من التواصل المفتوح وتزيد من مبادرات الطلاب في العملية التعليمية .
كفايات المشرف العيادي :
إن علىالإشراف العيادي، الذي يطمح إلى أن يكون إشرافا يتمتع بجودة تربوية عالية، أن يخضعحسب باكيت (Paquette) لضبط وتعديل يتحكم فيه ثالوث يتكون من الثقة والمصداقيةوالكفاءة .
ونجد فيما يلي توصيفا لأهم الكفايات التي تتوافر في المشرفالعيادي :
1.القدرة على استعمال تقنية منهجية (استبانة، بطاقاتللملاحظة ، وسائل أخرى تتيح الحصول على بيانات ومعلومات تخص التدريس ،فالملاحظة هي تعيين ووصف وتصنيف ، وتحليل ، ثم تأويل الظواهر التي تحدث داخلالقسم.
2.القدرة على التشخيص : أي الكشف عن سبب المشكلات التي قد تعترضأداء المعلمين في فصولهم ، مما يخلق ثغرات في التعليم والتعلم ، ويحول دون تحقيقالأهداف المتوخاة .
3.القدرة على التحليل : وهي عملية تفكيك وضعياتالتعليم- التعلم ، بحثا عن ترتيب لها أو عن علاقات بينها . وتشمل في البداية تحليلالسلوك الملاحظ لدى أطراف العملية التربوية (معلم، تلاميذ في سياق لحظة التعلم داخلحجرة الدراسة) ؛ ثم في مرحلة لاحقة تحليل السلوك المهني للمعلم .وتتضمن عملية تحليلالتعليم مجموعة من الفئات ، التي تترجم بكيفية معينة واقع الصف الدراسي ، وهي التيتتطلب تفكيك الأحداث الملاحظة إلى وحدات تحليلية يمكن تصنيفها منهجيا للحصول علىصورة صادقة لمظاهر التدريس المعقدة .
4.القدرة على إعداد وتصميم مشروعاتوعمليات وبرامج لأجل تحقيق مقاصد وأهداف تعليمية أو تكوينية ( أهداف، مضامين،أنشطة، وسائل، تقويم ) .
5.القدرة على اتخاذ القرار : وهو مجموعة منالعمليات والإجراءات الهادفة إلى تطوير عملية التدريس والتي تنطلق من الإحساس بوجودمشكلة أو حاجة ، وطرح مجموعة من القرارات واختيار ما يناسب منها ، بعد فحصها والتأكد منملاءمتها .
6. القدرة على تقويم التدريس : وهو عبارة عن عمليات تتم بواسطةأدوات ملائمة بقصد فحص مكونات التعليم كالطرق والوسائل والأنشطة بهدف الحصول علىمعلومات تمكن من ترشيد هذا التعليم وتطويره ، ويهدف إلى فحص فعالية التعليم.
منطلقات الإشرافالعيادي :
1. يقول أنصار هذا النموذج إنه إذا كان تحسين التعليم في غرفةالصف هو الهدف النهائي للإشراف التربوي ، فيجب أن يقضي المشرف جل وقته للعمل معالمعلمين لمواجهة المشكلات التي يحددونها خاصة المشكلات التي تتعلق بحجرةالدراسة .
2. ينطلق الإشراف العيادي من الاعتقاد بأن التعليم سلوك ونتيجة ،وهذا يعني أن الأداء التعليمي غير منفصل عن آثاره.
3. إن التركيز على ما يجريفي غرفة الصف هو ما يميز الإشراف العيادي من الإشراف العام الذي يرتبط بالعملياتالإشرافية التي تأخذ مجراها أساسا خارج المدرسة مثل تطوير ومراجعة المناهج وإعدادالبرامج والمواد التعليمية وتقييم البرنامج التعليمي بشكل عام ولا تهتم بما يجري فيغرفة الدرس إلا بمقدار ارتباطها بتلك العمليات ، في المقابل يركز الإشراف العياديعلى تحسين أداء المعلم في حجرة الصف أساسا ويهتم بالمعلومات التي يستقيها منالمعلم بهدف تطوير أدائه المهني ليصبح قادرا على التحليل الذاتي لعمله ، ومستعدالقبول المساعدة من الآخرين وقادرا على الإشراف الذاتي .
مراحل الإشراف العيادي :
يتكون الإشرافالعيادي من حلقة دائرية متصلة ومستمرة التَّفاعل تسمى بدائرة الإشراف العياديوتتضمن المراحل الثلاث الأساسية ( التَّخطيط – الملاحظة – التَّحليل والتَّقـويم)وكل مرحلة تتضمن عددًا من الخطوات الأساسية والإخلال بأي منها يؤثر سلبًا في سيرالعملية الإشرافية ويتم تكرار المراحل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
رسم بياني يوضح مراحل الإشراف العيادي :
ثالثاً : الإشراف بالأهداف :
مفهومه : يعرف الإشراف بالأهداف على أنه "عملية مشاركة جميع الأفراد المعنيين بالعملية الإشرافية في وضع الأهداف المراد تحقيقها بغرض زيادة فاعلية العملية الإشرافية وتتضمن هذه العملية تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس والتطبيق ، ونتائج محددة بدقة وبرامج واقعية ، وتقييماً للأداء في ضوء النتائج المتوقعة .
فلسفة الإشراف بالأهداف :
لا ينطلق أسلوب المشرف التربوي من فراغ ولكنه يتأثر بالبيئة المحيطة به ، ولا يمكن للمشرف التربوي تطبيق أسلوب الإشراف بالأهداف قبل معرفة اتجاهه نحو تفسير السلوك الإنساني ، فإن كانت نظرته إلى المعلمين من زاوية نظرة الإدارة التقليدية التي تنظر إلى الإنسان نظرة سلبية ، فإن تطبيق أسلوب الإشراف بالأهداف لا يصلح حينئذ ، في حين يصلح تطبيق أسلوب الإشراف بالأهداف مع المشرف التربوي الذي ينظر إلى الإنسان من زاوية نظرة الإدارة الحديثة التي تنظر إلى الإنسان نظرة إيجابية متفائلة .
العلاقة بين الإشراف التربوي والإشراف بالأهداف :
لا بد منالتعاون القائم على الثقة والتفاعل الإيجابي بين الطرفين ، وقد أوصت عدد من الدراسات مثل دراسة البريكان (1422هـ)ودراسة نشوان (1407هـ) وغيرهما بضرورة الأخذ بأهم الاتجاهات الحديثة في الإشراف التربوي، ومن ضمنها الإشراف بالأهداف الذي يعنى باشتراك المعلمين مع المشرف التربوي في صياغة الخطة الإشرافية وتوزيع العمل فيما بينهم بروح الفريق، الأمر الذي يزيد من حماسهم لتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها .
و يعد نمط الإشراف بالأهداف امتداداً طبيعياً للإدارة بالأهداف ، حيث دأبت المؤسسات التربوية على الاستفادة مما لدى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية ، وغيرها من أفكار واتجاهات مفيدة ، وتوظيفها في خدمة أهداف التربية والتعليم من مثل استفادتها من الإدارة العلمية والعلاقات الإنسانية وإدارة الجودة الشاملة ومهارات التعليم الأساسية ( الحاسوب، تنمية التفكير، عمليات الاتصال) .
ويرى بعض الباحثين أنه على الرغم من أن أدوار المشرف التربوي بالمفهوم الشامل تتضمن مجالات عدة ( مناهج وطرق التدريس ، الاتصال التربوي، القيادة التربوية ، التقويم التربوي ، الإدارة التربوية) إلاّ أن دوره الإداري واضح من خلال استخدام العمليات الإدارية الأساسية الآتية : التخطيط،التنظيم ، الإشراف، التنسيق ،التقويم ، وفي ضوء الدور الإداري للمشرف التربوي تم تطبيق مبادئ الإدارة بالأهداف على الإشراف التربوي وفق ما ذكره نشوان (1413هـ،ص253).
الافتراضات الأساسية لنموذج الإشراف بالأهداف:
يقوم نموذج الإشراف بالأهداف في فلسفته على افتراضات أساسية توجه حركته وكيفية تطبـيقه ، وهذه الافتراضات وفـق ما يذكره عدد من التربويين ومنـهم السعود( 1423هـ،ص220) ونشوان (1413هـ، ص65) وغيرهم ، هي :
1. يميل المعلمون في المؤسسات التربوية إلى معرفة وفهم النواحي المتوقع منهم أن يقوموا بها .
2. أن لدى المعلمين رغبة قوية في الاشتراك في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على عملهم .
3. يرغب المعلمون في الوقوف على أدائهم ، هل كان أداءً مرضياً أم أداء رديئاً ؟
وقد أدت هذه الافتراضات الثلاثة إلى بلورة أسس تفصيلية يقوم عليها نموذج الإشراف بالأهداف تتمثل فيما يأتي :
1. يميل أداء المعلمين إلى التحسن عندما يفهمون جيداً أهداف المؤسسة التربوية التي يعملون فيها .
2. يتجه أداء المؤسسة التربوية إلى التحسن عندما يكون هناك اتفاق بين المشرفين والمعلمين على الأمور التي سينجزها المعلمون .
3. يتجه أداء المعلمين إلى التحسن عندما يُعطون تغذية راجعة تعينهم على رؤية ما أنجزوا وما لم ينجزوا .
4. يتجه أداء المعلمين إلى التحسن عندما يعطون الفرصة للتعلم والنمو وإذا ما أقرّ رؤساؤهم لهم بما أنجزوا من أعمال .
مبادئ الإشراف بالأهداف :
يقوم الإشراف بالأهداف على مبدأين أساسين هما : مبدأ المشاركة و مبدأ تحديد الأهداف ، و ذلك على النحو الآتي :
أولاً : مبدأ المشاركة:
ضرورة المشاركة بين المشرفين والمعلمين في تحديد الأهداف ، وضرورة صياغتها وتحديدها على نحو يساعد على تحديد الوسائل والطرق المتعلقة بالتنفيذ ومن ثم طرق التقويم المناسبة لأن المشاركة فيها بين المشرفين والمعلمين تساعدهم جميعاً على زيادة فعاليتهم من أجل تحقيق الأهداف ، كما أنها تحقق النتائج الآتية :
1- الالتزام:
يساعد الإشراف بالأهداف على إيجاد نوع من الالتزام لدى جميع المشرفين والمعلمين نحو تحقيق الأهداف الموكلة إليهم ، وهذه فائدة كبيرة يحققها الإشراف بالأهداف ، و يتميز بها عن الإشراف التقليدي الذي يفرض الأهداف على المعلمين دون أن يكون لهم علاقة بصياغتها .
2- تحمل المسؤولية:
يساعد الإشراف بالأهداف على تحمل المسؤولية وذلك عندما يشارك المعلمون مشرفهم في صياغة الأهداف وتحديدها وحينما يتفقون على الأهداف ، ويوزعون الأدوار بينهم بحيث يتولى كل منهم أهدافاً محددة خاصة ويتولون إنجازها.
3- رفع الروح المعنوية:
فعندما يشترك المشرفون والمعلمون في التخطيط لعملهم ، يساعد ذلك على أن يحققوا ذواتهم ، بالإضافة إلى إكسابهم الشعور بأهمية ما يقومون به من عمل مما يرفع من روحهم المعنوية .
ثانياً: مبدأ تحديد الأهداف:
يقوم الإشراف بالأهداف على وضع الأهداف على شكل النتائج المرجو تحقيقها ، والأهداف غاية في الأهمية في الإشراف بالأهداف ، ولذا فلابد أن تكون هذه الأهداف واضحة لدى جميع المشرفين والمعلمين المعنيين بتحقيقها ومحددة بفترة زمنية معينة، يتم خلالها مراجعة ما ينجز من هذه الأهداف باستمرار وعلى فترات زمنية معينة .
مراحل تنفيذ الإشراف بالأهداف :
يمرّ تطبيق نموذج الإشراف بالأهداف بعدّة مراحل هي : مرحلة قراءة الموقف التعليمي ، ومرحلة وضع الأهداف ، و مرحلة وضع الخطة ، و مرحلة التنفيذ والمتابعة ، و مرحلة قياس الإنجاز ، وذلك على النحو الآتي :
المرحلة الأولى : قراءة الموقف التعليمي :
يكون ذلك من خلال زيارة المعلمين في مدارسهم و الإطلاع على ما يدور في المدرسة ، وما يقدمّه المعلمون لطلابهم ، ثم الاجتماع بهم لقراءة الموقف التعليمي ومدارسته .
المرحلة الثانية وضع الأهداف :
تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل والخطوات، وذلك لأن الأهداف جزء أساس وهام جداً في الإشراف بالأهداف وقد أشار إلى هذه المرحلة (أوديورن ) بقوله : إن الخطوة الأولى في الإدارة بالأهداف هي تحديد الأهداف ومن ثم اقتراح الأنشطة أو النشاطات اللازمة لتنفيذها، فإذا كانت صياغة الهدف مناسبة، فإن الأنشطة الأخرى توجه نحو الهدف .
وللأهداف شروط وخواص من أهمها وفق ما يذكره الهواري (1999م،ص106) ومطاوع وحسن (1402هـ،ص139) ما يأتي :
1- أن تتم صياغة الأهداف بشكل واضح ودقيق، وهذا يعني أنه يجب الابتعاد عن العبارات العامة والألفاظ الغامضة أو الكلمات التي لها معان متعددة وتحتمل التفسير بعدة وجوه.
2- أن تكون الأهداف واقعية ومعقولة، أي ممكنة التحقق، ويترتب على هذا دراسة إمكانات المدرسة والمعلمين وقدراتهم الفعلية على تحقيق الأهداف الموضوعة، وبشكل خاص الموارد المالية المتاحة والطاقات البشرية المطلوبة والزمن اللازم لتحقيق الأهداف، وأن لا تكون مثالية لدرجة يستحيل تحقيقها.
3- أن يشترك المشرفون والمعلمون في صياغة الأهداف و أن يتم ذلك بأسلوب شوري .
4- أن تتسم الأهداف بالمرونة التي تجعلها ممكنة التحقيق فيما لو تغير الموقف التربوي لأي سبب طارئ .
المرحلة الثالثة : وضع الخطة :
الخطة برنامج عمل لتحقيق هدف أو أهداف معينة ، والخطة جزء هام للإشراف الفعال ، إذ أن الهدف بدون خطة لتحقيقه ما هو إلاّ حلم أو توقع .ولذا يجب أن يكون لكل هدف خطة وجدول زمني ، تبين ما يجب القيام به لتحقيق الهدف .
ويتوقف تحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة على تحديد النشاطات التي ينبغي ممارستها لتحقيق هذه الأهداف، وكذلك تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة، ويتطلب ذلك دراسة احتياجات المدرسة والمعلمين الفعلية من الأموال المطلوب توفرها، والمواد والمعدات والأجهزة المطلوبة، ولذا فإنه يجب وضع خطة عمل لتأمين هذه الموارد بالكميات المطلوبة والنوعيات اللازمة في الوقت المناسب كي لا تقف حجر عثرة في وجه التنفيذ .
المرحلة الرابعة : التنفيذ والمتابعة :
بعد اكتمال المرحلة السابقة يبدأ التطبيق، ويعتمد التنفيذ على تحفيز المعلمين لإشباع دوافعهم المختلفة والعمل على تحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح المدرسة .ومن الضروري متابعة التنفيذ استناداً إلى المعايير المحددة مسبقاً .و متابعة التنفيذ في غاية الأهمية للتأكد من أن عمليات التنفيذ تسير وفقاً للخطة المرسومة وأن الانحرافات لا تتجاوز الحدود المقبولة ، ولذا فإن الهدف من المتابعة اكتشاف الأخطاء- أثناء التنفيذ- والتعرف على العقبات لتذليلها ولتصحيح المسار المؤدي إلى الهدف الأصل.
المرحلة الخامسة : قياس الإنجاز:
بما أن نموذج الإشراف بالأهداف يركز على تحقيق الأهداف بفعالية فإن الأمر يستوجب بل ويحتم وجود وسيلة لقياس الإنجاز، فبدون هذا العنصر يصعب الحكم عما إذا كانت الأهداف قد تحققت أم لا؟.
وفي هذا الشأن يقول ( دركر) "لن تكون هناك نتائج بدون تقديرها بموضوعية، فمن الضروري معرفة النتائج المرغوبة، وتحديد ما إذا كانت هذه النتائج المرغوبة قد تم تحقيقها وإنجازها، والقياس هنا يجب أن يكون قياساً للإنجاز أكثر من كونه قياساً للجهد" .
ولا يتم قياس الإنجاز في نهاية الخطة فقط، بل يجب أن تكون عملية القياس مستمرة. وتتم عن طريق التغذية الراجعة المستمرة. فالمشرفون والمعلمون يقّومون مدى تحقيقهم للأهداف باستمرار أثناء تقدمهم في العمل، والتغذية الراجعة تتم على فترات زمنية جنباً إلي جنب مع تنفيذ الخطة، وتفيد التغذية الراجعة في إجراء التعديل سواء في الخطة نفسها أو في الأهداف. (نشوان، 1413هـ ، ص 58).
ولذا فإن وجود معايير تقيس مدى تحقق الأهداف من الضرورة بمكان لأن دقة القياس ومصداقيته تعكس وبشكل جلي قدرة المؤسسة التربوية على تحقيق الأهداف المنشودة، وتوضح الانحرافات التي قد تحدث أثناء التنفيذ، وبالتالي يمكن تلافيها والتقليل من آثارها السيئة على المؤسسة التربوية بخلاف ما إذا أهملت واستفحلت فإن الأمر فيما بعد يكون أكثر صعوبة وأشد تعقيداً عند محاولة الخلاص أو العلاج لهذه الانحرافات. (السعود ، 1423هـ ،ص221)
شكل يبيّن كيفية تنفيذ الإشراف بالأهداف :
إيجابيات و سلبيات نموذج الإشراف بالأهداف :
لاشك أن لكل نموذج مزايا كما أن له سلبيات، وتظهر قدرة الإداري الناجح في محاولة تعزيز الايجابيات ومحاولة تلافي أو تقليل أثر السلبيات على العملية الإدارية.
أولاً : ايجابيات نموذج الإشراف بالأهداف :
لعل من أبرز ايجابيات نموذج الإشراف بالأهداف ما يأتي :
1- يجعل الأهداف واضحة ومحددة لجميع العاملين في المؤسسة التربوية ، ويعني بذلك صياغة الأهداف على نحو يساعد على قياسها وتقويمها .
2- يساعد الإشراف بالأهداف على تحديد أدوار ومسؤوليات وسلطات المشرفين والمعلمين في المؤسسة التربوية .
3- يلمس المعلم ثمرة جهوده بوضوح فتتحسن معنوياته وترتفع بالتالي إنتاجيته بفضل إنجاز الهدف الذي يضعه نصب عينيه فتتحسن تبعاً لذلك الإنتاجية .
4- يساعد الإشراف بالأهداف على زيادة فعالية تنفيذ الخطط ومتابعتها فهو يركز اهتمام العاملين على الأعمال التي تساهم فعلاً في بلوغ الأهداف المحددة مما يؤدي إلى عدم ضياع الجهد والوقت في أعمال غير مفيدة.
5- يساعد في تقييم الأداء وتحديد المسؤولية وتحقيق فعالية الرقابة، فالمعلمون يكونون مسؤولين عن تحقيق أهداف معينة والوصول إلى نتائج محددة ضمن إطار زمني واضح، وبالتالي يمكن تقييم أدائهم بنسبة ما يسهمون به في تحقيق هذه الأهداف والنتائج.
6- لنظام الإشراف بالأهداف تأثير فعال على نظام التعويضات والمكافآت والترقيات، فقد كان نظام المكافآت مبني على مبدأ الجدارة وهو تعبير فضفاض، وأصبح مرتبطاً بالأقدمية، أما نموذج الإشراف بالأهداف فيرى ضرورة ربط المكافأة والتعويض بدرجة إنجاز الأهداف، ودفع المكافآت بما يتناسب مع درجة تحقيقها .
7- تحسين عملية اتخاذ القرارات، حيث تتاح للمعلمين فرص المشاركة فيها وتبادل المعلومات وذلك وصولاً إلى قرارات أفضل.
8- يهيئ الإشراف بالأهداف الفرصة للمعلمين في المؤسسة التربوية للتطوير والنمو الذاتي.
9- يتحسن التنسيق والعمل الجماعي بين أفراد المؤسسة التربوية و تقل ازدواجية العمل.
10 ـ عناية الإشراف بالأهداف بنوعي التغذيةالراجعة الأمامية والمرتدة . ويقصد بالأمامية أو القبلية ما يقوم به المشرف التربوي من الاجتماع بالمعلم قبل الزيارة الصفية وإخباره بما يتوقع منه ، والاتفاق معه على الأهداف المرادتحقيقها ، أما التغذية الراجعة أو المرتدةأو البعدية فيقصد بها ما يقوم به المشرف التربوي من الاجتماع بالمعلم بعد الزيارةالصفية لإخبار المعلم بنواحي القوة والضعف لديه ومدى تحقيقه للأهداف .
ويفصّـل البعض مزايا الإشراف بالأهداف وفق الآتي :
· مزايا الإشراف بالأهداف بالنسبة للمدرسة .
· مزايا الإشراف بالأهداف بالنسبة للمشرفين .
· مزايا الإشراف بالأهداف بالنسبة للمعلمين .
أ -مزايا الإشراف بالأهداف بالنسبة للمدرسة :
ينتج عن تطبيق نموذج الإشراف بالأهداف مزايا عديدة للمدرسة من أهمها :
· يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء .
· معرفة جميع أعمال المدرسة ومتابعتها في ضوء الأهداف المحددة .
· يبين الأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى معايير الإنجاز المطلوبة مما يساعد المدرسة على تحديد الأفراد المطلوب تدريبهم أو نقلهم إلى أعمال أخرى أو الاستغناء عنهم .
· تؤدي المشاركة في تحديد الأهداف إلى انخفاض معدل دوران العمل ومعدل الغياب وانخفاض الشكوى .
· كما تؤدي المشاركة في تحديد الأهداف إلى ارتفاع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي وزيادة درجة الرضا الوظيفي .
· يؤدي إلى العدالة في توزيع الحوافز حيث أن ما يتقاضاه أي فرد يكون بناء على النتائج التي يحققها .
· تزويد المدرسة بأسس موضوعية لتقييم الأداء .
ب – مزايا الإشراف بالأهداف بالنسبة للمشرفين :
و من أهمها ما يأتي :
· يمكن من تحقيق الاتصال الفعال بصورة أفضل نظراً لأن المشرف والمعلم قد اتفقا على النتائج المتوقعة في العمل .
· يؤدي إلى توفير الوقت للقيام بعمليات الإدارة نفسها بسبب تشجيع تفويض السلطة للمعلمين في بعض المهام نظراً لتحديدها .
· يساعد المشرف التربوي على حسن التقدير لاستغلال الموارد المتاحة في ضوء ما هو مطلوب منه وعمل ما هو ضروري لإنجاز أهداف المدرسة .
· يؤدي إلى تركيز المشرفين التربويين على النتائج بدلاً من التركيز على الأنشطة كنشاط .
· يؤدي إلى اكتشاف المعلمين الجديرين بالترقي نظراً لتوفير البيانات المحددة بكل عمل .
ج -مزايا الإشراف بالأهداف بالنسبة للمعلمين :
و من أبرزها ما يأتي :
· يقوى الشعور بالانتماء للمدرسة لدى المعلمين نظراً لمشاركتهم في تحديد الأهداف.
· يشجع المعلم على تطوير نفسه من خلال تحليله لنقاط قوته وضعفه ، ومن ثم يتعرف على ما يجب عليه أن يفعله .
· يدرك المعلم مدى تقدمه في العمل فترفع روحه المعنوية .
· يُكون الإشراف بالأهداف لدى المعلم فكرة موضوعية عما يستحقه من حوافز بناءً على أهدافه الفعلية .
ثانياً : سلبيات نموذج الإشراف بالأهداف:
لعل من أبرز سلبيات نموذج الإشراف بالأهداف ما يأتي :
1- صعوبة توفير أنظمة مساندة يتطلبها استخدام نموذج الإشراف بالأهداف كوجود نظام معلومات متطور ونظام رقابة وتقييم فعال ومعايير دقيقة لقياس مدى تحقق الأهداف. وتلك الأنظمة المساندة لا تكون في الغالب متوفرة في الدول النامية بدرجة متطورة .
2- التركيز على أهداف قصيرة المدى ونسيان الأهداف بعيدة المدى التي يتطلبها التخطيط السليم، والميل إلى تحقيق نتائج سريعة على حساب نتائج كبيرة مهمة .
3- إنفاق الوقت الكثير في العمليات التي يتطلبها نموذج الإشراف بالأهداف والاهتمام بملء النماذج وتعبئة الاستبيانات وتحبير الصفحات دون أن يكون لذلك كله مردود واضح على المؤسسة التربوية وإنجاز نتائج ملموسة.
4- المقاومة الشديدة التي يتعرض لها إدخال نموذج الإشراف بالأهداف وتطبيقه في بداية المطاف، إذ أن استخدام هذا الأسلوب يعتبر محاولة لأحداث تغيير في الأساليب الإدارية القديمة، وفي ذلك تحد كبير للمشرفين والمعلمين لأنه يتطلب منهم تغيير أنماط تفكيرهم وسلوكهم وأساليبهم في العمل وهذا بالطبع يحتاج إلى طاقة فكرية ونفسية كبيرة تمكنهم من التأقلم مع الجديد والتعود عليه.
5- صعوبة تحديد أهداف بعض الأنشطة والبرامج بوضوح وبشكل كمي، وصعوبة تحديد معايير دقيقة لقياسها وتقييم مدى إنجازها وهذه ظاهرة شائعة في العديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات التي تقدم خدمات مثل التعليم والصحة .
6- المبالغة في التركيز على الأهداف والنتائج المتوقعة يؤدي إلى إهمال الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف، مما ينعكس بصورة سلبية على فعالية المؤسسة التربوية في المدى الطويل.
7- الميل إلى الاهتمام بالبرامج أكثر من الاهتمام بالمعلم الذي هو جوهر العملية التربوية وإغفال حاجاته وأهدافه في سبيل أهداف المؤسسة التربوية وحاجاتها.
صعوبات تطبيق نموذج الإشراف بالأهداف :
رغم أن نموذج الإشراف بالأهداف يُعد من المداخل المفيدة في الإشراف التربوي إلا أن تطبيقه يواجه بعض الصعوبات و منها :
1 - يتطلب الإشراف بالأهداف وضع أهداف قد تكون أعلى أو أقل من الإمكانات المتاحة.
2 - صعوبة التنسيق بين الأهداف الفرعية .
3 - يتطلب الإشراف بالأهداف وضع أهداف واضحة لسهولة قياسها ، وهذا الشرط يصعب تحقيقه .
4 -يحتاج تحقيق الأهداف إلى وقت وجهد كبيرين نظراً لاشتراك كافة المستويات التنظيمية في وضع الأهداف وكثرة الإجراءات والاتصالات .
5 -يحتاج تطبيق نموذج الإشراف بالأهداف إلى مهارة إدارية عالية لوضع الأهداف بالتفاعل بين المشرف والمعلم ، وقد لا تتوفر هذه المهارة لدى البعض .
6 -عدم رغبة بعض المعلمين في المشاركة عند وضع الأهداف .
7 -مقاومة بعض المشرفين لنموذج الإشراف بالأهداف .
8 -صياغة الأهداف أحياناً بطريقة براقة تظهر محاسن الإشراف وتخفى مساوئه .
9 – صعوبة تطبيق القياس الكمي على بعض الأهداف ، مثل إجراء البحوث على سبيل المثال.
رابعاً : الإشراف التطويري :
هو أحد أنواع الإشراف التربوي الحديثة التي تهتمبالفروق الشخصية والمهنية بين المعلمين من خلال انتقاء أحد الأنماط الإشرافيةالتالية :
رسم توضيحي للإشراف التطويري :
الإشراف التطويري يتضمن ثلاثة أنماط من الإشراف التربوي تقدم بحسب خصائص المعلم
من يتسم بـ : تفكير تجريدي عالي ومستوى عال من الالتزام بالعمل .
من يتسم بـ : تفكير تجريدي منخفض وبعدم حب العمل أو الإلتزام به
الإشراف غير المباشر :يقوم على مبدأ الخبرات الخاصة بالفرد فالمعلم يجب أن يتوصل إلى حلول نابعة من ذاته بغرض تحسين مستوى طلابه .
من يتسم بـ : مستوى متوسط من التفكير التجريدي والالتزام بالعمل
يعود ظهوره إلى الدكتور (كارل جلكمان) . والفرضية الأساسية فيه هي أن المعلمين راشدون وأنه يجب في أثناء الإشراف عليهم والأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التطورية التي يمرون بها ، فعلى المشرف التربوي أن يعرف ويراعي الفروق الفردية بين المعلمين . وفكرة الإشراف التطويري هي أن هناك عاملين أساسيين يؤثران على أداء المشرف وتعامله مع المعلم هما :
1- نظرة المشرف التربوي لعملية الإشراف وقناعته بها .
2- صفات المعلم .
أولا: نظرة المشرف لعملية الإشراف وقناعاته بها تملي عليه عشرة أنماط من السلوك .وهذه الأنماط من السلوك تحدد ثلاث طرق للتعامل في الإشراف التربوي : الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة والطريقة التعاونية .
1- الطريقة غير المباشرة ) الاستماع ، الإيضاح، التشجيع ،التقديم )
2- الطريقة التعاونية : ( حل المشكلات ، الحوار ( المناقشة ) ، العرض )
3- الطريقة المباشرة : ( التوجيه ( الأمر ) ،إعطاء التعليمات ، التعزيز )
ففي الطريقة المباشرة يميل المشرف إلى السيطرة على ما يجري بين المشرف والمعلم وهذا لا يعني بالضرورة أن المشرف متسلط أو عشوائي الطريقة ، بل المقصود أن المشرف يضع كل شيء يريده من المعلم ويشرحه بدقة ويبين له ما هو المطلوب منه . فهذه الطريقة تفترض أن المشرف يعلم أكثر من المعلم عن عملية التعليم وعليه فإن قرارات المشرف أكثر فعالية من ترك المعلم يختار لنفسه . (جلكمان 1999).
وفي الطريق التعاونية يتم الاجتماع مع المعلم لبحث ما يهمه من أمور , وينتج عن هذا الاجتماع خطة عمل .أما الطريقة غير المباشرة فتقوم على افتراض أن المعلمين قادرون على إنشاء الأنشطة والبرامج التربوية التي تساعد على النمو المهني من خلال تحليل طرقهم في التدريس . فتكون مهمة المشرف هي تسهيل العملية والمساعدة فقط.
ثانيا: صفات المعلم :
وهي مهمة في تحليل ممارسات الإشراف ويرى(جلكمان) أن صفات المعلم تفهم بشكل أوضح بوصفها نتاجا لخاصيتين:
- مستوى الولاء للمهنة أو التزامه بها , ويتضح هذا من اهتمامه بزملائه المعلمين ومدى ما يخصصه من وقت لعمله.
- مستوى التفكير التجريدي ,فأصحاب المستوى المنخفض من التفكير التجريدي يصعب عليهم مواجهة ما يقابلهم من مشاكل تربوية فلا يستطيعون اتخاذ القرارات المناسبة فلذلك يحتاجون إلى توجيه مباشر من المشرف بينما المعلمون ذوو مستوى التفكير التجريدي المتوسط يحتاجون إلى نوع من المساعدة في عملية تعاونية .والقسم الثالث , وهم ذوو التفكير التجريدي العالي تكون لديهم القدرة على تصوير المشكلات ووضع الحلول لها.
ولعل أهم ميزات الإشراف التطويري مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين , بحيث أنه لا يجب على كل المعلمين الخضوع لعملية إشراف واحدة . إلا أنه في الوقت نفسه يحتم على المشرف إلزام المعلم بأسلوب معين من الإشراف بالإضافة إلى إن وضعه في فئة الأسلوب المباشر قد تجعله يظهر أمام بقية زملائه على أنه أقل ذكاء أو نضجا منهم .
ويوضح الشكل التالي نموذج الإشراف التطويري :
مراحل تطبيق الإشراف التربوي التطويري:
1) مرحلةالتشخيص :
أ ـ جمع المعلومات الأولية .
ب ـ الزيارة الصفية .
ج -المداولاتالإشرافية.
2) مرحلة التطبيق : ( اختيار النمط الإشرافي المناسب للمعلم ) .
3) مرحلة التطوير .
الارتقاء والتدرج بسلوك المدرس من " النمط المباشر،إلى " النمط التشاركي " إلى النمط غير المباشر .
رسم توضيحي لمراحل الإشراف التطويري :
ـ صعوبة في تحديد المشكلة
ـ ضعف في إدارة الصف
ـ طرق تدريس تقليدية
يتبع ....
ـ قادر على تحديد المشكلة
ـ يجد صعوبة في حل المشكلة
ـ يرغب في حلها بنفسه
يتبع ....
ـ قادر على تحديد المشكلة ووضع خيارات وخطة لحلها
ـ قائد تربوي
ـ يعتبر الطالب محور العملية يتبع .....
1ـ التوجيه ( الأمر )
2ـ إعطاء التعليمات
3ـ التعزيز
1ـ حل المشكلات
2ـ الحوار ( المناقشة )
3ـ العرض
1ـ الإستماع
2ـ الإيضاح
3ـ التشجيع
4ـ التقييم
[IMG]file:///D:\DOCUME~1\nesnas\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image009.png[/IMG]
خامساً : الإشراف التنوعي"التمايزي":
يرجع تطوير هذا النمط إلى ألان جلاتثورن (Glatthorn) , ويقوم على فرضية وهي: بما أن المعلمين مختلفون فلا بد من تنوع الإشراف عليهم فهو يعطي المعلم ثلاثة أساليب إشرافية لتطوير قدراته وتنمية مهاراته ليختار منها ما يناسبه وقد يكون هناك تشابه بينه وبين الإشراف التطويري إلا أن الفارق بينهما ، أن الإشراف التنوعي يعطي المعلم الحرية في تقرير الأسلوب الذي يريده أو يراه مناسبا له في حين إن الإشراف التطويري يعطي هذا الحق للمشرف التربوي.
وقبل الدخول في تفاصيل هذا النموذج ينبغي التنبيه إلى أن كلمة "مشرف" هنا تشمل كل من يمارس العمل الإشرافي , مثل مدير المدرسة أو زميل , ولا يقتصر على من يشغل مسمى المشرف التربوي.
خيارات الإشراف التنوعي:
أولاً : التنمية المكثفة:
وهو أسلوب مشابه للإشراف الصفي(الاكلينيكي) إلا انه يختلف عنه من ثلاثة وجوه:
1. يركز الإشراف الصفي على طريقة التدريس بينما أسلوب التنمية المكثفة ينظر إلى نتائج التعلم.
2. يطبق الإشراف الصفي- غالباً - مع جميع المعلمين مما يُفقده أهميته ، في حين أن أسلوب التنمية المكثفة يطبق مع من يحتاج .
3. يعتمد الإشراف الصفي على نوع واحد من الملاحظة في حين أن أسلوب التنمية المكثفة يستفيد من أدوات متعددة (جلاتثورن1997).
ويؤكد جلاتثورن(Glatthorn 1997 P.57) على ثلاث خصائص للتنمية المكثفة:
1.أهمية الفصل بين أسلوب التنمية المكثفة وبين التقويم لأن النمو يحتاج إلى علاقة حميمة ونوع من التجاوب والانفتاح.
2.يجب أن يقوّم المعلم شخص أخر غير المشرف الذي شارك معه في الأسلوب الإشرافي.
3.يجب أن تكون العلاقة بين الطرفين –المشرف و المعلم- علاقة أخوية تعاونية.
وهناك ثمانية مكونات لأسلوب التنمية المكثفة هي :
1.اللقاء التمهيدي . ويفضل أن يكون في أول العام الدراسي بحيث يبحث المشرف مع المعلم الأوضاع العامة ويحسس المشرف ما قد يحتاج إلى علاج ويحاول توجيه العلاقة بينهما وجهة إيجابية.
2.لقاء قبل المقابلة الصفية وهو لقاء يتم فيه مراجعة خطة المعلم للدرس المراد ملاحظته وتحدد فيه أهداف الملاحظة الصفية .
3.الملاحظة الصفية التشخيصية حيث يقوم المشرف بجمع المعلومات المتعلقة بالجوانب ذات العلاقة بالأمر المراد ملاحظته لتشخيص احتياجات المعلم .
4.تحليل الملاحظة التشخيصية . وفيها يقوم المعلم والمشرف التربوي جميعا أو على انفراد بتحليل المعلومات التي تم جمعها في الملاحظة ومن ثم تحدد النقاط التي تدور حولها النشاطات التنموية .
5.لقاء المراجعة التحليلي ، وفيه يتم تحليل خطوات الدرس وبيان أهميته لنمو المعلم .
6.حلقة التدريب ، وهو لقاء يعطي فيه المشرف نوع التدريب والمتابعة لمهارات سبق تحديدها أثناء العملية التشخيصية .وتتكون حلقة التدريب تلك من الخطوات التالية :
أ0 التزويد بالمعلومات الأساسية لتلك المهارة .
ب0 شرح تلك المهارة .
ج0 عرض المهارة عملياً .
د0 تمكين المعلم من التدرب الذاتي عمليا وبطريقة موجهة مع إعطاء معلومات راجعة عن وضعه.
هـ0 تمكين المعلم من التدرب المستقل مع إعطاء معلومات راجعة عن وضعه .
7.الملاحظة المركّزة . وفيها يركز المشرف على ملاحظة تلك المهارة المحددة وجمع معلومات عنها .
8.لقاء المراجعة التحليلي المركّز . وفيه تتم مراجعة وتحليل نتائج الملاحظة المركّزة .
ويلاحظ أن هذه الخطوات معقدة نوعًا ما وتستهلك الوقت ، إلا أن جلاتثورن يعتذر عن هذا بأن هذه الطريقة سوف تطبق مع فئة قليلة من المعلمين .
ثانياً : النمو المهني التعاوني :
الخيار الثاني من خيارات الإشراف التنوعي هو النمو المهني التعاوني وهو رعاية عملية نمو المعلمين من خلال تعاون منظم بين الزملاء .
يذكر جلاتثورن(1997) ثلاثة مسوغات لطرح النمو المهني التعاوني في الإشراف التنوعي :
- الوضع التنظيمي للمدرسة ، فالعمل الجماعي التعاوني بين المعلمين له أثر على المدرسة أكبر من العمل الفردي , كما أن له أثراً في تقوية الروابط بين المعلمين وكذلك فيه ربط بين تطور المدرسة ونمو المعلمين وينظر إلى نمو المعلمين على أنه وسيلة لا غاية فهو وسيلة إلى تحسين التعلم من خلال تحسين التعليم .
- وضع المشرف : هذا الأسلوب الإشرافي يبين دور المشرف المساند ويمكنه من التوسع في دائرة عمله.
- وضع المعلم ، وهذا الأسلوب يجعل المعلم يستشعر مسؤوليته عن تنمية نفسه وانه ينتمي إلى مهنة منظمة ومقننة ونامية كما أنه يخفف من العزلة التي يعيش فيها المعلمون غالبا ويمكنهم من التفاعل مع زملائهم والاستفادة منهم.
ومن صور النمو المهني التعاوني ما يلي :
- التدريب بإشراف الزملاء (تدريب الأقران) : وهو أكثر صور النمو المهني التعاوني حيث تقوم مجموعة من الزملاء بملاحظة بعضهم بعضا في أثناء التدريس ومناقشة الجوانب السلبية واقتراح حلول لها والتدريب على تطبيقها وتتم في هذا الأسلوب تقريبا خطوات النمو المكثف نفسها لكنها بين الزملاء دون تدخل مباشرة من المشرف التربوي وتشير كثير من الدراسات إلى أن هناك أثرا كبيرا لهذا النوع من التدريب على نمو المعلم واكتسابه لمهارات تدريسية جديدة كما أنه يقوم الاتصال بين الزملاء ويشجعهم على التجريب وتحسين أساليب محددة في طرق التدريس Glatthorn 1997 P.59)
- اللقاءات التربوية : وهي نقاشات منظمة حول موضوعات مهنية وتربوية وعلمية لرفع المستوى العلمي للمعلمين ويجب أن تكون هذه اللقاءات منظمة حتى لا تتحول إلى كلمات لا هدف منها .
- تطوير المنهج: مع أن المنهج معد مسبقا إلا أن تطبيق المعلمين له يتفاوت ويبقى تطبيق المعلم للمنهج أثر كبير في أن يؤتي المنهج ثماره فيعمل المعلمون بشكل جماعي أو على شكل فرق لوضع خطة لتطبيق المنهج وتعديل ما يمكن تعديله أو سد بعض الثغرات التي تكون في المنهج كذلك البحث عن السبيل الأنسب لتنفيذ المنهج وتطبيقه وحل ما قد يعترض المعلمين من مشكلات في ذلك أيضا عمل تقويم للمنهج وما يتبع ذلك من اقتراحات للتطوير .
- البحوث الميدانية : البحوث الميدانية وهي البحوث التي يقوم بها المعلمون وتتعلق بأمر من الأمور التربوية العلمية وهذا النوع من البحوث يساهم في دعم العمل الجماعي بين المعلمين يساعد على تطوير التدريس ورفع مستواهم التربوي والعلمي والمهني.
ويمكن لكل مدرسة على مايراه جلاتثورن أن تصوغ ما يناسبها من صور النمو المهني التعاوني ويؤكد جلاتثورنGlatthorn 1997 P.59 ))على أن هذا الخيار لا يؤتي ثماره المرجوة إلا بتوافر الشروط التالية:
- وجود الجو التربوي العام الذي يدعم العملية.
- مشاركة القاعدة وهم المعلمون ودعم القمة وهم المسؤولون.
- لزوم البساطة والبعد عن التكلف والرسميات المبالغ فيها.
- إيجاد التدريب اللازم .
- مكافأة المشاركين.
ثالثاً : النمو الذاتي :
الخيار الثالث من خيارات الإشراف المتنوع هو النمو الذاتي وهو عملية نمو مهنية تربوية يعمل فيها المعلم منفرداً لتنمية نفسه وهذه الطريقة يفضلها المعلمون المهرة وذوو الخبرة ففي هذا الخيار يكون نمو المعلم نابعا من جهده الذاتي وإن كان سيحتاج من وقت لآخر إلى الاتصال بالمشرف التربوي .
يقوم المعلم بوضع هدف أو أكثر من أهداف النمو لمدة سنة ويضع خطة لتحقيق هذا الهدف أو الأهداف ثم ينفذ الخطة وفي النهاية يعطي تقريراً عن نموه . ودور المشرف هنا هو المساندة وليس التدخل المباشر.
ولنجاح عملية النمو الذاتي ينبغي مراعاة النقاط التالية:
1.إعطاء التدريب الكافي لمهارات الإشراف الذاتي مثل : وضع صياغة الأهداف ، فقد وجدت بعض الدراسات أن المعلمين يعانون من مصاعب في وضع الأهداف .
2.تصميم خطط واقعية وفاعلة لتحقيق الأهداف.
3.تحليل تسجيلات المعلم نفسه حيث إن كثيرا من المعلمين يجدون صعوبة في ملاحظة أنفسهم وتحليل ما يرونه مسجلا أمامهم من سلوكيات التدريس .
4. تقويم التقدم والنمو .
5. إبعاد البرنامج عن التعقيد مثل الإكثار من الأهداف أو اللقاءات الإعدادية أو الأعمال الكتابية .
6.توفير المصادر اللازمة .
7.إيجاد وسائل للحصول على معلومات راجعة عن التنفيذ فمن أهم عيوب هذا الأسلوب عدم وجود تلك الوسائل فالمعلم يعمل لوحده وليس لديه من يزوده بتلك المعلومات .
8.تشجيع المعلمين على العمليات التي تركز على التفكير والتأمل في عمل المعلم نفسه ووضع ملف تراكمي لأداء المعلم يساعد على هذا.
ويلاحظ أن الإشراف المتنوع يسعى إلى الاستفادة من أساليب الإشراف الأخرى وتطويعها لتناسب أكبر قدر من المعلمين كما أنه يحاول تزويد المعلمين بأكبر عدد من عمليات الإشراف وأنشطته ليتمكن كل معلم من اختيار ما يناسبه ويحقق نموه العلمي والمهني فالمرونة من أهم سمات هذا الأسلوب الإشرافي وهي التي تعطيه القدرة على التكيف مع الأوضاع المدرسية المختلفة .
والشكل التالي يبيّن أساليب الإشراف التنوعي :
سادساً : الإشراف الإلكتروني :
مفهوم الإشراف الإلكتروني :
هو : ( نمط إشرافي يقدم أعمال ومهامالإشراف التربوي عبر الوسائط المتعددة على الحاسب الآلي وشبكاته إلى المعلمينوالمدارس بشكل يتيح لهم إمكانية التفاعل النشط مع المشرفين التربويين أو مع أقرانهمسواء أكان ذلك بصورة متزامنة أو غير متزامنة مع إمكانية إتمام هذه العمليات فيالوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروف المشرفين التربويين فضلاً عن إمكانية إدارةهذه العمليات من خلال تلك الوسائط .
وإذا كان التعليمالإلكتروني : هو ( طريقة للتعلم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب آليوشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ،وآليات بحث ومكتبات إلكترونية ،وكذلك بوابات الإنترنت سواء عن بعد ، أو في الفصل الدراسي ، المهم هو استخدامالتقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبرفائدة ، فإن إسقاط التعريف السابق على الإشراف الإلكتروني يفضيإلى التالي :
الإشراف الإلكتروني : ( نمط للإشراف باستخدام آليات الاتصالالحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ،وآليات بحثومكتبات إلكترونية ، وكذلك بوابات الإنترنت سواء عن بعد ، أو في مكتب التربية والتعليم ، أوفي المدرسة ، أو الفصل الدراسي ، وهو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال وتبادلالمعلومات والخبرات للمعلم والمشرف بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
ويرىآخرون أن الإشراف الإلكتروني هوذلك النمط من الإشراف الذي يعتمد علىاستخدام الوسائط الإلكترونية في الاتصال بين المشرفين والمعلمين ، وبين المشرفينوالمؤسسة التعليمية، فالإشراف يكون بشكل حقيقي وليس افتراضياً )0
لماذا نسعى إلى تطبيق الإشراف الالكتروني ؟
1)المطلب الوطني:
تسعى حكومة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطانبن عبد لعزيز إلى تطبيق الحكومة الالكترونية ، و إدخال التقنية في جميع العملياتالإدارية و الفنية في الوزارات و الأجهزة الحكومية كافة ، و لاشك أن تطبيق الإشرافالالكتروني يصب في هذا التوجه السامي
2) المطلب التربوي :
التجديد و التطويرفي مجالات التربية أمراً حتمياً و ليس خياراً لاستشراف المستقبل من خلال تغييرطريقة التفكير ، و اتباع أساليب جديدة تفتح أفاقاً واسعة للتعلم الذاتي .
3) المطلب التقني :
يمتاز وقتناالمعاصر بأنه عـصر التقنية ، و عصر الفضائيات ، و عصـر التعلم عن بُعد ، و عصرالحاسوب .
كما تنامت وسائل الاتصال في هذا العصر تنامياً عجيباً، فأصبح العالم كأنه قرية صغيرة 0
4) المطلب الإداري :
إن تطبيق الإشرافالالكتروني يعالج كثيراً من المشكلات التي تواجه كثيـراً من المشرفين ،
و منها :ـ نقص أعداد المشرفين التربويين في مقابل زيادة أعداد المعلمين 0
ـ بُعد بعضالمدارس عن إدارات التربية و التعليم و مكاتب التربية والتعليم .
وآخـر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين ,,,
بعض المراجع
1- " الإشراف التربوي" ( 2002) ، سعيد جاسم الأسدي وآخر.
2- الإدارة والإشراف التربوي : اتجاهات حديثة . (1998) ، رداح الخطيب وآخرون
3- " أسس الإدارة التربوية والمدرسية والإشراف التربوي " (2001 ) ، تيسير الدويك وآخرون .
4- " الإشراف التربوي : اتجاهات حديثة " ، ( 2002) راتب السعود .
5- الإدارة التعليمية والإشراف التربوي " ، (2001) ، جودت عزت عطوي .
6- " تجديدات في الإشراف التربوي " ، (2001 ) ، محمود أحمد المساد .
7- " الإدارة والإشراف التربوي بين النظرية والتطبيق " ( 19829 ، يعقوب نشوان .
8- ورقة عمل لـ / د.عبد الكريم بن عبد العزيز المحرج .
9- بعض مواقع الشبكة العنكبوتية .
10- دليل المشرف التربوي الصادر عن وزارة التربية والتعليم .