أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
هدا بحث في معنى التأويل عند السلف وعند الخلف
أرجو أن أكون قد وفقت و الله المستعان
المبحث الأول معنى التأويل عند السلف
أول معنى من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.
التأويل لغةً:
مصدر أوَّل يوؤل تأويلاً، وأوَّل مأخوذة من كلمة "عاد"، فآل إلى الشئ يعني عاد إليه ورجع إليه، ومنه "المآل" يعني المرجع وهو ما سترجع إليه وتعود إليه، ومنه كلمة "آل فلان" أي من ينتسب إليهم ويرجع إليهم، فآل الشخص هم مرجعه، فيقال: أنت من آل إبراهيم أي أنك ترجع إلى قوم إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى يعبر بـ"آل إبراهيم" عن الأنبياء كلهم، فكل الأنبياء يعودون ويرجعون إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويقال آل فرعون لكل من انتسب إلى فرعون، فكلمة "آل إلى" معناها عاد ورجع.
و عندما نتكلم عن التأويل في معناه اللغوي نجد أنه هو المعنى الذي استخدمه القرآن الكريم، فالكلام يقع على حقائق وأشياء، فمثلاً إذا قلت لفظ "القلم" علامَ ترجع فيما ترى؟ فلا يصح أن تعطيني كتاباً، فإذا قلت لك: أريد قلماً، فأوِّل هذا الكلام، يعني ضعه على الموقع المطلوب، فلفظ "القلم" يعود إلى ذات القلم وحقيقته.
إذاً، المعنى الأول من معاني التأويل هو: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.
و هذا هو المعنى الرئيسي والأول الذي ورد في القرآن، بل هو المعنى الوحيد الذي ورد في القرآن.
تكررت كلمة "التأويل" في القرآن حوالي عشر مرات، وفي جميع استعمالاتها تأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فمثلاً لفظ "القلم" تأويلها أن ترجع إلى كيفية القلم وحقيقته، فتعود عليه ولا تعود على غيره، وهي التي قلنا عنها بأنها دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على كل ما وضع له، فكلمة التأويل تعني أنني أريد أن أعرف ما الذي يريده المتكلم من كلامه أي أريد أن أعرف المدلول الذي يقصده والحقيقة التي يؤول إليها كلامه وعلام ينطبق كلامه، فكوني أصل إلى فهم مراده فقد فهمت تأويل كلامه.
تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه.
ولذلك يقال بأن هذا النوع من التأويل (وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام) يُستخدم في نوعي الكلام، فالكلام إما خبر وإما أمر، والخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، والأمر هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب ولكن يتطلب التنفيذ، فالخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب التنفيذ.
فإذا أخبرني أحد بشئ، فما تأويل هذا الخبر؟
تأويل هذا الخبر وقوعه، فإذا قلت لك: أنا متوقع -إن شاء الله- أنه سيحدث كذا وكذا، فهذا الكلام خبر، فما تأويله؟ وقوعه وحدوثه في المستقبل، وأما تأويل الأمر فتنفيذه، فلما أقول لك: "اسقني ماءً" فتأويل هذا الكلام أن تُحضر لي الماء.
وسنبحث في الأدلة على هذه القضية من كلام السلف وفهم السلف لهذه المعاني، فهم فهموا أن تأويل الخبر وقوعه وأن تأويل الأمر تنفيذه، لأنهم يفهمون أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، قال سفيان بنعيينة: "السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر".
وقد استُحدث معنىً آخر للتأويل واشتهر الآن وأصبح هو الذي يُشار إليه بالبنان ونسوا المعنى الأصلي الذي كان يتكلم عنه الصحابة رضي الله عنهم، فعندما يقولون: هل تقول بالتأويل أم لا؟ فإنهم يتكلمون عن معنىً آخر غير موجود لا في القرآن ولا في السنة، فحن نريد أن نُعيد الأمور إلى نِصابِها بحيث أنك تفهم التأويل كما ينبغي كما ورد في القرآن والسنة، فنحن نريد القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فماذا الذي ورد في القرآن والسنة؟
سيدنا يوسف عليه سلام قال لوالده:
( يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ((سورة يوسف 4)
1.فهذه رؤيا عبَّر عنها يوسف عليه سلام لوالده بكلام، هذا الكلام ما حقيقته؟
تمر الأيام، ثم بعد ذلك (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا) أي: هذا الذي تراه وهذه الحقيقة التي أمامك (تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا) سورة يوسف الاية100 إذاً، فالحقيقة التي يؤول إليها الكلام هو معنى التأويل المقصود في القرآن.
في قول الله تعالى عن الكافرين (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ) الاعراف 53
أي: ماذا ينتظر هؤلاء الكافرون؟ هل ينتظرون تأويله؟! فتأويله يعني وقوع ما أخبر الله تعالى به من جنة ونار وحساب وبعث ... وغيرها من الأشياء التي كذَّب بها الكافرون، فهل ينتظر هؤلاء إلا وقوع ومجئ هذه الأحداث ورؤيتهم لها بأعينهم؟! قال تعالى (يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ) الاعراف53
أي أنها جاءت وأخبرت عن هذه الأشياء التي نراها (فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) الاعراف (53)
، وهذا عندما يرون الحقيقة التي أخبرتهم الرسل عنها وحذروهم منها، فقالوا لهم: (إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) الانعام (134)
(إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ) الذاريات (5) (6)
إلى غير ذلك مما أخبرت به الرسل، فكذَّبوا بهم، فالله تعالى يقول: ماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينتظرون أن يروا ذلك بأعينهم؟
قال الله تعالى (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) يونس (39)
أي كذَّبوا بكيفية هذه الحقائق التي ستحدث، وبأنها ستحدث (وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) يونس (39)
أي لم تأت بعد الحقيقة التي سيرونها بأعينهم.
(وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ) يونس (36)
2.أنهم رأيا رؤيا عبَّروا عنها بكلام، فما معنى هذا الكلام، وما حقيقته؟
3.يوسف عليه السلام لا يخبر عن حقيقة إلا بوحي، فليس بمقدور أي شخص أن يُخبرنا عن حقيقة سوف تحدث لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، والقدر سر مُخبَّأ، فلا يطلع على القدر لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيوسف u سيخبر بُناءً عن وحي، وليس بقياس أو نحو ذلك، فتأويل الرؤيا القصد منها تفسيرها بما يساعد الشخص على الاستقامة، فالعالم الذي عنده تقوى ودين عندما يسمع رؤيا من شخص يفسرها بحيث أنه يدفعه إلى الاستقامة، وأما أن يُخبره بأشياء غيبية فلا، فتأويل الرؤى بالنسبة للأنبياء يكون عن طريق الوحي.
فيوسف عليه السلام قال لهما (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) (يوسف:41)
أي أن هذا هو تأويل الكلام، فالتأويل هنا معناه: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.
4. (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (آل عمران:7). فما معنى التأويل هنا؟
معناه: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على أساس أن هؤلاء الناس يبحثون عن الكيفية الحقيقية التي أخبر ربنا تبارك وتعالى عنها من خلال قوله مثلاً: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه 5)
فما تأويل هذا الخبر؟ تأويله وقوعه، ووقوعه أن الله تعالى على العرش بكيفية تليق بجلاله لا يعلمها إلا هو، فهم يبحثون عن الكيفية الغيبية، فيبحثون عن تأويلها، وتأويل
(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه 5)
هو وقوع ذلك، وليس تأويله بمعنى تفسير الاستواء بالاستيلاء.
فتأويل (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه 5)
عند السلف هو الكيفية الحقيقية الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، فالذي يبحث عن هذه الكيفية في قلبه زيغ.
ثم قال تعالى (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)
أي أنه لا يعلم أحد هذه الكيفية الغيبية إلا الله عزوجل، فالتأويل معناه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.
نريد الآن أدلة من كلام الصحابة أنفسهم أنهم فهموا أن التأويل معناه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وأن تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه.
ننظر الآن إلى الأدلة التي وردت في السنة:
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عيه وسلم يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي" يتأول القرآن، والمراد بقولها رضي الله عنها "يتأول القرآن": أي يُنفِّذ الأمر الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) (النصر 3)
فهذا أمر يتطلب التنفيذ، فتنفيذ النبي صلى الله عيه وسلم للأمر في قوله تعالى
(فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ)
1.سَمَّته رضي الله عنها تأويلاً، فتأويل الأمر تنفيذه، وهذا هو فهم أمنا عائشة رضي الله عنها
فالتأويل معناه: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فإن كان في باب الأمر فالتأويل هو التنفيذ، وإن كانت في باب الخبر فالتأويل هو وقوع الخبر.
روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: ... وكان النبي عليه صلاة وسلام وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال الله
(وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (ال عمران 186)
وَقَالَ اللَّهُ: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة:109) وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ
2أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُنفِّذ الأمر بالعفو عن المشركين، فتأويل الأمر عند أسامة بن زيد رضي الله عنه هو تنفيذه.
ثم قال رضي الله عنه: حتى أذن الله فيهم فلما غزا رسول الله بدراً فقتل الله به صناديد كفار قريش، أي أنه لما جاءه الأمر بدأ يُنفِّذ، وقبل ذلك جاءه الأمر بالعفو فنفَّذه.
3.هناك آية هامة جداً ستساعدنا كثيراً في فهم قضية التأويل وهي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (المائدة:105) هل معنى ذلك أنني لو وجدت شخصاً يفعل منكراً لا أُغيِّره؟! هذه الآية قرئت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال كلاماً وقرئت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال كلاماً آخر، وقد تفهم من الكلام شبه تناقض، ولكن ليست المسألة متناقضة على الإطلاق.
روى أبو داود وصححه الألباني رحمهما الله تعالى أن أبا بكر قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: "يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها على غير مواضعها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (المائدة:105) وإنَّا سمعنا النبي عليه الصلاة وسلام يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وفي رواية: ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يُغيِّروا ثم لا يُغيِّرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب" فمعنى ذلك أن الإنسان إذا رأى منكراً عليه أن يُغيِّره، وهذا هو مراد أبي بكر رضي الله عنه ، ولكننا قد نفهم من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (المائدة:105) أن الإنسان عليه أن يكون في حاله، وإذا رأى ضلالاً أو منكراً لا يتدخل في ذلك، ولكن أبا بكر قال بأننا إذا رأينا المنكر ولم نغيره يوشك الله تعالى أن يعمنا بعقاب من عنده.
وهناك رواية رواها أبو داود - وإن كان فيها ضعف إلا في بعض المواطن التي سنشير إليها، فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال بأن هناك فقرات فيها ضعف يمكن أن تكون من الراوي نفسه، ولكننا نريد أن نرى فهم الصحابي لمعنى التأويل، فهذا هو ما يعنينا، وأما الحديث فلا نأخذ منه إلا ما صح- من حديث أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشنى فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول فى هذه الآية (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك - يعنى بنفسك - ودع عنك العوام" هذا القدر فيه ضعف، وأما القدر الصحيح فهو: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل
عمله" أي أنه ستأتي أيامُ فتنٍ لا يستطيع الإنسان أن يُغيِّر المنكر، ففي هذه الأيام يُقال (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)، وهذه الأيام اسمها أيام الصبر، والصبر فيه مثل قبضٍ على الجمر، فالقابض على دينه كالقابض على جمرة من نار، كما نرى في مثل هذه الأيام.
والذي يوضح هذه المسألة أكثر رواية موقوفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواها البيهقي في السنن، (وذكر هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفصَّله تفصيلاً دقيقاً)، قال أبو العالية رحمه الله تعالى: "كانوا عند عبد الله بن مسعود فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس فوثب كل واحد منهما إلى صاحبه "
أي أنه حدث بينهما خلاف، فتجاوزا في الحديث، وكان سيحدث بينهما شجار.
قال: " ........ فقال بعضهم - أي بعض الحاضرين مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر، فقال بعضهم: "عليك نفسك، إن الله تعالى قال: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)، فسمعها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ليس هذا بزمانها.
أي أن هذا الزمان ليس بزمان تأويل هذه الآية، فأنت في عصر أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فإذا رأيت منكراً عليك أن تُغيره ولا تسكت عليه، كما قال النبي r: " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب"، فتقول لمن يفعل المنكر: أنت على خطأ، فإن لم يَنته عليك أن تُبلغ ولي الأمر بما يحدث، فسيأتي معك ويغير هذا المنكر، فلا يجوز ساعتها أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هناك من سيقف معك ويُنفِّذ شرع الله سبحانه وتعالى.
ولكن إذا فُرض أنك ذهبت إلى المسؤولين وأخبرتهم بالمنكر الفلاني فقالوا لك: "لا يعنيك هذا الأمر"، فهم بذلك يتحملون هذه المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى.
فإذا رأيت سلوكاً منحرفاً لا تسكت عليه، وإذا رأيت أذىً في الطريق فعليك أن تنحيه، فأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس هذا بزمانها، قولوها ما قُبلت منكم، فإذا رُدَّت عليكم فقد جاء تأويلها .....
فعليكم بتغيير المنكر طالما أنه سيقبل منكم، وأما إذا لم تقبل منكم ورُدَّت عليكم فقد جاء تأويلها، أي أن هذا هو أوان وقوعها، فالتأويل عند عبد الله بن مسعود معناه: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه.
ثم قالرضي الله عنه: إن القرآن نزل حين نزل وكان منه آى مضى تأويله قبل أن ينزل .....
وهو ما أخبر الله من قصص السابقين كإغراق فرعون في اليم، فهذا أخبر الله تعالى عنه وقد مضى تأويله لأنه قد وقع.
قال رضي الله عنه: ..... وكان منه آى وقع تأويله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ......
وهذا كقول الله تعالى (الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) (الروم1 - 3)
(الروم:1 - 2)، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحدث ووقع فعلاً.
قال رضي الله عنه: ..... ومنه آيات وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ...
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"، وجاء بالفعل عصر الخلافة الراشدة.
فالتأويل هنا معناه: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه.
قال رضي الله عنه: ومنه آيات يقع تأويلهن في آخر الزمان .....
وهذه هي علامات الساعة الصغرى والكبرى.…
قال رضي الله عنه: ومنه آيات يقع تأويلهن يوم القيامة.
مثل الحساب والبعث.
قال رضي الله عنه: ما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فمروا وانهوا، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وأُلبستم شيعاً وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه، فعند ذلك جاء تأويلها.
أي جاء وقتها، ويكون تنفيذ الأمر في هذه الحالة.
نقول بأن من يفهم هذه القضية ويستوعبها جيداً فقد فتح الله تعالى عليه بأشياء كثيرة جداً.
أيقنَّا الآن أن التأويل عند الصحابة هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وأن تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه.
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فابن مسعود رضي الله عنه - قد ذكر في هذا الكلام تأويل الأمر وتأويل الخبر فهذه الآية (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) من باب الأمر وما ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبر وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به وتأويل الأمر هو فعل المأمور به فالآية التي مضى تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر: يقع الشيء فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له وهي وإن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها"
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وأما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه: الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا كان السلف يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول فيثبتون العلم بالاستواء وهو التأويل الذي بمعنى التفسير وهو معرفة المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل ويفقه ويقولون: الكيف مجهول وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو".
إذاً، علمنا الآن المعنى الذي ورد في القرآن عن التأويل، فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه، فإذا قلنا بأن العبادة هي تأويل الأمر فهذا كلام صحيح، وإذا قلنا بأن اتباع السنة وتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي تأويل الأمر فهذا كلام صحيح، لأن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
وأما تأويل توحيد الربوبية والأسماء والصفات فهو تصديقه، فإذا أخبر الله تعالى عن نفسه وعن اسمه ووصفه فعلينا التصديق.
إذاً، سترجع الأمور إلى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. (شرح اصول العقيدة الدكتور الشيخ محمود الرضواني)
ثاني معنى من معاني التأويل هو التفسير والبيان.
المعنى الثاني: التأويل بمعنى التفسير، وهو الكلام الذي يُفسَّر به اللفظ حتى يُفهم معناه، وهو المقصود في قول المفسرين "تأويل قوله تعالى"، وقد سمى ابن جرير تفسيره الكبير "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". ومنه قول الإمام أحمد في كتابه "الرد على الجهمية والزنادقة فيما تأولته من القرآن على غير تأويله".
فعلى المعنى الأول: يكون تأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته وأفعاله، هو نفس الحقيقة التي أخبر عنها، وذلك في حق الله تعالى - عن- ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، ولا سبيل لأحد إلى العلم به وإحاطته.
وعلى هذا المعنى ورد الوقف عند قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} آل عمران7.
وعلى المعنى الثاني: يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه بما له من الصفاته العلية، هو تفسير وفهم معنى ما وصف الله به نفسه من الصفات العظيمة الجليلة، وهذا يُعرف من اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها، وتعرَّف إلينا بواسطتها، مع العلم بأنه لا يشبهه شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.
وعلى هذا المعنى ورد الوقف عند قوله تعالى: {والراسخون في العلم} آل عمران7، كما هو مذهب كثير من السلف. (الأشاعرة في ميزان أهل السنة)
، وهذا التأويل يُحمد حقُّه ويُردُّ باطله، وهذا المعنى ورد في السنة ولم يرد في القرآن، والدليل على ذلك:
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عليه: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" فالتأويل هنا معناه التفسير والبيان وليس معناه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان ومنه قول ابن جرير وغيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره، ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله ....... "
فلا يقول قائل: الإمام أحمد بن حنبل يقول بالتأويل، فلماذا تعترضون علينا؟
نقول: هذا القائل لا يقصد بالتأويل لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، وإنما يقصد معنىً مستحدث سنتكلم عنه بعد قليل، وهو ليُّ النصوص بحجة التأويل، وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد بالتأويل هنا التفسير والبيان أو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وليس المعنى الذي يقصده هذا المتكلم
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: " ...... فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده، فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج "
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه :" أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله" أي أنه يعلم التفسير والبيان.
يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: "ولقد صدق رضي الله عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: " اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل " رواه البخاري وغيره، ودعاؤه r لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن لم يقل عن آية: إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله.
وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس. مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس "
إذاً، هناك معنى وهناك كيفية، فقوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه:5) لها معنى دلَّ على الكيفية الغيبية كشكل العرش وكيفية الاستواء، وهذه الكيفية مجهولة لنا، فكيفية الاستواء هي الحقيقة التي آل إليها قول الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)، فإذا سأل أحد عن معنى الاستواء يجوز لي أن أوضح له، فالمعنى هنا هو التفسير والبيان، ولذلك كل ما صحَّت ترجمته فهو من التفسير والبيان، وأما الكيفية فلا نستطيع ترجمتها لأننا لم نرها، فهذه من الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.
فالكيفية هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والمعنى من التفسير والبيان.
ولنضرب مثلاً آخر للتوضيح: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى) (محمد15)
فأنهار الماء التي في الجنة هل هي كأنهار الماء التي في الدنيا؟ لا، ولا يستطيع أحد أن يصف كيفية الماء الذي في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك في الجنة شجرة طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام، هل يستطيع أحد أن يصف كيفية هذه الشجرة؟
نقول: نحن نفهم معنى الشجرة، وأما شكل الشجرة وكيفيتها ولون ورقها فهذه كيفية غيبية، وهذه الكيفية الغيبية هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وأما شرح هذا الكلام وترجمته للغة الإنجليزية فهو من التفسير والبيان، لأن الحديث الذي فيه وصف الشجرة دلَّ على معانٍ باللغة العربية تُُفهم ونستطيع أن ننقلها إلى اللغة الإنجليزية، فتفسير المعنى هو من باب التفسير والبيان وهو المعنى الثاني للتأويل، وأما الحقيقة والكيفية فمن المعنى الأول.
(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه:5) - كلام له معنىً، وتفسير هذا المعنى هو التفسير والبيان، وأما كيفية الاستواء وشكل العرش فهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. (شرح اصول العقيدة الشيخ الدكتور محمود الرضواني)
المبحث الثاني معنى التأويل عند الخلف
الموجود في القرآن والذي استمر في عصر السلف الصالح هو واحد من المعنيين اللذين ذكرناهما للتأويل ، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام أو التفسير والبيان . ظهر معنىً جديد للتأويل لم يكن موجوداً قبل ذلك ، ولم يعرفه الصحابة ولا تكلموا عنه ، وهو صرف اللفظ من معنىً إلى آخر بدليل ، أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل ( 1 )
أو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل يقترن به. (2 )
او صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله بما لا يخالف نصا من كتاب الله سبحانه ولا سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.. او صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره بقرينة. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه ، وهو خلاف التأويل في اللغة، وفي كلام السلف.
قد يقال: إن بعض معاجم اللغة العربية تذكر أن معنى التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. أشار إلى ذلك ابن منظور وابن الأثير وغيرهما، فكيف تزعمون أن العرب لا تفقه من كلامها هذا المعنى.
والجواب: أن هذا المعنى دخل إلى معاجم اللغة العربية المتأخرة نقلاً عن استعمالات الفقهاء والأصوليين، لا نقلاً عن كلام العرب الذي يحتج به، يدل على صحة هذا القول أن معاجم اللغة العربية المتقدمة أمثال: تهذيب اللغة للأزهري، ومقاييس اللغة لابن فارس وهما مما دون في القرن الرابع الهجري لم يشيرا إلى هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء والأصوليون مما يدل على أنه معنى اصطلاحي خاص بهم، فلا يجوز حمل ألفاظ القرآن عليه.(3 )
وقد ظهر هذا المعنى للتأويل متأخراً عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، بل ظهر مع ظهور الفرق ودخلوا منه إلى تحريف النصوص، ولعب التأويل- أي المحدث- دوراً بارزاً في مفاهيم الناس، وكانت له نتائج خطيرة في حياتهم، خصوصاً تلك التأويلات المذمومة التي جرت على المسلمين محناً شتى بسبب سوء الفهم لكثير من القضايا الإسلامية، وكانت له آثاراً سيئة إذ فرق بين كلمة المسلمين وباعد بينهم وبين جوهر الشريعة وأساسها المتين.
ولقد تدرج أهل التأويل - أي المحدث - من سيئ إلى أسوأ في فهم المعاني التي يدعون معرفتها، وذلك لأنهم كلما توغلوا في تأويلٍ كلما بعدوا عن المعنى الصحيح الذي تهدف إليه النصوص.
أقسام التأويل المحدث
أولا التأويل الصحيح وهو صرف اللفظ من معنىً إلى آخر بدليل ، أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل لا يخالف نصا من كتاب الله سبحانه ولا سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
المقصود بالظاهر: المعنى اللغوي الظاهر الواضح من سياق الكلام
قال ابن قدامة في "روضة الناظر" : «الظاهر: وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، مع تجويز غيره، وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر"أي له معنيين احدهما راجح والاخر اقل منه اي معنى أعلى من معنى نسمي الراجح ( ظاهر) ونسمي المرجوح ( مؤول )
بعض الأمثلة التي توضح المقصود:
مثال 1 : "وأنا في أفريقيا شاهدت أسدًا وهو ينقض على فريسته."
هنا ظاهر الكلام أن الأسد الذي انقض على فريسته هو الحيوان المعروف.
مثال 2 : " كان خالد في ساحة القتال أسدًا."
ظاهره أن المقصود هو الشجاعة وليس الحيوان.
سؤال هل التأويل هو المجاز؟
يرتبط المجاز بالتأويل ارتباطا وثيقا حتى إنه قد يلتبس أحيانا تمييز كل منهما عن الآخر لوجود علاقة تربطهما ببعض
بل هناك من أرجع التأويل كله إلى المجاز كما قال الغزالي " ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز "
فالتأويل والمجاز يندرجان تحت صرف اللفظ عما وضع له ولعل الجاحظ هو اول من قال بالمجاز أي أن المجاز كان أولاً ثم ترتب عليه التأويل , فباب المجاز كان أسبق وأوسع ثم التأويل
"فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره ، لدليل دلَّ عليه أو لقرينة.
فإذا في التأويل عندنا ظاهر ، وهناك صرف للفظ عن ظاهره ،فعماد فهم التأويل على كلمة الظاهر.
كما أن المجاز عندهم هو: نقل اللفظ من وضعه الأول ، إلى وضعٍ ثانٍ لعلاقة بينهما.
ففهم المجاز ، الذي يقابله الحقيقة مبني على فهم الوضع الأول الوضع الثاني العلاقة ، والتأويل مبني على فهم الظاهر والقرينة.
فإذا في التأويل شيئان: ظاهر ، وقرينة ، مهم أن تعتني بهذين حتى تفهم المسألة.
وفي الحقيقة والمجاز ، هناك ثلاثة ألفاظ:
*1- وضع أول
* 2- وضع ثاني
* 3- وعلاقة
الظاهر في التأويل نوعان:
* الظاهر في الكلام نوعان:
* 1- ظاهر لفظ
* 2- ظاهر تركيب
ظاهر يظهر من لفظ واحد ، وظاهر يظهر من الكلام ، من الجملة.
ولهذا تعريف التأويل قالوا: نقل الكلام ، أو صرف اللفظ ، نقل الكلام من ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينة ، أو صرف اللفظ عن ظاهره.
فنقل الكلام ، أو صرف الكلام عن ظاهره هذا راجع إلى الظاهر التركيبي ، وصرف اللفظ عن ظاهره هذا راجع إلى اللفظ الإخراجي.(4)
مثلا يقول هذا كتابي، تفهم معنى الكتاب هو الذي في ذهنك منه، يقول مررت بفلان، تفهم معنى المرور حيث هو كلمة وفلان تتصوره، هذا استعمال للألفاظ وفهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ.
هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام؛ يعني يفهم الكلام بفهم أفراده، هذا نوع.
والثاني وهو مهم في هذا الباب أن المتكلم يُفهم كلامه بتركيب الكلام بسياق الكلام، وهذا هو الذي يسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية للكلام، هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب باب الأسماء والصفات؛ لأن من ادعوا التأويل وأن السلف أوّلوا في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا بما دلت عليه أفراده.
مثال ذلك قول الله جل وعلا ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾[الفرقان:45]، الظاهر الإفرادي للكلام (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ) أن الرؤية تكون لله؛ يعني يرى اللهَ جل وعلا يرى الرب جل وعلا (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ)؛ لكن لما قال (كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) علمنا بدلالة التركيب وهو ما يُفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله جل وعلا ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾[الفرقان:45].
كذلك قوله جل وعلا ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾[النحل:26]، (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) هل هذه من آيات الصفات فيها الإتيان؟ لا، ولم يحملها السلف على ذلك، وليست من آيات صفة الإتيان؛ لأن المقصود بالإتيان إذا أثبتت الصفة إتيان الذات وليس إتيان الصفات، هنا (أَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) نقول ليس هذا دليلا على صفة الإتيان لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله (أَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) ومعلوم أن المتقرر في أنه جل وعلا ليس كمثله شيء أن الله جل وعلا لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو جل وعلا أجلُّ من ذلك ومستوٍ على عرشه سبحانه، وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة في هذا الموضع وهي قدرته وبسطه وقوته وعقابه ونكاله بالكافرين لذلك قال(فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ).
أيضا من أمثلته –نطيل فيها لأجل أهمية ذلك- قوله جل وعلا في سورة البقرة﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾[البقرة:115]، هنا فسر السلف الوجه بالقبلة؛ لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، وجه بمعنى وِجهة، والوجه وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعروفة، هنا ما حُمل على الصفة مع أنها إضافة وجه الله، إضافة صفة إلى متصف، وذلك لدلالة السياق لدلالة التركيب، وهذا ظاهر لقوله (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) لسياق الآيات في القبلة (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) يعني القبلة؛ ولهذا خرجت هذه الآية من أن تكون من آيات الصفات.
كذلك قوله جل وعلا ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾[القلم:42]، (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟ وبعضهم قال من آيات الصفات وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات، لم؟ لتنازع هذا الموضع بين أن يُقصد الفرد فتكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات، يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة (سَاقٍ)، أو نفهمه مع سباقه ولحاقه فمن فهمه مع سباقه ولحاقه، العرب تقول كشفت الحرب عن ساقٍ إذا كشفت عن هول وشدة، وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) يعني عن ساق الرحمن جل وعلا فيما جاء في الحديث في الدلالة على ذلك.
المقصود هذا البحث مهم وطويل فروعه، تضبطه بأن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ، وقد يكون من جهة التركيب؛ لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام، لكننا نعلم ظاهر الكلام، هذا مقصود المتكلم نفهمه من جهة ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد، وقد يكون من جهة التركيب، ولهذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وتركيبي.
هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو معروف من جهة أصول الفقه في الركن الثالث من علم الأصول وهو دلالة الألفاظ أو الاستدلال.(5 )
إذن المجاز نقل اللفظ، أما التأويل صرف اللفظ، المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، مثل أنْ تقول فلان أسد، لا تريد به الحيوان المفترس، لكن تريد فلان أسد في الشجاعة، فَنَقَلَ اللفظ من معناه الأول إلى معنى جديد.
والتحقيق في هذه المسألة ولا يتسع المقام لتفصيل الكلام؛ أنّ لغة العرب لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة؛ فليس ثَم عندهم مجاز، والحقيقة عندهم تارة تكون إفرادية؛ حقيقة في اللفظ بمفرده، وتارة تكون تركيبية، وهي المفهومة من تركيب الكلام.
الحقيقة الإفرادية مثل الأسد هو الأسد؛ حيوان مفترس.
الحقيقة التركيبية هي التي ادعى فيها المدّعون المجاز، مثل أنْ يقال فلان أسد، قال كلمة أسد، هذه مجاز عن الرجل الشجاع لأنه لا يُعنى بها المعنى الأول.
فنقول العرب استعمالها لتركيب كلامها لا تنظر حين التركيب إلى الألفاظ، وإنما تنظر إلى دلالة الألفاظ حال التركيب، فالألفاظ تدل حال التركيب على معنى لا ينتقل معه الذهن من المعنى الأول إلى معنى جديد، مثلا نقول زيد أسد مباشرة ما دام قال زيد أسد لا يأتي للذهن الأسد الذي هو حيوان مفترس، ثم ينتقل منه إلى الرجل الشجاع لقرينة وجود زيد، وإنما مباشرة لما قال زيد أسد علِمَ أن المراد تشبيه زيد بالأسد في شجاعته، وهذه حقيقة تركيبية، وهي التي يدعي فيها المخالفون أنها مجاز
الحقيقة ما هي؟ هي إظهار الحقيقة بهذا الكلام، فصار الكلام حقيقة، لأنّه تظهر به حقيقة الأمر، فالكلام كله حقيقة، هذه الحقيقة تارة تكون إفرادية في اللفظ، وتارة تكون تركيبية في الكلام جميعا، وهنا مثّل بأمثلة يأتي الكلام عليها.
لكن هذه الحقيقة بمثل قوله تعالى ? وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا?[يوسف:82].
تعريف المجاز الذي عرفوه به: أنّ المجاز نَقْلُ اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان. وهذا يسمونه المجاز الناقص؛ لأنه حُذفت منه أهل القرية، أصل الكلام واسأل أهل القرية، نقول أنّ هذا الكلام مفهوم، ولا نقول أنّ ثَمّ مجاز؛ لأنّ المستمع لهذا الكلام يعلم أنّ القرية من حيث هي جدران وأبنية أنّه ليس المراد الجدران والأبنية، وإنما المراد أنْ يُسأل من يصح أن يُنسب إليه أنّه يسأل وهم أهل القرية، فقوله (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ) من الذي يصح أنْ يسأل؟ أهل القرية، فلهذا يكون الكلام بتركيبته يفيد حقيقة، هذه تسمى حقيقة تركيبية تُستفاد من تركيب الكلام، لكن لو أتى بمفردها وقيل القرية يُعنى بها أهل القرية لم تكن حقيقة إفرادية، ولكن لما استعملت بهذا التركيب صات حقيقة تركيبية، ومن مثل قوله )وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا([يوسف:82] يعني أهل العير، ونحو ذلك من أنواع كثيرة أُدُّعي أنها مجاز في القرآن.
بقي أنْ نقول أنّ الأصوليين اختلفوا في وجود المجاز في اللغة، فمنهم من قال بوجوده في اللغة وهم الكثرة الكاثرة، وهناك قلة أفراد من المحققين نفوا وجود المجاز في اللغة؛ قالوا كلام العرب كلُّه حقيقة.
هناك خلاف آخر أخصّ من هذا، وهو هل في القرآن مجاز أم لا؟ فنفاه كثيرون؛ نفاه كثيرون، وأثبته كثيرون، والخلاف في كون القرآن فيه مجاز أم لا، قد يكون عقديا وقد يكون أدبيا:
فيكون الخلاف في قول المجاز في القرآن عقديا إذا أُدُّعي أنّ آيات الصفات فيها مجاز، أو أنّ الآيات التي فيها العقائد -آيات الغيب التي فيها الخبر عن الغيب ونحو ذلك- أنّ فيها مجاز؛ إذا أدعي أن فيها مجاز صار الخلاف عقديا، لأنّ هذا مسلك المبتدعة .فإن أُدعي أنّ القرآن فيه مجاز في غير آيات الصفات صار خلافا أدبيا، فمثلا إذا قرأت في بعض التفاسير في بعض الآيات، قال هذه الآية فيها مجاز في مثل قوله تعالى ?وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ?[الإسراء:24] يقولون هذا فيه استعارة تمثيلية وهي من أنواع المجاز، (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ) ليس متعلقا بخبر غيبي ولا متعلق بعقيدة، فيكون الخلاف فيه أدبيا، نقول لا، الصواب أنه ليس هاهنا مجاز، ظاهر؟
وإذا قيل )الرَّحْمَن الرَّحِيم( أو)وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا( أنّ الرحمة مجاز عن إرادة الإحسان أو عن إيصال الإنعام صار خلافا عقديا، يُرَدُّ كما يُرَدُّ على أهل البدع.
بهذا تجد أنّ من أهل السنة من قد يقول في بعض الآيات فيها مجاز، لكن في غير آيات الصفات هذا يكون خلافا أدبيا، نقول الصواب فيه أنه لا مجاز في القرآن أصلا، والأصح أيضا أنّه لا مجاز في اللغة أصلا؛ لأنّ كلام العرب حقيقة قد تكون حقيقة إفرادية وقد تكون تركيبية ( 6)
هل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة يكون في استنباط الأحكام ام في الأمور الغيبة التي لا يدركها العقل ؟
أولا يجوز التأويل في الأحكام؛ لأن أدلة الأحكام فيها الناسخ والمنسوخ، فيجوز صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر بقرينة النسخ، وكذلك ألفاظ الأحكام فيها المطلق والمقيد وفيها العام والخاص، وفيها ما يسوغ الخروج من لفظ إلى لفظ آخر، سواءٌ أكان هذا المسوغ دليلاً آخر أم قرينة أخرى أم قاعدة شرعية كبرى أم ضرورة أم خصوصية أم نحو ذلك.(7 ) قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} إِيمَانَكُمْ لفظ كلمة لها معنى ولها حقيقة وحقائق الألفاظ لا تخرج عن ثلاثة حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية لفظ الإيمان في الشرع اي في معنى الشرع اي في الكتاب الله وسنة فعلى طول ناخد الحقيقة الشرعية ساعة ما تسمع لفظ ايمان لو اخدنا على حقيقة لغوية تكون التصديق ولو قلنا الشرعية يعني الايمان بالله وملائكته وكتبه.... دل المتبادر للادهان و لكن في هدا الموضوع لها معنى اخر غير المتبادر الى الادهان جبناه منين جبناه من القرينة معنى القرينة ايه يعني الدليل الشرعي والمعنى المراد من قوله{وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ ) يعني صلاتكم كيف عرفنا هدا ؟ هدا هو الإشكال ؟ لازم نضع ضابط لو لم نضع ضابط لقام كل انسان و صرف الالفاظ عن معناه كما يريد .. جاء في صحيح عن براء بن عزب وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينةصلى 16 شهر او17 شهر الى بيت المقدس وكان يعجبه ان يصلي اتجاه الكعبة فأنزل الله عزوجل قوله ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة: 144] فتجاه النبي الى الكعبة فقال بعض الصحابة فما بال اخوننا الذي كانوا يصلون اتجاه بيت المقدس وماتوا قبل تحول القبلة يعني هؤلاء الناس حكم صلاتهم ايه....فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} "يعني (إِيمَانَكُمْ ) معنه ايه ؟ معناه (صلاتكم) جبناه منيين بدليل شرعي من البخاري من حديث البراء بن عازب (8)
المثال الثاني
"قوله صلى الله عليه وسلم: (الجار أحق بصقبه) رواه البخاري، والصقب القرب والملاصقة والمراد به الشفعة فهذا الحديث ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضا مع احتمال أن المراد بالجار الشريك المخالط، لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر فلما نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه البخاري، صار هذا الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجحا على ظاهره فقدمناهما وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم وحملنا عليه الجار في الحديث الأول وهو حمل سائغ في اللغة.(9)
شروط التأويل الصحيح:
1أن يكون المُؤَوِل من أصحاب الملكات الاجتهادية.
2- أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا فلا يكون نصا.
3-أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يؤول إليه، وأن يكون احتمال اللفظ له على أساس من وضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو مما عرف من استعمال القواعد الشرعية كنحو تخصيص عام أو تقييد مطلق.
4- أن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده. – من الكتاب او السنة 5- ألا يعارض التأويل نصوصا صريحة قطعية الدلالة في التشريع .(10)
فإذا انتفى ضابط أو سقط شرط من الشروط فلا يجوز التأويل أي لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره
ثانيا
هل يجوز صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة في الامور الغيبية؟
التأويل هو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، وهذا الصرف لا يتأتى في أمر العقيدة؛ لأن العقيدة غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ومن هنا فلا يتأتى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعي القدرة على أن يعطي لألفاظ الغيب معاني أخرى لم يسبق إليها.
ينبغي التنبيه على أمر من الأمور التي اختلطت على كثير من الناس خاصة في هذا العصر، وهي دعوى أن التأويل قد يدخل في العقيدة بأي وجه من الوجوه، وهذه دعوى باطلة بإطلاق جزماً؛ لأن العقيدة لا يمكن أن يرد فيها التأويل بأي معنىً من معاني التأويل عند من عرف التأويل من الأصوليين، والذين قالوا: التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة أو لدليل، تعريفهم هذا -مع سلامته عند الأصوليين- لا يمكن أن يسلم به في أمور العقيدة بإطلاق أبداً؛ لأن التأويل هو صرف اللفظ عن معنىً إلى معنى آخر، وعن لفظ إلى لفظ آخر، واللفظ المغاير يقتضي المعنى المغاير، وهذا الصرف لا يتأتى في أمر العقيدة؛ لأن العقيدة غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن هنا لا يتأتى بأي حال من الأحوال أن يدعي بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه باستطاعته أن يعطي معنى آخر لألفاظ الغيب، ومنها ألفاظ العقيدة، فألفاظ العقيدة استقرت على ما هي عليه، فعلى هذا يجب أن نقف على ألفاظها، ومعاني الألفاظ هي التي تفهم بما يمكن أن يفهمه البشر، وما لا يفهم يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الكيفيات، فمن هنا لا يتأتى التأويل في العقيدة أبداً، وما يرد من النصوص التي تشبه التأويل في العقيدة فإنما هو تفسير نص بنص، لا دخول للعقل فيه ولا لاجتهاد البشر، ولا يمكن لبشر أن يصرف لفظاً من ألفاظ العقيدة عن معنى راجح إلى معنى مرجوح؛ لأن الانتقال من معنى إلى معنى آخر يخرج المعنى الأول من اليقين إلى الشك، ثم يكون المعنيان كلاهما مشكوكاً فيهما ومظنوناً، وهذا لا يتأتى في العقيدة، بل ما كان كذلك لا يكون عقيدة، فلذلك اضطربت عقيدة المؤولة، كل من أول في العقيدة بأي نوع من أنواع التأويل فإن عقيدته مضطربة فيما أول فيه؛ لأنه خرج من المعنى الذي يريده الله إلى معنى آخر ليس عنده عليه برهان ولا دليل، والعقيدة غيب، ولو لم تكن غيباً ما صارت عقيدة، فأي أمر ينتقل من الغيب إلى عالم الشهادة لا يصبح من عالم الغيب ولا يكون عقيدة.
إذاً: فالتأويل في العقيدة لا يرد، إنما يرد التأويل في الأحكام؛ لأن أدلة الأحكام فيها الناسخ والمنسوخ، فيجوز صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر بقرينة النسخ، وكذلك ألفاظ الأحكام فيها المطلق والمقيد وفيها العام والخاص، وفيها ما يسوغ الخروج من لفظ إلى لفظ آخر، سواءٌ أكان هذا المسوغ دليلاً آخر أم قرينة أخرى أم قاعدة شرعية كبرى أم ضرورة أم خصوصية أم نحو ذلك.
أما العقيدة فلا يمكن أن يرد فيها تأويل، ولا نعرف أحداً من السلف وأئمة الدين قديماً وحديثاً ادعى أن في العقيدة تأويلاً، إذاً: فينبغي أن يفهم هذا (11)
" سلك أهل السنة والجماعة في جميع صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة مسلكاً واحداً وهو إثباتها وإمرارها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه، لا يفرقون في ذلك بين صفة وأخرى. فلا فرق عندهم بين الصفات الذاتية والفعلية، ولا بين العقلية والخبرية، ولا بين صفات المعاني وغيرها. ونصوصهم في هذا كثيرة جداً يصعب حصرها.
قال تعالى {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} الشورى11، وهذه آية جامعة عامة في أن الله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. وقال تعالى {هل تعلم له سمياً} مريم65. وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاطب أصحابه جميعهم: المتعلم منهم والجاهل، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويذكر صفات ربه، لا يفرق بين صفة وصفة، ولم يقل في بعضها: الظاهر غير مراد، أو لا تفهموا منها الحقيقة، ونحو ذلك. ولم يكن يقرن عند ذكر بعض صفاته ما يدل على كونها مجازاً، فكان يذكر صفة النزول مثلاً، ويكررها في مواضع كثيرة، ولا يقرن بالكلام ما يدل على أن المراد خلاف ظاهرها.
إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كمايقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله - كما زعموا - لبينه الله ورسولهولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال.
"فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه -وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة- فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي؛ فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟! فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه؛ قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى، وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدهما: ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيئول الأمر إلى الحيرة.
المحذور الثاني: أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول؛ إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية ( 12)
من أشهر النصوص الواردة عن السلف قولهم عن نصوص الصفات: (أمروها كما جاءت)،
وقولهم (أمروها كما جاءت) يقتضى إبقاء دلالتها على ما دل عليه ظاهرها، فإنها جاءت ألفاظاً دالةً على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال (أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد) أو (أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة) وحينئذ فلا تكون قد أُمِرَّت كما جاءت.
قال القاضي أبو يعلى: (لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين)( 13)
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (150 هـ)
قال: (لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم، ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه) ـ.
- الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (164 هـ)
قال في بيان معتقد السلف في أسماء الله وصفاته، فذكر بعض ما ورد منها في الكتاب والسنة ثم قال: (وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض"، وقال لثابت بن قيس: "لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة"، وقال فيما بلغنا: "أن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم، فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيراً" - الإمام سلام بن أبي مطيع أبو سعيد الخزاعي (164 هـ)
قال هدبة: قال سلام بن أبي مطيع: (متى ينكرون من هذه الأحاديث شيئاً، فإنهم لا ينكرون شيئاً إلا في القرآن أبين منه، إنه {سميع بصير} الأعراف200، وإنه {السميع العليم} الأنعام13، {فلما تجلى ربه للجبل} الأعراف143، {وكلم الله موسى تكليما} النساء164،، وقال {لما خلقت بيدي} ص75،، فما زال يقول حتى غربت الشمس)
- الإمام إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلى (236 هـ)
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبا معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي يقول: (من زعم إن الله لا يتكلم، ولا يسمع، ولا يبصر، ولا يغضب، ولا يرضى، وذكر الأشياء من هذه الصفات، فهو كافر بالله بهذا ندين الله عز وجل)
- مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري المدني (236 هـ)
قال: (إن الله يتكلم بغير مخلوق، وإنه يسمع بغير ما يبصر، ويبصر بغير ما يسمع، ويتكلم بغير ما يسمع، وإن كل اسم من هذه يقع في موضع لا يقع غيره، ولست أقول إن كلام الله وحده غير مخلوق. أنا أقول أفعال الله كلها غير مخلوقة، وإن وجه الله غير يديه، وإن يديه غير وجهه. فإن قالوا: كيف؟ قلنا: لا ندري كيف هو؟ غير أن الله عز وجل أخبرنا أن له وجهاً ويدين ونفساً، وأنه سميع بصير. وكل اسم من هذه يقع في موضع لا يقع عليه الاسم الآخر. الإمام العلامة الحافظ الناقد عثمان بن سعيد الدارمي (280 هـ)
قال: (أخبرنا الله في كتابه أنه ذو سمع، وبصر، ويدين، ووجه، ونفس، وعلم، وكلام، وأنه فوق عرشه فوق سماواته، فآمنا بجميع ما وصف به نفسه كما وصفه بلا كيف)
- الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ)
قال: (ولله تعالى ذكره أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - أمته .. ) إلى أن قال: (وذلك نحو إخبار الله تعالىذكره إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين لقوله تعالى {بل يداه مبسوطتان} المائدة64، وأن له يميناً لقوله: {والسماوات مطويات بيمينه} الزمر67، وأن له وجهاً لقوله: {كل شيء هالك إلا وجهه} القصص88، وقوله: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} الرحمن27. وأن له قدماً لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى يضع الرب قدمه فيها" يعني جهنم. وأنه يضحك إلى عبده المؤمن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي قُتل في سبيل الله: "إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه". وانه يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا، لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأنه ليس بأعور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ ذكر الدجال فقال: "إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور".وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، كما يرون الشمس ليس دونها غياية، وكما يرون القمر ليلة البدر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.وأن له أصابع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن".فإن هذه المعاني التي وصفت، ونظائرها مما وصف الله عز وجل بها نفسه، أو وصفه بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لا تُدرك حقيقة علمه بالفكر والروية)( 14)
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (449 هـ)
قال: (وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع، والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعزة، والعظمة، والإرادة، والمشيئة، والقول، والكلام، والرضا، والسخط، والحياة، واليقظة، والفرح، والضحك، وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى، وقاله رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه، ولا تكييف له ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله )(15)
وقال في وصيته أنه "يسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات البارئ –جل جلاله-، والأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بابها، كآيات مجيء الرب يوم القيامة، وإتيان الله في ظُلل من الغمام، وخلق آدم بيده، واستوائه على عرشه، وكأخبار نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والضحك والنجوى، ووضع الكنيف على من يُناجيه يوم القيامة، وغيرها، مسلك السلف الصالح، وأئمة الدين، من قوبها وروايتها على وجهها، بعد صحة سندها، وإيرادِها على ظاهرها، والتصديق بها والتسليم لها، واتقاء اعتقاد التكييف، والتشبيه فيها، واجتناب ما يؤدي إلى القول بردّها، وترك قبولها، أو تحريفها بتأويل يُستنكر، ولم ينزل الله به سلطانا، ولم يجر به للصحابة والتابعين والسلف الصالح لسان".( 16)
قال الإمام الحافظ أبو القاسم اسماعيل بن محمد التيمي الطلحي الأصبهاني(535 هـ):
(مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأحمد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه: أن صفات الله التي وصف بها نفسه، ووصفه بها رسوله من السمع، والبصر، والوجه، واليدين، وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور، من غير كيف يتوهم فيها، ولا تشبيه ولا تأويل، قال ابن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره) ثم قال: (أي هو هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل)
وقال: (أن الله عز وجل سميع بصير، عليم خبير، يتكلم، ويرضى، ويسخط، ويضحك، ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول: هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر، ويرون الرب عز وجل يوم القيامة عياناً لا يشكون في رؤيته، ولا يختلفون ولا يمارون كذلك)
قال ابن عيينة: «كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل )
قال السجزي: (مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأحمد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه: أن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع، والبصر، والوجه، واليدين، وسائر أوصافه: إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور، من غير كيف يتوهم فيها، ولا تشبيه ولا تأويل)
وقال الذهبي: (وهذا الذي علمت من مذهب السلف، والمراد بظاهرها أي: لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع، والبصر، والعلم، والكلام، والإرادة، والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء معلومة فلا نحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا والله أعلم)
قال الأزهري صاحب اللغة: (فهو سميع: ذو سمع بلا تكييف، ولا تشبيه بالسميع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه، ونحن نصفه بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف ( 17)
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت. 795 هـ) «وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية، لأن جهْمّا وأصحابه أولُ من اشتهر عنهم أن الله تعالى مُنزّهٌ عما دلّت عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سموّها "أدلة قطعية" وهي المحكمات، وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات، فعرضوا ما فيها على تلك الخيالات، فقبلوا ما دلّت على ثبوته بزعمهم، وردّوا ما دلّت على نفيه بزعمهم، ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وزعموا أنّ ظاهر ما يدلّ عليه الكتاب والسنة تشبيه وتجسيم وضلال، واشتقّوا من ذلك -لمن آمن بما أنزل الله على رسوله- أسماء ما أنزلَ اللهُ بها من سلطان؛ بل هي افتراءٌ على الله، يُنفّرون بها عن الإيمان بالله ورسوله. وزعموا أنّ ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره - من باب التوسع والتجوز، وأنه يُحمل على مجازات اللغة المستبعدة، وهذا من أعظم أبواب القدحِ في الشريعة المحكمةِ المُطهّرةِ، وهو من جِنس حَمْل الباطنية نصوصَ الإخبار عن الغُيوبِ؛ كالمعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة، وحملِهم نصوص الامر والنهي عن مثل ذلك، وهذا كله مروق عن دين الإسلام (18)
وَذُكِرَ فِي التَّبْصِرَةِ أَنَّ نُصَيْرَ بْنَ يحيى البلخي روى عن عمرو بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُؤَدِّي ظَاهِرُهُ إِلَى التَّشْبِيهِ؟ فَقَالَ: نُمِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ، وَنُؤْمِنُ بِهَا، وَلَا نَقُولُ: كَيْفَ وَكَيْفَ )( 19)
التأويل الفاسد أو التأويل البعيد
وهو صرف اللفظ من معناه الظاهري الى معنى اخر لدليل يظنه صارف وهو في الحقيقة ليست بصارف
وينقسم التحريف عند المبتدعة إلى ثلاثة أقسام
1 تحريف اللفظ - 2 تحريف المعنى - 3 تحريف الأدلة (20)
النوع الأول: تحريف اللفظ:
وتعريفه: هو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرها، وله أربع صور:
1- الزيادة في اللفظ.
2- النقصان في اللفظ.
3- تغيير حركة إعرابية.
4- تغيير حركة غير إعرابية.
ومن أمثلة تحريف اللفظ:
المثال الأول: تحريف إعراب قوله تعالى: وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا [النساء: 164] من الرفع إلى النصب، وقال: وَكَلَّمَ الله أي موسى كلم الله، ولم يكلمه الله، ولما حرفها بعض الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد: فكيف تصنع بقوله: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ [الأعراف: 143] فبهت المحرف.
مثال آخر: إن بعض المعطلة سأل بعض أئمة العربية: هل يمكن أن يقرأ العرش بالرفع في قوله: الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى [طه: 5] وقصد بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق ( 21)
النوع الثاني: تحريف المعنى:
وتعريفه: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ . أو نقول: تعريفه: هو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما.
وهذا النوع هو الذي جال فيه أهل الكلام من المعطلة وصالوا, وتوسعوا وسموه تأويلاً، وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة .(22)
ومن أمثلة تحريف المعنى:
كقول المعطلة في معنى استوى: استولى في قوله: الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى [طه: 5].
وفي معنى اليد في قوله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة: 64] النعمة والقدرة.
وفي معنى المجيء في قوله تعالى: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر: 22] وجاء أمر ربك.
وقد ذكر الله التحريف وذمه حيث ذكره، وهو مأخوذ في الأصل عن اليهود، فهم الراسخون فيه، وهم شيوخ المحرفين وسلفهم، فإنهم حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة, وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه؛ ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم.
وقد درج على آثارهم الرافضة؛ فهم أشبه بهم من القذة بالقذة، وكذلك الجهمية؛ فإنهم سلكوا في تحريف النصوص مسالك إخوانهم في اليهود (23)
النوع الثالث:
تحريف الأدلة عن مواضعها هذا النوع من التحريف من الأنواع الخفية جدًا
تحريف الأدلة
تحريف الأدلة عن موضعها
العباد تنقسم إلى ثلاثة أقسام 1 عبادة نص عليها المشرع جملة وتفصلا
2عبادة ليس منصوص عليها جملة و لا تفصيلا
3عباد نص عليها جملة وليس عليها تفصيل
وقد يقع فيه كثير ممن يرد الخير وهو قليل البضاعة في العلم والفهم كما أنه مدخل واسع لكثير من البدع، نسأل الله السلامة. وهذه الطريقة من طرق التلبيس هي ثمرة من ثمرات الطريقتين السابقتين، إذ لابد لمحرف الأدلة من كتمان الحق، ولابد لمتبع المتشابه من تأويل كلام الله - سبحانه - وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - من التأويل الفاسد الذي يؤدي إلى صرف الأدلة عن ما أراد الله بها وأراده رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن ثم وضعها في غير موضعها، وهذا هو نوع من أنواع التحريف للأدلة عن مواضعها، إذ لا يلزم من التحريف أن يكون لفظياً كما فعلت اليهود في التوراة بل إن تحريف المعنى المراد إلى غير المراد هو تحريف للنصوص عن مواضعها أيضاً وهذا ما أشار إليه الشاطبي - رحمه الله تعالى -: وهو يستعرض مآخذ أهل البدع في الاستدلال: ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهماً أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله، ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام وبأنه يذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحاً، إلا مع اشتباه يعرض له، أو جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعاً وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلاً فأتى به المكلف في الجملة أيضاً، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضداً لعلمه من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح به. فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنٍ لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار متخيلاً أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعاً من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه
• بعض الفوائد من هدا البحث
1- ان التأويل له معنيين الحقيقة التي يؤول إليها الكلام أو التفسير والبيان .
إما المعنى الثالث فهو محدث
2- التأويل المحدث وهو صرف اللفظ من معنى الى معنى اخر لقرينة يجوز العمل به في استنباط الأحكام وبضوابط ادا انتفي ضابط فلا يجوز العمل بهذا التأويل
أما في الصفات الغيبية فلا يجوز العمل بهذا التأويل المحدث لان الصفات الغيبية لايعلمها الا الله فالمعنى معلوم والكيفية مجهولة
3 – ان السلف اجمعوا على إمرار الصفات على ظاهرها كما جاءت بدون إدخال العقل وصرفها عن ظاهرها لان هدا القول على الله بدون علم
والحمد لله رب العالمين
المراجع
1- شرح اصول العقيدة الشيخ الدكتور محمود الرضواني
2- معجم علوم القرآن
3- التأويل خطورته وآثاره عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر
4- الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية الشيخ صالح آل الشيخ
5- الشيخ في تعليقه على كلام شيخ الإسلام في الحموية
6- شرح الورقات للشيخ صالح ال الشيخ
7- شرح الطحاوية ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
8- منهاج التلقي والاستدلال الشيخ عادل الشوربجي
9- "شرح مختصر الروضة" (1/ 562)، و "المدخل" لابن بدران (1/ 188).
10 المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول أبو المنذر محمود بن محمد المنياوي
11 -12 شرح الطحاوية ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
13-14 الأشاعرة في ميزان أهل السنة أبو عثمان فيصل بن قزار الجاسم
15 عقيدة السلف واصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل الصابوني (ص39)
16 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (ج4 ص288)
17 أشاعرة في ميزان أهل السنة أبو عثمان فيصل بن قزار الجاسم)
18 (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي (ج7 ص230-231)
19 شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي - ط الأوقاف السعودية (ص: 185)
20 منهاج التلقي والاستدلال الشيخ عادل الشوربجي
21 الصوعق المرسلة 218/1
22 .مختصر الصوعق المرسلة147/2
23- الصوعق المرسلة215-216/1


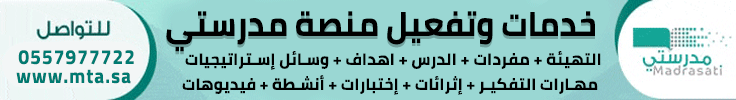






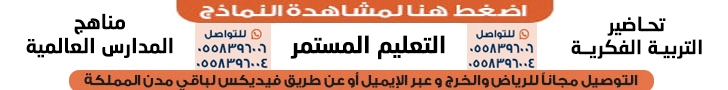

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
