أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين:
اعتنى به: عمرو الشرقاوي
[1/ 84 - 85]
قال الطبريتعالى: ((ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قُدَمَاءِ الْمُفَسِّرِينَ مَحْمُودًا عِلْمُهُ بِالتَّفْسِيرِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَذْمُومًا عِلْمُهُ بِذَلِكَ.
وساق بإسناده عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «نَعَمْ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ».
عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ»، وَبإسناده عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: بِنَحْوِهِ.
وبإسناده عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: " رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمَعَهُ الْوَاحِدُ فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:: اكْتُبْ , قَالَ: حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ التَّفْسِيرِ، كُلِّهِ ".
وبإسناده عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ، مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، أَوْقَفْتُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ، وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا».
وبإسناده عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، فَحَسْبُكَ بِهِ».)).
التعليق:
ذكر الإمام الطبري في هذا الفصل، ما يمكن أن يقوم تقويمًا للمفسرين، وهو نوع من الجرح والتعديل .
ومن المعلوم أن الطبريلم يقصد الاستيعاب فيما ذكر - فيمن مدح أو ذم قوله في التفسير -، وإنما ذكر بعض ما عنده من الروايات في هؤلاء .
وهناك رابط بين هذا الفصل، والفصلين قبله، وهما: ((ذِكْرُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي الْحَضِّ عَلَى الْعِلْمِ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَانَ يُفَسِّرْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ))([1])، و ((ذِكْرُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ الَّتِي غَلَطَ فِي تَأْوِيلِهَا مُنْكِرُو الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ))([2]) .
وهذا الرابط يتمثل في كون علم التفسير من العلوم التي حض الصحابة على تعلمه، بل وكانوا يقومون بتدريس هذا العلم الشريف، ولم يرد أن أحدًا منهم توقف توقفًا كليًا في تفسير القرآن، ولم يظهر التوقف إلا في بعض التابعين من علماء المدينة والكوفة .
ثم ذكر الرد على من زعم أنه لا يجوز القول في التفسير، وكأن هذا الفصل معترض بين الفصلين، والذي جعله يجعله معترضًا، ما ذكره في آخر الفصل الأول بقوله: ((وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ، فَسَدَ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَ تَفْسِيرَ الْمُفَسِّرِينَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَتَنْزِيلِهِ، مَا لَمْ يَحْجُبْ عَنْ خَلْقِهِ تَأْوِيلَهُ))، ثم كأنه استطرد في ذكر بعض الأخبار عن هؤلاء في الإنكار على تفسير القرآن، ففهمها البعض غلطًا على أن المراد منها عدم جواز تفسير القرآن، وبين الصواب فيها، فذكر الْأَخْبَارَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قُدَمَاءِ الْمُفَسِّرِينَ مَحْمُودًا عِلْمُهُ بِالتَّفْسِيرِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَذْمُومًا عِلْمُهُ بِذَلِكَ.
وجل الأخبار التي ذكرها الطبريفيما أوردناه عن ابن عباس، فأورد الطبري قول ابن مسعود: «نَعَمْ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ».
الترجمان هو من ينقل الكلام من لغة لأخرى، والتفسير في حقيقته قريب من الترجمة، فهو: نقل لكلام الله من لفظ عربي معين إلى لفظ عربي آخر .
وهذه صورة من صور الترجمة، لكنها من نفس اللغة .
وينبغي أن ننتبه إلى أن التفسير بأي لغة، فإننا نسميه "ترجمة" اصطلاحًا، إذ هو نقل للمعاني، ولا يمكن بحال أن يوجد ما يسمى بالترجمة الحرفية.
من اللطائف في هذا القول المروي عن ابن مسعود، أنه توفي عام (32) على خلاف في وفاته، أي: في نهاية خلافة عثمان، وقد قال ذلك وابن عباس في هذا السن شاب([3])، ولا نعرف على الحقيقة متى قال هذا القول، فلو افترضنا أنه قاله في آخر حياته، فهذا يدل على شريف علم ابن عباس حيث مدحه أحد كبار الصحابة، واحد أعلم الأمة بالقرآن .
وقوله: ((عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: " رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمَعَهُ الْوَاحِدُ فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:: اكْتُبْ , قَالَ: حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ التَّفْسِيرِ، كُلِّهِ".)).
فيه فوائد كثيرة، منها:
1. أن علم التفسير كان علمًا قائمًا بذاته في عهد الصحابة، لأن مجاهد ذهب إلى ابن عباس ليسأله عن التفسير خاصة، فدل على أنه علم قائم بذاته.
وسبب التنبيه على هذا، أن بعض من كتب في تاريخ التفسير خلط في هذا، واتبعه كثير على هذا الأمر، وذكر أن علم التفسير لم يكن علمًا قائمًا بذاته إلا في القرن الثالث، وهذا لا شك في خطأه([4]) .
2. أن تدوين التفسير كان في عصر صغار الصحابة، وهذه النسخة التي كان يكتبها مجاهد من أكبر الأدلة على أن بدايات علم التفسير كانت متقدمة جدًا، ومن المعلوم أن التدوين التنظيمي للسنة بدأ مع عمر بن عبدالعزيز على رأس المائة، وهذه النسخة التي كتبها مجاهد كان قبل ذلك بفترة طويلة، وهي قضية مهمة في تاريخ علم التفسير .
3. رضى ابن عباس بكتابة التفسير عنه، وقد ورد عنهأنه لما عمي نهى عن كتابة العلم عنه ([5]).
4. وقوله: ((حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ التَّفْسِيرِ، كُلِّهِ))، يدل على عدم توقف ابن عباسعن التفسير، فإن قيل: إنه توقف عن بعض الآيات، قلنا: توقف ثم علمها وفسرها .
ويؤكد هذه المعلومة مجاهد في قوله: «عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ، مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، أَوْقَفْتُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ، وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا».
وكل هذا يدلنا على تقدم العناية بعلم التفسير .
وأما قول سفيان الثوري: «إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، فَحَسْبُكَ بِهِ»، فهذا داخل في تعديل تفسير مجاهد.
[1/85]
قال الطبري: ((وبإسناده عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: «لَمْ يَلْقَ الضَّحَّاكُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا لَقِيَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالرِّيِّ، وَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ».
وبإسناده عن عَنْ مُشَاشٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلضَّحَاكِ: " سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا ")).
التعليق:
هذا نقد لرواية الضحاك عن ابن عباس، وعندنا صحيفة عن الضحاك عن ابن عباس، وقد ثبت عندنا أن الضحاك لم يلق ابن عباس، وإن كان في فترة تمكنه من لقاء ابن عباس، لأنه في طبقة مجاهد، حيث توفي سنة (105ه).
والرواية الأولى تفيد أن سعيد بن جبير لما ذهب إلى الري أخذ عنه الضحاك التفسير، فإذا جاءنا التفسير عن الضحاك عن ابن عباس، ففيها احتمال أن تكون منقولة عن سعيد بن جبير .
وفي سؤال الضحاك عن لقيا ابن عباس وإجابته بالنفي، دليل أن هناك انقطاع في الرواية بين الضحاك وابن عباس .
وهنا لا بد أن ننظر إلى تعامل أهل النقد من علماء التفسير مع رواية الضحاك عن ابن عباس([6])، وهي كافية لإبراز المنهج في التعامل مع أسانيد التفسير .
[1/86]
قال الطبري: ((وبإسناده زَكَرِيَّا، قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَمُرُّ بِأَبِي صَالِحٍ بَاذَانَ، فَيَأْخُذُ بِأُذُنِهِ فَيَعْرُكُهَا، وَيَقُولُ: «تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ»)).
التعليق:
أبو صالح باذام كان بمكة، وكان من تلاميذ ابن عباس، ثم نفي إلى الكوفة، فالذي يظهر أن هذه الرواية كانت في الكوفة .
والشعبيكان من أصحاب الورع في التفسير والتوقي فيه، فكان يتكلم في بعض من يفسر القرآن برأيه كأبي صالح، والسدي .
ومقصوده بالقراءة (الحفظ)، وهذا يفيدنا أن من شروط المفسر عند الشعبي حفظ القرآن، وهو نوع من الجرح عنده .
[1/86]
قال الطبري: ((وبإسناده عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ
[غافر: 20] ، قَالَ: «قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْزِيَ بِالْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ، وَبِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» قَالَ الْحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: حَدَّثَنِي بِهِ الْكَلْبِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ أَنْ يَجْزِيَ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَبِالْحَسَنَةِ عَشْرًا» فَقَالَ الْأَعْمَشُ: لَوْ أَنَّ الَّذِيَ عِنْدَ الْكَلْبِيِّ عِنْدِي، مَا خَرَجَ مِنِّي بِحَقِيرٍ([7]))).
التعليق:
الحسين بن واقد من علماء القرآن، ويروي عن الأعمش، وقوله: حدثني به الكلبي، فهو يروي عن الكلبي أيضًا.
وكلام الشعبي نوع نقد وجرح لتفسير الكلبي .
وهذا الأثر من الشعبي محل إشكال عندي فهل مراده المدح، أم لا ؟
وقد استشكلها محمود شاكر([8])، وهي في الحقيقة مشكلة .
[1/87]
قال الطبري: ((وبإسناده عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: مَرَّ الشَّعْبِيُّ عَلَى السُّدِّيِّ وَهُوَ يُفَسِّرُ، فَقَالَ: «لَأَنْ يُضْرَبَ عَلَى اسْتِكَ بِالطَّبْلِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ مَجْلِسِكَ هَذَا».
وبإسناده عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، فَرَأَى السُّدِّيَّ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ يُفَسِّرُ تَفْسِيرَ الْقَوْمِ».)).
التعليق:
هذا الكلام عن السدي من الشعبي وإبراهيم النخعي، وهما من الأقران، والشعبي يعتمد على النقل والأثر أكثر من إبراهيم النخعي .
ولم يلقيا ابن مسعود، وإنما أخذا عن تلاميذه، وهو ممن كان يعلم طلابه الاتباع، ويحذرهم من الابتداع، وهذا جعل الرأي قليلًا في تلاميذه.
وهذا بخلاف تلاميذ ابن عباس .
وفي هذين الأثرين نلاحظ أن الشعبي انتقد السدي، بخلاف النخعي.
وقول الشعبي: «لَأَنْ يُضْرَبَ عَلَى اسْتِكَ بِالطَّبْلِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ مَجْلِسِكَ هَذَا»، والاست تطلق على المقعدة أو العجيزة، وهي داخلة في مقام الجرح أو النقد .
[1/87]
قال الطبري: ((بإسناده عن سَعِيد بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «مَا أَرَى أَحَدًا يَجْرِي مَعَ الْكَلْبِيِّ فِي التَّفْسِيرِ فِي عِنَانٍ»)).
التعليق:
هذا فيه نوع من الإشارة إلى ما عند الكلبي من علم بالتفسير .
وننتبه إلى أن الكلبي متهم بالتشيع، والكذب، والكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس هي سلسلة الكذب عن ابن عباس .
لكن المحققين من علماء التفسير ممن لهم بصر بالحديث لا يعتمدون على هذه الرواية مفردة، بل يعتمدون عليها مقرونة، وهذه قاعدة مهمة .
وأيضًا، فإن قول الكلبي مختلف عن روايته .
وهذه الآثار التي أوردها الطبريفي بعضها تعديل لبعض الرجال وفي بعضها تقويم وجرح.
ومن الغريب في تفسير الطبري إعراضه التام عن مقاتل، مع أنه في نفس هذه الطبقة التي أوردها، وقد نقل الطبري عن الكلبي، ومقاتل قد مدحه أعلام وذمه اعلام، بل قال الشافعي: ((الناس عيال على ثلاثة، وذكر مقاتل في التفسير)) .
وحاله مقارب للكلبي، والكلبي قد أشار إليه الطبري، ونقل عنه في التفسير قرابة (50) موضعًا، وأما مقاتل فلم يشر إليه، وهذا محل غرابة عندي .
[1/87 - 89]
قال الطبري: ((قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ قُلْنَا فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي وُجُوهِ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ تَأْوِيلَ جَمِيعِ الْقُرْآنِ عَلَى أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ:
أَحَدُهَا: لَا سَبِيلَ إِلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ، وَحَجَبَ عِلْمَهُ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَهُوَ أَوْقَاتُ مَا كَانَ مِنْ آجَالِ الْأُمُورِ الْحَادِثَةِ، الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهَا كَائِنَةٌ، مِثْلُ وَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَوَقْتِ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَوَقْتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالنَّفْخِ فِي الصُّورِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ([9]).
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: مَا خَصَّ اللَّهُ بِعِلْمِ تَأْوِيلِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دُونَ سَائِرِ أُمَّتِهِ، وَهُوَ مَا فِيهِ مِمَّا بِعِبَادِهِ إِلَى عِلْمِ تَأْوِيلِهِ الْحَاجَةُ، فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى عِلْمِ ذَلِكَ، إِلَّا بِبَيَانِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ تَأْوِيلَهُ([10]).
وَالثَّالِثُ مِنْهَا: مَا كَانَ عِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ، وَذَلِكَ عِلْمُ تَأْوِيلِ عَرَبِيَّتِهِ([11])وَإِعْرَابِهِ، لَا تَوَصُّلَ إِلَى عِلْمِ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمْ.
فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَأَحُّقُ الْمُفَسِّرِينَ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ الَّذِي إِلَى عِلْمُ تَأْوِيلِهِ لِلْعِبَادِ سَبِيلٌ، أَوْضَحُهُمْ حُجَّةً فِيمَا تَأَوَّلَ وَفَسَّرَ، مِمَّا كَانَ تَأْوِيلُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دُونَ سَائِرِ أُمَّتِهِ، مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الثَّابِتَةِ عَنْهُ، إِمَّا مِنْ وَجْهِ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ، فِيمَا وُجِدَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ، وَإِمَّا مِنْ وَجْهِ نَقْلِ الْعُدُولِ الْأَثْبَاتِ، فِيمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَنْهُ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ، أَوْ مِنْ وَجْهِ الدَّلَالَةِ الْمَنْصُوبَةِ عَلَى صِحَّتِهِ، وَأَوْضَحُهُمْ بُرْهَانًا فِيمَا تُرْجَمَ وَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ، مِمَّا كَانَ مُدْرِكًا عِلْمَهُ مِنْ جِهَةِ اللِّسَانِ، إِمَّا بِالشَّوَاهِدِ مِنْ أَشْعَارِهِمُ السَّائِرَةِ، وَإِمَّا مِنْ مَنْطِقِهِمْ وَلُغَاتِهِمُ الْمُسْتَفِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُتَأَوِّلُ وَالْمُفَسِّرُ، بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ خَارِجًا تَأْوِيلُهُ وَتَفْسِيرُهُ مَا تَأَوَّلَ وَفَسَّرَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْخَلَفِ مِنَ التَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ.)) .
التعليق:
وجوه تأويل القرآن عند الطبري، أحد أمور ثلاثة:
1. ما لا يوصل إلى علمه إلا قبل الله .
2. وما لا يوصل إلى علمه إلا من قبل الرسول.
3. وما لا يوصل إلى علمه إلا من قبل أهل اللسان .
والنوع الأول لا يرتبط بالمعاني، فهو خارج عن حد التفسير، وأما الوجه الثاني، فمنه ما يتعلق بالتفسير، ومنه ما لا يتعلق به، وليس كل القرآن مما قد فسره النبي.
أما النوع الثالث، فهو ما قال عنه: مَا كَانَ عِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ، ومن أول من يدخل فيهم الصحابة، والتابعون واتباعهم .
وأما ما كان له حكم الرفع من كلام الصحابة فهو داخل في القسم الثاني .
وقوله: ((فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَأَحُّقُ الْمُفَسِّرِينَ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ الَّذِي إِلَى عِلْمُ تَأْوِيلِهِ لِلْعِبَادِ سَبِيلٌ)).
فهذا مخرج للوجه الأول .
وقوله: ((فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَأَحُّقُ الْمُفَسِّرِينَ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ الَّذِي إِلَى عِلْمُ تَأْوِيلِهِ لِلْعِبَادِ سَبِيلٌ، أَوْضَحُهُمْ حُجَّةً فِيمَا تَأَوَّلَ وَفَسَّرَ، مِمَّا كَانَ تَأْوِيلُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دُونَ سَائِرِ أُمَّتِهِ، مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الثَّابِتَةِ عَنْهُ، إِمَّا مِنْ وَجْهِ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ، فِيمَا وُجِدَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ، وَإِمَّا مِنْ وَجْهِ نَقْلِ الْعُدُولِ الْأَثْبَاتِ، فِيمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَنْهُ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ، أَوْ مِنْ وَجْهِ الدَّلَالَةِ الْمَنْصُوبَةِ عَلَى صِحَّتِهِ)) .
وهذا هو النوع الثاني، وذكر طريق الوصول إليه، وهو:
1. النقل المستفيض.
2. أو نقل العدول الأثبات فِيمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَنْهُ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ.
وهذا ما يسمى عند بعضهم بالتواتر والآحاد .
3. وقوله: ((أَوْ مِنْ وَجْهِ الدَّلَالَةِ الْمَنْصُوبَةِ عَلَى صِحَّتِهِ)) .
وقد ذكرها قبل ذلك: ((68، 72))، أي: أن يذكر النبيما يمكن أن يستدل به على تفسير الآية، وإن لم يكن نص عليه مباشرة .
وقوله: ((وَأَوْضَحُهُمْ بُرْهَانًا فِيمَا تُرْجَمَ وَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ، مِمَّا كَانَ مُدْرِكًا عِلْمَهُ مِنْ جِهَةِ اللِّسَانِ، إِمَّا بِالشَّوَاهِدِ مِنْ أَشْعَارِهِمُ السَّائِرَةِ، وَإِمَّا مِنْ مَنْطِقِهِمْ وَلُغَاتِهِمُ الْمُسْتَفِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُتَأَوِّلُ وَالْمُفَسِّرُ، بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ خَارِجًا تَأْوِيلُهُ وَتَفْسِيرُهُ مَا تَأَوَّلَ وَفَسَّرَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْخَلَفِ مِنَ التَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ.)).
وهذا هو النوع الثالث، وذكر أن البيان العربي يتوصل له بالرجوع إلى الشواهد:
- الشعرية، أو
- النثرية .
وقوله: ((كَائِنًا مَنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُتَأَوِّلُ وَالْمُفَسِّرُ، بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ خَارِجًا تَأْوِيلُهُ وَتَفْسِيرُهُ مَا تَأَوَّلَ وَفَسَّرَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْخَلَفِ مِنَ التَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ.)).
تنبيه: أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، فله أن يفسر بالرجوع إلى لغة العرب، بشرط أن لا يخرج عن أقوال السلف، وهو قيد مهم عنده .
وقد اعتمد الطبري هذا القيد وطبقه، وهذا من منهج الطبريتعالى .
ولو وقع في نظر الناظر أن الطبري خالف منهجه في مثال من الأمثلة،
فأقول: لا بد من الانتباه إلى أن الطبريتعالى مرتب، فقد رتب ما ورد في السنة قبل اللغة، فأحيانًا ما يعتمد الطبري على أشياء وردت في السنة، ويبني عليها المعنى، وإن ورد عن الصحابة والتابعين بعض الأقوال .
ومثال ذلك ما وقع في قول الله تعالى:وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
[النساء: 34].
حيث قال: ((فَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ:وَاهْجُرُوهُنَّ
[النساء: 34] مُوَجَّهًا مَعْنَاهُ إِلَى مَعْنَى الرَّبْطِ بِالْهِجَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ لِلْبَعِيرِ إِذَا رَبَطَهُ صَاحِبُهُ بِحَبْلٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا: هَجَرَهُ فَهُوَ يَهْجُرُهُ هَجْرًا([12]). وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ كَانَ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ , فَعِظُوهُنَّ فِي نُشُوزِهِنَّ عَلَيْكُمْ , فَإِنِ اتَّعَظْنَ فَلَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ , وَإِنَّ أَبَيْنَ الْأَوْبَةِ مِنْ نُشُوزِهِنَّ فَاسْتَوْثِقُوا مِنْهُنَّ رِبَاطًا فِي مَضَاجِعِهِنَّ))([13]).
فإذا قيل كيف ترك أقوال الصحابة والتابعين، قلنا: إنه اعتمد على إشارات نبوية في فهم الآية، وعليه فلم يخالف منهجه، وإن كان القول الذي رجحهقول غريب فيه نظر .
وهذا لا يعني عصمة الطبري، وإنما هو إشارة إلى تناسق منهجه، وعدم الهجوم على كلامه إلا بعد التبين .
(*) يمكن الاستماع للمحاضرة صوتيًا على هذا الرابط .
(1) جامع البيان: (1/74) .
(2) جامع البيان: (1/78) .
(3) انظر مقالين للشيخ د. مساعد الطيار، بعنوان: لطائف من ترجمة ابن عباس (1)، (2) .
(4) انظر مقال: التنكيت على مراحل التفسير وتدوينه في كتاب التفسير والمفسرون، لمحمد حسين الذهبي، وهو منشور بموقع الشيخ د. مساعد الطيار .
(5) روى الخطيب في الكفاية، (1/262): عَنْ عِكْرِمَةَ, قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْعِلْمِ بَحْرًا يَنْشَقُّ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ الْأُمُورِ, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَلْهِمْهُ الْحِكْمَةَ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» , فَلَمَّا عَمِيَ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ, وَمَعَهُمْ عِلْمٌ مِنْ عِلْمِهِ أَوْ كُتُبٌ مِنْ كُتُبِهِ, فَجَعَلُوا يَسْتَقْرِئُونَهُ وَجَعَلَ يُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ, فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي قَدْ تَلِهْتُ مِنْ مُصِيبَتِي هَذِهِ, فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ عِلْمِي أَوْ كُتُبٌ مِنْ كُتُبِي فَلْيَقْرَأْ عَلَيَّ, فَإِنَّ إِقْرَارِي لَهُ بِهِ كَقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ فَقَرَأُوا عَلَيْهِ ".
وانظر: تاريخ ابن عساكر: (73/216)، وسير النبلاء: (3/354) .
وروى البيهقي في المدخل، (1/408): عن عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَكْتُبُ قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ قَالَ: أَتَكْتُبُونَ؟ ثُمَّ قَامَ، قَالَ: وَكَانَ حَسَنُ الْخُلُقِ وَلَوْلَا حُسْنُ خَلْقِهِ لَغَيَّرَ بِأَشَدِّ مِنَ الْقِيَامِ ".
انظر، الطبقات، لابن سعد: (1/170) .
(6) أشار الشيخ إلى صلاحيته كبحث .
(7) قرأ القاري: ((إلا بخفير)) .
(8) قال: ((يأتي هذا الخبر في تفسير سورة غافر: (20)، ونصه هناك: "ما خرج مني إلا بحقير"، والذي كان هنا في المطبوعة "ما خرج مني بحقير"، والصواب ما أثبتناه. و "الخفير": مجير القوم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده. وراوي هذا الخبر - علي بن الحسين بن واقد: ضعفه أبو حاتم، وقال البخاري: "كنت أمر عليه طرفي النهار، ولم أكتب عنه". وأبوه حسين بن واقد: ثقة.)).
(9) قال الشيخ: يراجع كلام الطبري عند قول الله تعالى: ((وما يعلم تأويله إلا الله)) عند قوله: (وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبدالله..).
(10) كرر الطبريهذه الفكر في أكثر من موضع، وفصل هنا في الوجه الثالث، ما تركه في المواضع السابقة .
(11) في نسخة: غريبه .
(12) وهو قوله:
وَالثَّالِثُ: هَجَرَ الْبَعِيرُ إِذَا رَبَطَهُ صَاحِبُهُ بِالْهِجَارِ , وَهُوَ حَبْلٌ يُرْبَطُ فِي حَقْوَيْهَا وَرُسْغِهَا , وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ:
رَأَتْ هَلَكًا بِنَجَافِ الْغَبِيطِ ... فَكَادَتْ تَجُدُّ لِذَاكَ الْهِجَارَا
[13])) (6/704) .


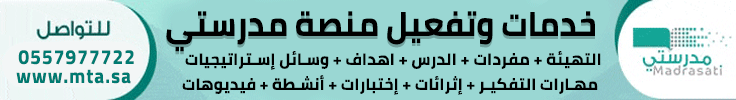






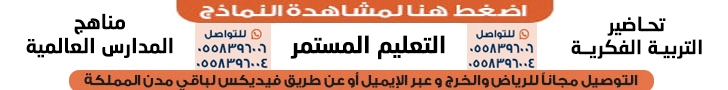



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
