بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطاعته ومرضاته
اعضاء منتدى غرابيل حفظكم الله
ما ارايته من تفاعل وتعاون في منتداكم الرائع
اعطاني الدافع لاتقدم بطلبي واطرح مشكلتي واتمنى منكم ان تقدمو لي المساعده ماأستطعتكم
ولكم دعواتي وامتناني في هذا الشهر الفضيل
لا اريد ان اخذ من وقتكم الكثير ...
انا طالبه مستجده في الجامعه قسمي هو التربيه الخاصه ولا كني الآن اعداد
عام لذا ادرس مواد كليه التربيه بشكل عام
طلبت منا دكتوره مبادئ البحث التربوي
عمل بحث بالغه الانجليزيه عن
(kmowldege resources and problem solving)
اي مصادر المعرفه وحل المشكلات
ويحوي اهميه المصادر المطبوعه في حل المشكلات سواء كانت كتب او مجلات او موسوعات
وكذالك التعامل والتفاعل داخل المكتبه ومحركات البحث في الانترنت..
استفسرت منها اكثر فقالت انها تبي اهم الموسوعات اللي تساعد في البحث
وحل المشكلات وكذالك اهم الكتب ومحركات البحث على النت وكيفيه استخدامها
واهمها اي ذكر امثله عليها ...
بحثت كثيرا لاكني لم اجد ظالتي فكرت بكتابته باللغه العربيه ثم الذهاب به للمكتبه لترجمته ..
ولذا اطرح لكم مشكلتي واطلب منكم مساعدتي وجمع المعلومات من عندي وبمساعتكم يتكون بحث
رائع باذن الواحد الاحد ..
لا حرمكم الله الاجر وجزاكم الله كل خير ..


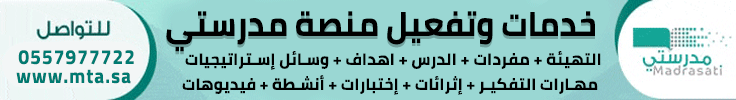






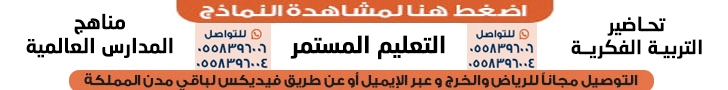


 [/align]
[/align]
