أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
جاء في لسان العرب (1/468) واحدُ الذِّبَّانِ ذُبابٌ، بِغَيْرِ هاءٍ. قَالَ: وَلَا يُقال ذُبَابة. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً. اهـ
وقال ابن فارس كما في الفرق ص 97: وأنثى الذباب ذباب بغير هاء كما يقال للذكر والهاء لا تكون في ذلك أصلا. اهـ
وقال سيبويه في كتابه (3/603): وأما ما كان فعالاً فإنه في بناء أدنى العدد بمنزلة فعالٍ؛ لأنه ليس بينهما شيء إلاَّ الكسر والضُّم. وذلك قولك: غرابٌ وأغربةٌ، وخراجٌ وأخرجةٌ، وبغاثٌ وأبغثةٌ. فإذا أردت بناء أكثر العدد كسّرته على فعلانٍ، وذلك قولك: غرابٌ وغربانٌ، وخراجٌ وجرجانٌ، وبغاثٌ وبغثانٌ، وغلامٌ وغلمانٌ. ولم يقولوا: أغلمةٌ، استغنوا بقولهم: ثلاثة غلمةٍ، كما استغنوا بفتيةٍ عن أن يقولوا: أفتاءٌ.
وقالوا في المضاعف حين أرادوا بناء أدنى العدد كما قالوا في المضاعف في فعالٍ، وذلك قولهم: ذبابٌ وأذبةٌ. وقالوا حين أرادوا الأكثر ذبّانٌ، ولم يقتصروا على أدنى العدد لأنَّهم أمنوا التضعيف. وقالوا: حوارٌ وحيرانٌ، كما قالوا: غرابٌ وغربانٌ. اهـ
وجاء في المطلع على ألفاظ المقنع ص 55: وأما الذباب، فهو هذا المعروف، وهو مفرد، وجمعه ذِبَّانٌ وأَذِبَّةٌ، ولا يقال ذبابة: نص على ذلك ابن سيده، والأزهري، وأما الجوهري فقال: واحدة ذبابةٌ، ولا يقال ذبانة والصواب الأول، والظاهر أن هذا تصحيف من الجوهري، رآهم قالوا: ولا يقال: ذبابة فاعتقدها ذبانة وأجراه مجرى أسماء الأجناس المفرق بينها وبين واحدها بالتاء، كتمرة، وتمرٌ. اهـ
وجاء في تاج العروس (2/421-422): (والذُّبَابُ م) وَهُوَ الأَسوَدُ الَّذِي كَون فِي الْبيُوت يَسْقُطُ فِي الإِناءِ والطَّعَامِ، قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي حَيَاة الْحَيَوَان: سُمِّيَ ذُبَاباً لكَثْرَةِ حَرَكَتِه، واضْطِرَابِه، أَو لأَنَّه كُلَّمَا} ذُبَّ آبَ قَالَ:
إِنَّمَا سُمِّيَ {الذُّبَابُ} ذُبَاباً حَيْثُ يَهْوِي وكُلَّمَا ذُبَّ آبَا
(و) الذُّبَابُ أَيضاً (: النَّحْل) قَالَ ابنُ الأَثِير: وَفِي حَدِيث عُمَرَ رَضِي الله عَنهُ (فَاحْمِ لَهُ فإِنَّمَا هُوَ {ذُبَابُ الغَيْثِ) يَعْنِي النَّحْلَ، أَضَافَهُ إِلى الغَيْثِ على معنى أَنه يكونُ مَعَ المَطَرِ حَيْثُ كَانَ، ولأَنه يعيشُ بأَكلِ مَا يُنْبِتُه الغَيْثُ (الوَاحِدَةُ) من ذُبابِ الطَّعَامِ} ذُبَابَةٌ (بهاءٍ) وَلَا تقل: ذِبَّانَةٌ أَي بِشَدِّ المُوَحَّدَةِ وبعدَ الأَلفِ نُونٌ، وَقَالَ فِي ذُبَابِ النَّحْلِ: لاَ يُقَالُ ذُبَابَة فِي شيْءٍ من ذَلِك، إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ روى عَن الأَحْمَرِ ذُبَابَة، هَكَذَا وَقع فِي كتاب المُصَنَّفِ روايةِ أَبِي عليَ، وأَما فِي رِوَايَة عليِّ بنِ حَمْزَةَ فَحَكَى عَن الكسائيّ الشَّذَاةُ: ذُبَابَةُ بعضِ الإِبِلِ، وحُكِيَ عَن الأَحْمَرِ أَيْضاً النُّعَرَةُ: ذُبَابَةٌ تَسْقُطُ على الدَّوَاب، فَأَثْبَتَ الهَاءَ فيهمَا، والصوابّ: ذُبَابٌ، وَهُوَ واحدٌ، كذَا فِي (لِسَان الْعَرَب) . وَفِي (التَّهْذِيب) : وَاحِدُ الذِّبَّانِ، بِغَيْرِ هَاءٍ، قَالَ: وَلاَ يُقَالُ: ذُبَابَةٌ، وَفِي التَّنْزِيل: {2. 029 وان يسلبهم {الذُّبَابُ شَيْئا} (الْحَج: 73) فسَّرُوه للواحِدِ (ج} أَذِبَّةٌ) فِي القِلَّةِ مثلُ غُرَابٍ وأَغْرِبَة قَالَ النَّابِغَة:
ضَرَّابَة بالمِشْفَرِ الأَذِبَّهْ.اهـ


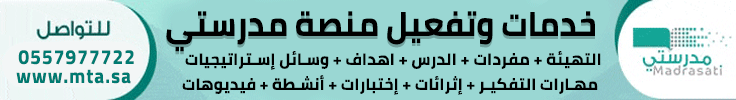






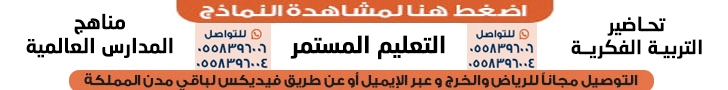

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
