احترس من سوء الظن
1- يدمر علاقاتك بالناس:
سوء الظن كالقنبلة التي تنفجر فتدمر كل جميلٍ في الوجود؛ لا تعترف بزرعٍ أو زهرٍ أو بستان، أو طائر وديع أو حيوان أليف أو إنسان رحيم.
سوء الظن كاللغم إذا انفجر؛ يخدعك باختفائه، وتُصدم بإهلاكه، حين لا يكون اعتبار لصغير أو كبير، لامرأة أو رجل، لشيخ أو شاب.
سوء الظن هو القنبلة أو اللغم الذي يدمر العلاقات بين الأفراد، ويُفجِّر الصلات بين المجتمع، ويفكك الروابط بين العائلات، ويجفف العواطف بين الناس، يقول تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)﴾ (الناس).
*
2- يدمر علاقاتك بأسرتك:
الحنان والدفء الأسري جوٌّ من أجمل أجواء الوجود؛ فالحب الأسري يرفرف في جنبات البيوت، لا تسمع إلا الكلمة الطيبة المُشجِّعة الدافعة، ولا ترى إلا البسمة الحانية الدافئة، ولا تشعر إلا بالبهجة المنشطة الباعثة للحياة، ولا تحس إلا باللمسة العاطفة الرائقة، التي تهز الوجدان والكيان، ولا تبصر إلا بقلب يخفق من أخلاق عالية كريمة.
كل هذه الأجواء سرعان ما يسري السمّ القاتل في جنباتها حينما يُسيطر سوء الظن على النفوس، وتمتلئ به الصدور، وتفسد به القلوب.
فكم من زوجةٍ عانت من زوجها! وكم من زوجٍ تألَّم من زوجته! وكم من أبناء ضاقوا بآبائهم! وكم من آباء تحسروا على أبنائهم! وهل تستمر علاقات أسرية تقوم على المعاناة والألم والضيق والحسرة؟!.
3- يدمر علاقاتك بالمجتمع:
وهذه دائرة أوسع ولكنها ترجمة لحياتك اليومية؛ فأصدقاؤك هم حياتك، فلماذا تقتل هذه الحياة بسوء الظن بهم؟! وزملاؤك في العمل هم جزء من حياتك اليومية، فلماذا تصيبها بالشلل حينما يكون التعامل معهم بسوء الظن؟! وجيرانك هم سرٌّ من أسرار حياتك، فلماذا تخنقها بيدك حين تتعايش معهم بسوء الظن؟!.
4- تأمل هذه الصورة القرآنية:
يقول تعالى: ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12)﴾ (القلم)، لقد تأملت هذه الصورة القرآنية في مظاهرها، وتعمقت فيما رسمه الله من أشكال هذه الصورة في السلوك مع الناس والمجتمع والأسر، فقد تجمعت فيها عدة مظاهر:
- تلفيق الأكاذيب.
- تزوير الأخبار.
- تضييع الحقوق.
- صد عن الحق.
- ظلم الآخرين.
فتساءلت في نفسي: ما سبب سوء الظن الذي أتى بهذه النتائج المسيئة في المجتمعات؟
إذا كان سوء الظن قد أتى بكل هذه المظاهر والأشكال فلا بد أن يكون سببه هو مرضًا عضالاً من الأمراض المستعصية التي لا علاج لها بسهولة، فأدركت على الفور أنه (الهوى).
*
ففي شدة حادثة الإفك في المجتمع النبوي تأتي الآيات من السماء تؤكد السبب الذي دفعهم إلى سوء الظن، فيقول تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ﴾ (النور: 15).
وفي مجتمعاتنا كم من حوادث يجمعها الإفك، ويحركها الهوى، ويصنعها سوء الظن!، وإليك هذه المشاهد التي نعيشها ونراها ويلمسها المتأملون:
- مجالس القيل والقال والخوض فيما لا يفيد، وقد قال الحكماء في ذلك: عدم الخوض في كلامٍ لا ينبني عليه عمل؛ فإنه من التكلف الذي نُهينا عنه شرعًا.
والعجيب أن هذه المجالس قد يقدمها أصحابها باسم التربية أو التوظيف أو ترقية بعض الأشخاص أو لدواعي الأمن؛ فقد تتعدد المبررات وسوء الظن واحد.
- انتقال الحديث دون وعي أو تثبُّت، وهذا مشهد آخر يُعكِّر الأجواء الصافية، ويكدِّر الأوقات الحالمة، ويرهق القلوب الطاهرة، فما الذي يجعل الإنسان ينقل كلامًا عن الآخرين دون وعي به، أو تحقُّق أو تثبُّت منه؟!.
ألا تتفق معي في أن سوء الظن منطلق من هوى النفس؟!.
فإذا سئلت عن الأدلة، كان القول الجاهز: (قالوا لنا، أو سمعنا به، أو وصل إلينا، أو جاءنا من ثقة).
لقد قيل لأحد السلف حينما سأل: وما دليلك؟ فقال: جاءني من ثقة، فرد عليه: الثقة لا يبلغ.
فما إذن الداعي وما الدافع لهذا القول الجاهز ولا يقدم دليلاً واحدًا لإثبات ما يقول أو يخبر به؟! إنه سوء الظن الذي صنعه الهوى في النفس.
5- أعراض وعلاج:
فإن سأل سائل كريم عن أعراض سوء الظن قلنا له: هو ما تراه من أقوال وأفعال تفضح المرضى، وإن أظهروا عافيتهم وابتعادهم عن سوء الظن؛ تراها في:
- التجسس.
- كشف العورات.
- الاتهامات الظالمة.
- الأحوال المضطربة.
- البخل والحرص.
- الكذب والجبن.
يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: من الآية 12).
لماذا يأمرنا الله تعالى باجتناب الكثير من الظن؟ حتى نمنع القليل، فهل أدركنا هذا المعنى؟ وهل تأملنا النتيجة حينما نجتنب الكثير فنمنع القليل من أجل أن يختفيَ سوء الظن بيننا وحتى ندرك أن الله يعالجنا وهو أعلم بنا؟ ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: 14).
ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم وحذَّر الحبيبُ أحبابَه وأصحابه من سوء الظن فقال: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث".
ولكي تختفي هذه الأعراض أوضح الله لنا العلاج في أكمل صورة وأيسر سلوك، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).
*
حقيقة سوء الظن
1- مراحل سوء الظن:
سوء الظن كسائر الأشياء، يولد ثم يكبر، وينمو حتى يشتد عوده، ويقوى ويتحكم ويقود، وهذه هي مراحل النمو، حتى ندرك حقيقة سوء الظن، فنحسن التعامل معها ونحترس منها:
مرحلة التصور:
وهي سباحة في الوهم، وصناعة في الخيال، لا يراها أحد إلا صاحبها، ولا يدرك بوجودها إنسان إلا متصورها، الذي ينسج من خياله أشياء كثيرة ليس لها وجود في الواقع أو حياة الناس.
*
مرحلة الفكر:
ونتيجةً لهذا التصور في خياله يتحول إلى فكرة عن الناس، مثل سلوك معين أو أسلوب عمل أو طريقة تفكير أو تعبير عن موقف، وكل هذه الأفكار غير موجودة في الناس، الذين نسج خياله عنهم هذه الأفكار الخيالية.
مرحلة الإنتاج:
تدخل الفكرة في مرحلة الإنتاج، وتدخل أول برامج الصناعة؛ برنامج صوَّره له الشيطان ويشرف على تنفيذه، وبرنامج صوَّره له هواه ويدير تشغيله، ولنا أن نتصور كيف يكون منتَجًا من صناعة الشيطان وإدارة الهوى!.
مرحلة التنفيذ:
وفيه يقدم فكرته في جرأة وليس معه دليل أو برهان، وسر جرأته في الشيطان والهوى اللذين دفعاه إلى هذا السلوك، فينال من فلان، أو يدّعي على علاّن، أو يشوه سمعة الآخرين، أو يتسلق على مهامهم بالتهميش أو التجميد أو الإقصاء، دون تثبت أو تبين أو حجة.
مرحلة القناعة:
وهذه أخطر المراحل؛ لأنها النتيجة المظلمة لكل المراحل السابقة، حين يقنع نفسه بهذه الأشياء، لا يصدقها فحسب، وإنما يدافع عنها كأنها حق يصان، أو يقاتل دونها كأنها حقيقة مقدسة.
2- حتى لا تغيب عنا الحقيقة:
*
فالحقيقة تتخلص في أمرين:
الأول: أنه استسلم للظن الذي صنعه بنفسه، واستجاب لظنه، دون اعتبار أو إدراك لهذا الظن، أو خطره على الناس.
الثاني: أنه تبنى ظنه، وبنى سائر معاملاته مع الناس عليه، والتبني مرحلة بعد القناعة التي أوصلته إلى هذا السلوك العجيب.
*
وحتى لا تغيب عنا حقيقة سوء الظن تعالَ نتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى هذا السلوك أصلاً، وهي ستة أسباب؛ نجملها في التالي:
- ضعف الإيمان:
يقول تعالى: ﴿قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: من الآية* 14)، وقوة القلب في حياته، وحياته بما يتحقق فيه من آثار الأعمال التي تعصمه من سوء الظن، يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَا﴾ (الأنفال: من الآية 2)، ورضي الله عن عمر صاحب الإيمان القوي، وهو يأخذ بيد الرجل والرجلين قائلاً: "تعالوا نزداد إيمانًا"، وكان من فقه ابن مسعود أن يقول في دعائه: "اللهم زدني إيمانًا وفقهًا".
- قلة الخوف:
يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران 175)، والخوف إما تعظيمًا لله، في قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا﴾ (نوح: 13)، وإما محبةً لله، في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (آل عمران: من الآية 8)، وإما وقاية من وعيده، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحريم: من الآية 6).
فالخوف إذا سكن القلب أحرق الشهوات وطرد منه الهوى، وهو سراج القلب يبصر به ما فيه من الخير والشر.
- عدم الثقة في النفس:
العزة والغلبة والعاقبة تكون للمؤمنين، فإن لم يكونوا كذلك فهناك خلل من عند أنفسهم، هذا الخلل هو المسئول عن المعاصي، وأخطرها سوء الظن، فيفعل الظلم، ويعمل بالجَور، ويبطش بلا عدل، ويرى محاسن غيره مساوئ.
- توهم شر الناس له:
*
*فالناس كلهم يتربصون به، ويحيكون له الدسائس، ويتآمرون عليه لإقصائه من الوجود، ويفسِّر كل قول أو موقف أو حركة وَفق ما توهمه هو، وليس كما في الواقع، وبذلك يتعامل على ما اقتنع به، وهو في الحقيقة خيال ووهم لا وجود له.
- ارتكاب المعصية:
المعصية هي السم القاتل الذي يخنق الإيمان ويدمره، فإذا نبته وزهره يختفي، وإذا ثمره يفسد، وما يزال العبد في الخطيئة والسير في طريقها حتى تغيب شمس إيمانه ويذهب يقينه فيهلك.
- مستويات الناس المختلفة:
التفاوت بين الناس في مستوياتهم المالية والاجتماعية والعلمية والثقافية أمر طبيعي في الحياة، ووفق قاعدة الإسلام "أحب لأخي ما أحب لنفسي" يختفي الحقد والحسد والغل واللؤم والخسة المحرك الرئيس لسوء الظن.
*
3- إلى العلاج في أربع جلسات:
1- إدراك خطر سوء الظن كمعصية:
- أنه من صفات المنافقين:
يقول تعالى: ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ (الفتح: 12)؛ فقد دفعهم سوء الظن إلى القول: اعدل يا محمد!.
يقول القرطبي: "الظن في الآية هو التهمة كمن يتهم بالفاحشة أو شرب الخمر مثلاً، ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك".
ثم يقول: "والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا يجب الاجتناب".
ويقول تعالى: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (الفتح: 6)، وفي الحديث القدسي: "أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ظن بي خيرًا فله، وإن ظن بي شرًّا فله".
*
- من خصال الكافرين:
يقول تعالى: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ﴾ (ص: من الآية 27)، وفي الحديث القدسي: "أنا عند حسن ظن عبدي بي وليظن بي ما شاء".
- من صفات الطغاة:
لأن الباعث على الطغيان الخوف والجبن والحقد، وسبب الخوف والجبن هو سوء الظن الذي يؤدي إلى الحقد؛ فكل من يحمل سوء الظن هو في الحقيقة (مشروع طاغية)، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.
يقول تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ (يوسف: من الآية 53)، ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)﴾ (العلق).
- من أخلاق سوء الظن:
البخل والحرص والجبن، من أخلاق سوء الظن؛ فأما البخل فإنه يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، وأما الحرص فإنه يزين لك الشره بالجَور والظلم، وأما الجبن فإنه يضعفك عن الأمور.
يقول ابن عباس: الجبن والبخل والحرص غرائز سوء؛ يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل.
2- التوكل على الله:
تفويض الأمر إلى الله في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: من الآية 3)، وهذا التفويض هو تفويض الرضا وليس تفويض الإكراه أو الإجبار، فما ارتباطه بسوء الظن؟.
إن الذي يفوض أمره لله تعالى يشعر براحة وانشراح تدفعه إلى العمل في يقين وثقة بما يقدره الله، وما عليه إلا الرضا الحقيقي، وهذا هو تفويض الرضا، وبالتالي يقطع الطريق أمام الشيطان أو الهوى اللذين يحركان في نفسه سوء الظن، فإن أحسن الظن بربه أحسن الظن بالناس، ومن أحسن الظن بالناس تغير سلوكه معهم نحو الأفضل دائمًا، وابتعد عن الظنون بهم، والتمس لهم الأعذار.
3- عدم الاستسلام والعلاج:
*
قد يدرك الكثير في لحظات الصفاء مع نفسه مخاطر سوء الظن، وقد يدرك أيضًا أنه داء لا بد أن يعالج، ولكن باعتياده لهذا الأمر يتناسى هذه المخاطر، وبالتالي يقع فريسةً لليأس، فيعلن استسلامه للواقع، وإخفاقه في أي علاج!!.
ومن أجل أن نبدد ظلام اليأس، هيا معًا نجيب عن بعض الدواعي التي تدفعنا إلى اليأس، وهي أسئلة قد تتردد داخل أنفسنا، فإن لم نعثر على وضوح لها صارت شبهات مستحكمة، أو شهوات يصعب التخلص منها، ومثال ذلك:
أ- هل يجوز إطلاق الأحكام من الظن؟
لا يجوز ذلك إطلاقًا، انطلاقًا من سوء الظن أو الظن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ظننت فلا تحقق"، ومعنى الحديث لا يجوز أن يكون أساس الحكم على الآخرين بالظن، وبالتالي لا يجوز التحقيق معهم.
2- متى تكون شريكًا في سوء الظن؟
إذا سمع أحد من يمارس الظن بأخيه فلم يمنعه من ذلك كان شريكًا له في الإثم، وهذا جزء من مشهد توبة كعب بن مالك؛ حيث يقول: "ولم يذكرني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: "ما فعل كعب بن مالك؟" قال رجل من بني سلمة: "يا رسول الله.. حبسه برداه، والنظر في عطفيه"، فقال له معاذ بن جبل: "بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا"، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في قوله تعالى في حادثة الإفك: ﴿لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ (النور: 12).
هذا مشهد قلما أن يتكرر، فقد روي عن أبي أيوب الأنصاري وامرأته حينما قالت له: "يا أبا أيوب.. أسمعت ما قيل؟"، فقال: "نعم وذلك الكذب.. أكنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟"، قالت: لا والله، قال: فعائشة أفضل منك، قالت أم أيوب: نعم.
3- متى يكون سوء الظن محرمًا؟
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث" (متفق عليه).
يقول العلماء: إذا توفرت ثلاثة شروط كان سوء الظن محرمًا:
*
الشرط الأول: متى يساء به مسلم.
الشرط الثاني: متى انقلب إلى عمل واتهام.
الشرط الثالث: متى كان ظاهره الصلاح والعدالة.
فالظن بهذه الشروط هو الذي يؤدي إلى التجسس، والتجسس يؤدي إلى الغيبة، وللخروج من دائرة الحرام يحتاج الأمر منا جميعًا إلى الالتزام بالتقوى، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ (الحجرات: 12).
4- ماذا لو اجتمع سوء الظن والهوى؟
يشتد الخطر كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ (النجم: من الآية 23)، وهذا ما حذر الله منه جميع الأنبياء، فقال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ (ص: من الآية 26).
وقال الله تعالى لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18)﴾ (الجاثية / 18).
وكما تبين أن الهوى هو أصل من أصول سوء الظن، وإذا اجتمع معه فإنه في الغالب يؤدي إلى البخل والحرص والجبن.
*
5- ماذا إذا سمعت ظنًّا عن أخيك:
المفروض أن تطرد هذا الظن عنه، أو أي تصور فيه إساءة عنه، كما مر في قوله تعالى: ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12)﴾ (النور / 12).
لقد رأى بعض الصحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتكلم مع زوجته صفية عند باب المسجد ليلاً، فقال لهما: "على رسلكما إنها صفية بنت حيي"، فقالا: وهل نظن فيك إلا خيرًا يا رسول الله، قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّا".
*
6- متى يكون الظن بعيدًا عن الإثم؟
حرَّم الإسلام سوء الظن، للوقاية من الوقوع في الإثم، كما رأينا، أما الظن القائم على ثلاثة أمور:
- الخواطر.
- الأحاسيس.
- حديث النفس.
فهو لا سلطانَ لأحد عليه، ولذلك فهو خارج دائرة التحريم؛ لأنه لم يستوفِ الشروط الثلاثة التي سبق الحديث عنها، والتي تجعله حرامًا.
والتعامل الصحيح في هذه الأحوال الثلاثة طرد الخاطرة السيئة، والسيطرة على الإحساس، ونقل حديث النفس إلى أعمال إيجابية، حتى لا يقع الإنسان في الإثم.
لقد صعد النبي- صلى الله عليه وسلم- المنبر، فنادى بصوت مرتفع، فقال: "يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه.. لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه مَن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومَن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله".
الجلسة الرابعة: حسن الظن
ومعناه:
- اعتماد الإنسان المؤمن على ربه في أموره كلها.
- ويقينه الكامل وثقته التامة بوعد الله ووعيده.
- واطمئنانه بما عند الله فلا يسكن لغيره ولو امتلك غيره الكثير.
- وعدم اعتماده على نفسه وتدبيرها وما يقوم به من أعمال
*
ومن أفواه مَن أحسن الظن، نستخرج الدروس والعبر، ونستلهم الحكمة مما حققوه في حياتهم، واستمتعوا بممارسته وتطبيقه:
يقول أحد السلف: "حسن الظن بالله ألا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا ذنبك"، ويقول آخر: "والذي لا إله إلا هو ما أعطى قوم قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن الظن له ورجائه له، والكف عن اغتياب المؤمنين".
وكما قيل: رأس العبادة حسن الظن بالله.
- وهذا موقف عملي:
يختصر الطريق لإظهار حسن الظن بطريقة عملية، فقد جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: إن فلانًا قال كذا وكذا (وشاية به).
فقال له عمر: إن كنت صادقًا واعتذر عذرناه وإن كنت كاذبًا عاقبناك، وإن شئت عفونا عنك.
فقال: بل العفو.
- وظل التاريخ يشهد بحسن الظن:
خاصةً في المواقف الصعبة، وأصعب ما مرَّ بالمجتمع المسلم حادثة الإفك، فتأمل هذين المشهدين:
قول زيد بن حارثة للنبي- صلى الله عليه وسلم- في حادثة الإفك: "أهلك يا رسول الله، وما علمنا عليهم إلا خيرًا"، وقول زينب بنت جحش: "احفظ سمعي ولساني، والله لا أقول إلا خيرًا".
يقول عمر بن الخطاب: "لا تظن بأخيك سوءًا بكلمةٍ قالها ما دمت تجد لها في الخير محملاً". فأرسى قاعدةً في التعامل بحسن الظن حتى ولو أُسيء إليك بالقول أو العمل.
خلاصة حسن الظن
- إذا أردت وقايةً من الوقوع في الإثم المصاحب لسوء الظن.
- وإذا أردت علاجًا لسوء الظن إذا وقع بك.
- وإذا أردت أن تتحقق من حسن الظن في نفسك
- وإذا أردت أن تتعايش مع الآخرين بحسن الظن.
* فابدأ من الآن بقطع كل صلة لك بمواطن سوء الظن، وأماكن سوء الظن، ومجتمعات سوء الظن.
* وابدأ من الآن العمل والتدريب على حسن الظن والتخلق به.
* وابدأ من الآن التأكد أن سلوكك مع ربك ونفسك والناس هو (حسن الظن).
وهذا هو مدار حديثنا اللاحق بإذن الله، خاصةً حسن الظن بين الزوجين، فالغيرة محمودة بين الأزواج إلا إذا تحولت إلى سوء الظن، وبالمصارحة والوضوح بعيدًا عن التجسس، يمكن لكل زوجين استعادة الثقة بالحب والاحترام والتفاهم والمشاركة وجميل الظن ببعضها.
رابعًا: كيف أحقق حُسن الظن؟
*
- علامات حسن الظن
اسأل نفسك هذه الأسئلة، فإن كانت الإجابة: (نعم)، فقد ظهرت علامات حسن الظن عليك، وبالتالي أصبحت مؤهلاً إلى الخطوة الثانية، ومن أعماق قلبك أجب:
- هل أنت مطمئن تمامًا إلى نيتك؟
- هل أنت واثق بحسن نيتك؟
- هل تغلب جانب الصدق في أقوالك؟
- هل تغلب جانب الخير في تصرفاتك؟
- هل أنت قادر على التماس الأعذار للآخرين؟
- هل تحرص على إلحاق النفع بالآخرين؟
- هل إذا عجزت عن نفع الآخر فعلى الأقل لا تضره؟
- هل تحرص على إسعاد الآخرين؟
- هل إذا عجزت عن إسعاد الآخرين فعلى الأقل لا تحزنه؟
- هل تحرص على مدح الآخرين ؟
- هل إذا عجزت عن مدح الآخر فعلى الأقل لا تذمه؟
حاول الإجابة مسترشدًا بما قيل في الحِكم:
* إذا رأيتم المؤمن صموتًا فقد سلك مسالك الحكمة.
* إن لم تنفعه فلا تضره.
* وإن لم تفرحه فلا تغمه.
* وإن لم تمدحه فلا تذمه.
حسن الظن يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن.
وقد أجمعت آية واحدة تلك العلامات في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)﴾ (الأحزاب).
*
سبع خطوات لتحقيق حسن الظن
الأولى: حسن العمل:
يقول صلى الله عليه وسلم: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه".
فهذه رحلة الحياة، هي رحلة عمل، والعمل في عمومه هو حسن الظن، لقول الحسن البصري: "إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل".
*
الثانية: التدريب على حسن الظن:
ونعني بالتدريب، تعلُّم حسن الظن، وهذا ما كان يلقنه النبي- صلى الله عليه وسلم- لأصحابه، يروي البخاري أن رجلاً جاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودَ، فقال صلى الله عليه وسلم:
هل لك من إبل؟
قال: نعم.
قال: فما ألوانها؟
قال: حُمر.
قال: هل فيها من أوراق (سود).
قال: نعم.
قال: فأنى أتاها ذلك.
قال: عسى أن يكون نزعه عرق.
قال: ونستنتج من ذلك أن النبي المعلم- صلى الله عليه وسلم- أخذه في دورة تدريبية تثقيفية، حتى يمتلك المعرفة السليمة.
*
الثالثة: التماس الأعذار:
يقول أحد السلف: إني لألتمس لأخي المعاذير من عذرٍ إلى سبعين، ثم أقول: لعل له عذرًا لا أعرفه.
فماذا يعني سوء الظن بالمجتمع إلا القطيعة عن المجتمع، مما يسبب خللاً في العلاقات، وفوضى في المعاملات، سواء كان على مستوى الأسرة أو الناس أو الحاكم أو الشعوب أو الأمة.
*
الرابعة: التخلق بحسن الظن
ويبدأ ترسيخ هذا السلوك والتخلق به، حينما يسأل كل منا نفسه: لماذا نزكي أنفسنا ونتهم غيرنا؟
والله تعالى يقول: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى (32)﴾ (النجم، ويذم اليهود الذين زكّوا أنفسهم، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلْ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: من الآية 49)، والدافع للتخلق بحسن الظن أمران:
الأول: أن المؤمن يعمل الخير ويجتهد في الطاعة، ويقول: أخشى أن لا يقبله الله مني، فإنما يتقبل الله من المتقين، وما يدريني أن أكون منهم؟
الثاني: يلتمس المعاذير للناس جميعًا، خاصة لإخوانه وأصدقائه وأقاربه، فإن وصل إلى سبعين عذرًا، التمس لهم عذرًا لا يعرفه.
*
*
الخامسة: حاول أن يكتمل إيمانك:
*
لا يكتمل إيمان الإنسان إلا بأمرين: حسن الظن بالناس وحسن الظن بالله، فالاثنان يكمل بعضهما الآخر، ولا يتحقق أحدهما إلا بالآخر، وبهما معًا يكتمل إيمان المرء.
*
فمن وثق بربه واعتمد عليه وفوض الأمر إليه، لا يظن بالناس إلا خيرًا، ويحمل ما يصدر منهم على أحسن الوجوه، ويغّلب جانب الخير دائمًا على جانب الشر معهم، فمن أعظم شعب الإيمان حُسن الظن.
*
تأن ولا تعجل بلومك صاحبًا لعل له عذرًا وأنت تلومه، فمن أخطر ما يأكل الإيمان اتهام النيات، والحكم على السرائر، وإنما علمها عند الله.
*
*
السادسة: عليك بجميل الظن
يقول الشاعر:
وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع
*
وجميل الظن هو ما يقوم على سلوكيات أربعة:
- يتوقع الخير لكل الناس.
- يتفاءل بوقوع الخير لكل الناس.
- يوسع الأمور ولا يضيقها.
- يبقى باب الأمل دائمًا مفتوحًا.
*
وصاحب جميل الظن يرجو الله تعالى بالدعاء، والدعاء لا يكتمل إلا بعد الأخذ بالأسباب، ولذلك فكل ما يؤدي به إلى الالتزام بهذه السلوكيات الأربعة، يأخذ به، ويمارسه في حياته، ويحققه في مواقف عملية مع المجتمع والناس وأسرته.
*
*
وبذلك نفسر هذه الحركات الدميمة، التي لا تحس فيها بأي قطرة جمال في الظن، من دعوة إلى اليأس، أو كلمة إحباط، أو مفاجئتك عند طلبك بكلمة (لا)، أو تضيق كل ما اتسع من الأمور، أو غلق كل باب من أبواب الخير، أو توقع الشر والأذى قبل وقوعه، وملخص ذلك كله في (رفض كل جميل) وهذا هو الظن الدميم.
فيما رواه مسلم قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير
وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له".
وأمر المؤمن يعني حالين: مع نفسه أو مع غيره، فيشكر الله عند السراء إذا وقعت به أو بالناس، ويصبر الناس عند الضراء إذا وقعت به أو بهم، وصدق النبي- صلى الله عليه وسلم-: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير" (رواه مسلم).
*
السابعة: لا يفوتك وقت
حسن الظن بالله وبالناس، وأجب كل الأوقات:
*
11-* في حال الضرر والنفع، فالنافع والضار هو الله.
*
12-* وفي حال النجاح والفوز والنصر، فالنصر من عند الله.. ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: من الآية 126).
*
13-* وفي حال السعة والضيق، فالعاطي والمانع هو الله، وفي الحديث القدسي فيما رواه البخاري: "أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني".
*
14-* وفي حال الدعاء بيقين يحققه الله تعالى، طول الحياة، ففي الحديث: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله".
*


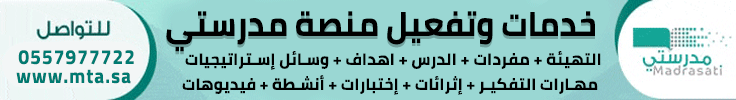






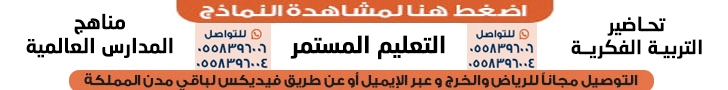


 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
