أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
التقييد على التهذيب: ضبط عنوانه وإثبات نسبته إلى أبي الحسن الزرويلي(*)
لا ريب في أن لأبي الحسن تقييدٌ على التهذيب؛ فقد ذَكرَ ذلك كلُّ مَن ترجمه (1)؛ لكن ههنا بحثان يحتاجان منَّا إلى تحرير:
أوَّلهما: ضبطُ عنوانِ الكتابِ، وثانيهما: إثبات أن ما بين أيدينا هو "التقييد" المنسوب إلى أبي الحسن في كتب التراجم، فنقول – في تحرير الأمرين – مستعينين بالله تعالى:
أولاً: ضبط عنوان الكتاب:
اختُلف فيه على أقوال؛ فقيل: هو شرحٌ، وقيل: هو تقييدٌ؛ وعلى القول الثاني اختُلف هل لأبي الحسن تقييدٌ واحدٌ أم تقاييد متعددة على التهذيب!
فممن سماه شرحاً على التهذيب (أو على المدونة في اصطلاح المتأخرين المبني على إطلاق الفرع على الأصل) نذكر على سبيل المثال لا الحصر: الشيخَ أحمد بابا التنبكتي (2)، والحجويّ الفاسي (3)، وآخرين، وسُمي شرحاً في دليل مخطوطات الخزانات الحبسية بالمغرب (4)، وجاء على غلاف النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (141/ فقه مالكي) في رواق المغاربة بالأزهر الشريف ما نصُّه: "الأول من الشيخ أبي الحسن الصُّغَيِّر؛ وهو الأوسط من شروحه على التهذيب".
وممن سماه تقييداً على التهذيب (أو على المدونة في اصطلاح المتأخرين المبني على إطلاق الفرع على الأصل) نذكر على سبيل المثال لا الحصر: لسانَ الدين الخطيب (5)، والقاضي برهان الدين ابن فرحون (6)، وابن القاضي المكناسي (7)، والشيخ أحمد بابا التنبكتي (8)، وأبا الربيع سليمان الحوَّات (9)، والحجوي الفاسي (10)، وآخرين.
ونَظَمَه شِعراً الشيخ عرفات، فقال مُتَفَنِّناً:
عنه تقاييدُ على الكِتابِ = - كذا الرسالةُ - مِنَ الطلّاب(11).
وسُمي تقييداً في كشاف مخطوطات الخزانة الحسنية بالرباط (12)، ومعجم تاريخ التراث الإسلامي (13)، وفهارس خزانات أخرى حول العالم.
ومما لفَتَ انتباهنا أن كل المصادر التي سُمي -هذا الكتاب- فيها شرحاً وردت تسميته فيها تقييداً أيضاً - في نفس الصفحة أو الترجمة- دون العكس، إضافةً إلى أن بعض المصادر جمعت كلمتي "الشرح" و "التقييد" في عنوان الكتاب، فجاء ذكره في معجم تاريخ التراث الإسلامي بعنوان: "التقييد في شرح المدونة الكبرى" (14) .
وعلى كلٍّ فإن "التقييد" و"الشرح" وصفان للكتاب الذي وضعه أبو الحسن (أو وُضِع من مجالس إقرائه أو إملائه) على التهذيب؛ حيث كان في تلك المجالس يشرح تهذيب البراذعي لمسائل المدونة والمختلطة، فهو بالنظر إلى الإلقاء والإملاء "شَرْحٌ"، وبالنظر إلى الكتابة عنه "تقييدٌ"، والله أعلم وأحكم.
ثَمَّةَ مسألة تتعلق بتسمية كتاب أبي الحسن تقييداً على التهذيب؛ وهي: ما ذُكِر من أن له تقييداً كبيراً، وآخر صغيراً، وبينهما تقييدٌ أوسط.
لم يُذكَر في كتب التراجم أن له تقييداً أوسط، ولكن وقع على غلاف النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (141/ فقه مالكي) في رواق المغاربة بالأزهر الشريف ما نصُّه: "الأول من الشيخ أبي الحسن الصُّغَيِّر؛ وهو الأوسط من شروحه على التهذيب". ...
ولم يرِد في أيٍّ من كتب التراجم، ولا فهارس المخطوطات في الخزانات العامة أو الخاصة، ولا في أي مصدرٍ مما وقفنا عليه؛ مخطوطا أو مطبوعاً أن للزرويلي تقييداً صغيراً.
وذكر التنبكتي في كفايته (15) والكتاني في سلوته أن لأبي الحسن تقييداً كبيراً، قالا عنه: " التقييد الكبير؛ جمعه رجل من صدور الطلبة؛ يقال له: اليَحْمُدي" (16)، وذكر الونشريسي تقييد اليَحْمُدي-هذا- عن أبي الحسن، ولم يصفه بـ (الكبير)، ولم يذكر أنه جمعه من صدور الطلبة (17) .
وهذا الكلام عليه جملة مآخذ؛ منها أن اليحمدي غير معروف في عداد تلاميذ أبي الحسن، وأن اسمه غير معروف، ومن بابٍ أولى عينُه، وأن ما ذهب إليه التنبكتي والكتاني -من ذكر جمعه"التقييد" من صدور الطلبة- يزيد تقييده ضعفاً على ضعف، كيف وقد تكلم أهل العلم في التقاييد التي تؤخذ سماعاً عن الشيخ مع كونها تكتب في المجلس (أو بعده) ممن حضره، فما ظنك بتقييد يجمعه من لم يحضر مجلس الإقراء أو الإملاء بل يُقيِّده بواسطةٍ!
وقد وجدتُ قُصاصةً في النسخة التي أمتلك أصلها في خزانتي الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث) جاء فيها: هذا سفرٌ من تقييد أبي الحسن الزرويلي على التهذيب، وأن بعضهم ظن بسبب كثرة الاختلاف بين نسخه أن للزرويلي أكثر من تقييد على التهذيب، وربما قرأ من لا يحسِن ضبط لقَبِه بغير تضعيف المثنَّاة التحتيَّة فظن أن الصغير – على التَّسْهِيل- صفة للتقييد، وبنى على هذا الخطأ أن له تقييداً (كبيراً) يقابل تقييدَه (الصغير)! وربما أقحم بعض النُّسَّاخ كلمة (الصغير) أو (الكبير) في وصف التقييد!!. اهـ
وبعد هذه المقدِّمات –أكاد- أجزم بأن ما كُتب عن الزرويلي تقييدٌ واحدٌ، وقع الخلاف بين مقيديه فيما لم يسمعوه من فم الشيخ في مجلسه، وأكملوه- فيما بعد- من المصادر التي نقل عنها الشيخ أو أومأ إليها.
لا يُعكِّر على ما أسلفتُ سوى ما ورد في "التقييد" الذي بين أيدينا من إحالاتٍ إلى "التقييد الكبير" وردت مراراً في ثنايا الكتاب؛ فتارةً يقول: "صح من التقييد الكبير"، ويقول تارةً: " هو في التقييد الكبير فتأمله"، وغالب الظن أن هذه الإحالات إنما هي إلى تقييد أُخِذَ عن شيخٍ غير أبي الحسن (18)؛ لأني وجدتُ بين يدَي كثيرٍ منها أو عقِبَه مباشرةً ما يفيد مخالفة الشيخ أبي الحسن لما نُسبَ إلى "التقييد الكبير" أو ردّاً عليه؛ فكيف يرد الشيخ على نفسه، أو يعارض في كتابٍ ما أقر أنه قاله في كتابٍ آخر!
تأمل –رعاك الله- الأمثلة التالية؛ ففيها برهان على ما ذهبنا إليه:
مثالٌ أول: قال الزرويلي على قول البراذعي في مسألة من قال: "عليّ يمين إن فعلت كذا" إلى قوله: "فعليه كفارة يمين" في كتاب (الأيمان والنذور) من كُتُب التهذيب: "أخذ بعضهم من هذه المسألة أن من قال: الأيمان له لازمة فحنث ولا نية له؛ أنه إنما تلزمه ثلاث كفارات يمينٍ بالله.
قال في "التقييد الكبير": وهي إقامة صحيحة.
الشيخ: وهذا بعيدٌ ...".
قلتُ: إذا كان "التقييد الكبير" صحيحَ النسبة إلى الزرويلي؛ فكيف يقول الزرويلي –نفسُه- عن قوله فيه: "هذا بعيدٌ"؟!!
مثالٌ ثانٍ: قال الزرويلي على قول البراذعي: «قال ابن القاسم: فإن اشترط ذلك فأثمر السواد، ثم أصاب جميع ثمرته جائحة فلا جائحة في ثمرتها».
... تقدم أنه عارضها اللخمي وحكى قولين.
قال الشيخ: كان في التقييد الكبير: "وليس في اللخمي تعيين المعارضة إلا ما نقل عنه".
قال الشيخ: لعله في نسخة أخرى؛ لأن نسخه مختلفة.
قلتُ: إذا كان "التقييد الكبير" صحيحَ النسبة إلى الزرويلي؛ فكيف يقول الزرويلي –نفسُه- عنه: "لعله في نسخة أخرى"!
مثالٌ ثالثٌ: قال الزرويلي: "قال في التقييد الكبير: وكذلك ذكر عبد الحق في كتابه الكبير فانظره؛ فإن كان مراده التهذيب (19) فليس فيه كراء الدور والأرضين".
قلتُ: إذا كان "التقييد الكبير" صحيحَ النسبة إلى الزرويلي؛ فكيف يشكك الزرويلي –نفسُه- في كلام نسب إليه فيه!
مثالٌ رابعٌ: قال الزرويلي: " في بعض الحواشي: يقوم من هنا أنه لا يجوز الربح في الكراء، خلاف ما جاء له بعد هذا، وهذا في التقييد الكبير، وليس بشيء؛ لأنه خلاف الكتاب".
قلتُ: إذا كان "التقييد الكبير" صحيحَ النسبة إلى الزرويلي؛ فكيف يقول الزرويلي –نفسُه- عن نقله فيه: " وليس بشيء"!
مثالٌ خامسٌ: قال الزرويلي على قول البراذعي:"قال غيره: لا تكرى أرض المطر التي تروى مرة وتعطش أخرى ... المسألة".
عبد الملك: خالف ابن القاسم -غيرَه- في ثلاثة مواضع؛ يجوز كراؤها عند ابن القاسم عشر سنين, وقال الغير: لا يجوز كراؤها إلا عاماً واحداً, ويجوز عند ابن القاسم العقد عليها في كل زمان ولا ينقد, وقال الغير: لا يجوز العقد عليها إلا قرب الحرث, وتوقع الغيث, وعند ابن القاسم يجوز النقد فيها إذا رويت, وقال الغير: لا يجوز حتى تروى ريّاً مأموناً ... وذكر الشيخ في التقييد الكبير الموضعين الأولين, وسكت عن الثالث, وهو لا بد من زيادته.
قلتُ: إذا كان "التقييد الكبير" صحيحَ النسبة إلى الزرويلي؛ فكيف يستدرك فيه على نفسِه؛ بقوله: "سكت عن الثالث, وهو لا بد من زيادته"!
مثالٌ سادسٌ: قال الزرويلي على قول البراذعي: "ولا بأس بزيادة دراهم في رأس مال السلم بعد شهر أو شهرين".
هذه جاءت دليلاً على التي قبلها, كذا ذكر في التقييد الكبير، وليس كذلك؛ لأنه إنما أتى بها في الأم مسألة على حيالها، وأجاب فيها من رأيه، ولم يسمع فيها جواباً من مالك، ولكن المناسبة بينة.
قلتُ: إذا كان "التقييد الكبير" صحيحَ النسبة إلى الزرويلي؛ فكيف يستدرك فيه على نفسِه؛ بقوله: " وليس كذلك ..."!
والأمثلة –غير ما ذكرنا- كثيرة في " التقييد" -الذي بين أيدينا- تدل بآحادها أو مجموعها على أن صاحب "التقييد الكبير" ليس أبا الحسن الزرويلي.
ثم لو صحَّ أن اليحمدي جمع تقييده من صدور طلبة الشيخ، فهذا يفيد أنه متأخرٌ عن الشيخ عصراً أو عن طلبته رتبة، فإذا كان الأمر كذلك فكيف – وهم المتقدمون عليه- يحيلون إلى تقييده الكبير؟!
هذا ما ترجح لدينا، ووقع عليه اخترنا – عن بيِّنةٍ- أنْ نُعَنون لطبعة الكتاب الذي وقفنا على تحقيقه ونشره بـ "التقييد" وحَسْب، دون وصفه بـ (كبيرٍ) أو (أوسطَ) أو(صغيرٍ)، وبه التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
***
ثانياً: إثبات أن ما بين أيدينا هو "التقييد" المنسوب إلى أبي الحسن في كتب التراجم:
أمامنا طريقان لا نعرف لهما ثالثاً في تحقيق هذا المراد:
أولهما: بالرجوع إلى ما وضعه ابن غازي العثماني في كتابه المسمى: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" أو "إتحاف ذَوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة"، وهو مما وقفنا على تحقيقه ونشره قبل تحقيق "التقييد" نفسِه، ولا نعلم خلافاً في أن ابن غازي أراد إدراك غايتين في هذا الكتاب؛ أولاهما –وقد أدركها- تكميل تقييد الزرويلي على التهذيب، وثانيتهما تحليل ما وقع في مختصر ابن عرفة من تعقيد العبارة، ونُقِلَ عن بعض معاصري ابن غازي قولَه: "أمَّا التكميل فكمَّله، وأمَّا التعقيد فما حلَّله" (20) .
ثانيهما: هو بمقارنةِ ما فيه بما في الكتب التي نقلت عنه، فقد أجرينا مقابلة بين عينات عشوائية فوجدانها هي هي مع ما لا يُؤَثِّر في المعنى أو السياق الذي –قد- يرجع إلى اختلاف النُّسَخ، الناتج عن اختلاف المقيدين عن أبي الحسن، وفيما يلي بعض النماذج:
1- قال الحطاب: قال الشيخ أبو الحسن الصُّغيِّر في كتاب الرهون في شرح قوله: "ويجوز رهن المصحف ولا يقرأ فيه" أخذ منه أن المُسْلِف إذا شرط على المتسلف إسقاط يمين القضاء أنه لا يجوز؛ لأنه سلف جر منفعة. اهـ (21) .
قلتُ: ذكر الزرويلي ما نقله عنه الحطاب في " التقييد"، وعبارتُه: "قوله: ولا بأس برهن المصحف ولا يقرأ فيه"، ... أخذ منه أن السلف إذا اشترط على المستسلف إسقاط يمين القضاء أنه لا يجوز؛ لأنه سلف جر منفعة.
2- قال التنبكتي: إن الشيخ أبا الحسن الزرويلي ذكر عن الطرطوشي: أن أخذ الفأل من المصحف من الاستقسام بالأزلام. انظر آخر كتاب (الصيد) أو (الضحايا) من تقييده على المدونة. اهـ (22) .
قلتُ: هذه المسألة نقلها التنبكتي بمعناها – من حفظٍ لا من كتابٍ- عن "التقييد"، ولذلك قال -متردداً في عزوها إلى موضعها من " التقييد"- بعدها: " انظر آخر كتاب الصيد أو الضحايا من تقييده على المدونة"، وقد بحثتُ عنها في " التقييد" فوجدتها في آخر كتاب (الذبائح) منه، وهذا نصُّها: " سئل الطرطوشي عن الاستفتاح في المصحف، فقال: هو من الأزلام"، والاستفتاح يأتي –في هذا السياق- بمعنى الاستقسام.
3- قال بهرام في تحبيره: الذي ذهب إليه أبو إبراهيم الأعرج وأبو الحسن الصُّغَيِّر أن الذي في الشهادات شرط كمال, وإليه أشار بقوله: "وتؤولت على الكمال في الأخير".
أبو الحسن الصُّغيِّر: إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شرط صحة. اهـ (23) .
قلتُ: ما نقله بهرام عن أبي الحسن نقلٌ بالمعنى، ونصُّه عند الزرويلي: "هذا شرط صحة في وثيقة الميت".
4- قال التتائي في جواهره: "واستدل بقول المدونة: وما كان مثل ديوان مصر والشام والمدينة، مثلَ دواوين العرب؛ فلا بأس به".
قال أبو الحسن الصُّغَيِّر: معناه لا بأس أن يكتب نفسه في الديوان إذا كان حلالاً.اهـ(24).
قلتُ: قارن بما في "التقييد" حيث قال الزرويلي ما نصُّه: "لا بأس أن يكتب نفسه ... في الديوان إن كان حلالاً".
قال أبو الهيثم الشبهائي: هذا ما تيسر جمعه وتقييده في هذا الموضوع، نختمه بحمد الله على توفيقه، والصلاة والسلام على نبيه.
__________
(*) هذا المبحث مستلٌ من مقدمتنا التحقيقية لتقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب البراذعي لمسائل المدونة والمختلطة، ونظراً لأن " التقييد" لم يطبع بعد فإننا لم نوثق ما نقلناه منه بالإحالة إلى أجزائه وصفحاته.
(1) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الأنيس المطرب، لابن أبي زرع، ص: 520، والإحاطة، للسان الدين الخطيب: 4/186، والديباج، لابن فرحون: 2/121، وجذوة الاقتباس: 2/472، وغير ذلك.
(2) كفاية المحتاج، ص: 478.
(3) الفكر السامي: 4/71.
(4) جاء في الدليل ما نصه: شرح على المدونة، تأليف: أبي الحسن بن علي الزرويلي، توجد منه نسخة (مبتورة الأول)، برقم: (993) في خزانة مسجد مولاي عبد الله الشريف بوزان، ورقمها الترتيبي (981).
(5) الإحاطة في أخبار غرناطة: 4/186.
(6) الديباج المذهب: 2/ 121.
(7) جذوة الاقتباس: 2/472، ودرة الحجال، ص: 403.
(8) كفاية المحتاج، ص: 198.
(9) الروضة المقصودة: 1/228.
(10) الفكر السامي: 4/71.
(11) رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال، للشيخ محمد الأمين (عرفات) بن فتى العلوي، ص: 47، 48.
(12) كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية، لعمر عمور، ص: 100.
(13) انظر: معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم، لعلي الرضا بلوط وأحمد طوران قره بلوط: 12/32.
(14) انظر: معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم، لعلي الرضا بلوط وأحمد طوران قره بلوط: 12/32.
(15) كفاية المحتاج، للتنبكتي، ص: 199.
(16) سلوة الأنفاس، للكتاني: 3/194.
(17) انظر: أزهار الرياض، للمقري : 3/36.
(18) أرجح كون هذا الشيخ هو شيخ أبي الحسن: أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر الورياغلي، المعروف بالأعرج؛ لأن في التقييد الذي بين أيدينا إحالات كثيرة بصيغة قال أبو إبراهيم في تقييده أو قاله أبو إبراهيم أو ما يؤدي هذا المعنى بألفاظ أخر.
(19) يريد: تهذيب الطالب وفائدة الراغب (ويعرف بالشرح الكبير على المدونة)، لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي، المتوفى سنة 466هـ.
(20) كفاية المحتاج، للتنبكتي، ص: 460، وسلوة الأنفاس، للكتاني: 2/84.
(21) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الحطاب، ص: 120، 121.
(22) كفاية المحتاج، للتنبكتي، ص: 421.
(23) تحبير المختصر، لبهرام الدميري: 5/199.
(24) جواهر الدرر في حل المختصر، للتتائي، اللوحة: 148/أ، من مخطوط يحفظ أصله في خزانة خاصة بمدينة تيشيت من الديار الشنقيطية حرسها الله.


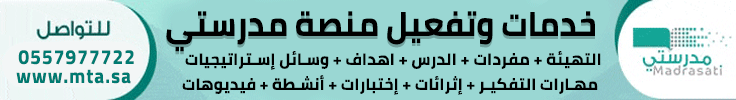






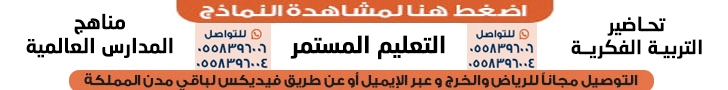

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
